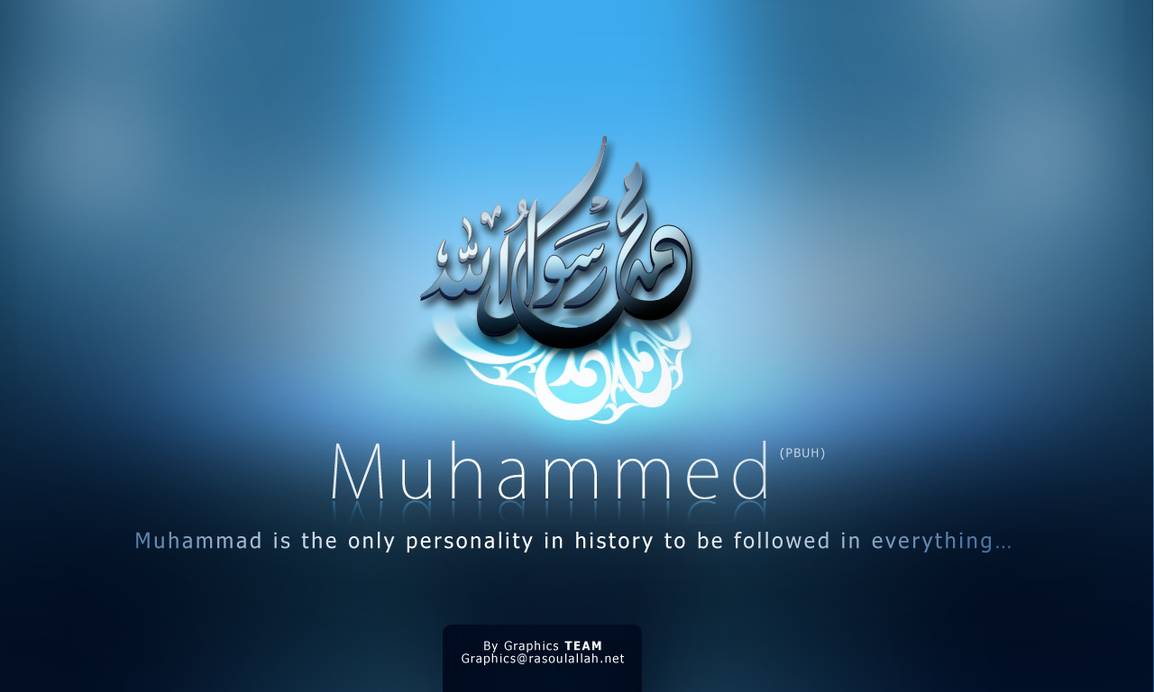أبعد من كوابيس طالبان: أفغانستان الأخرى المعقدة
2021-08-20

صبحي حديدي
لعلّ بعض معطيات التاريخ والجغرافيا تنفع في تمثيل مشهد أفغانستان الراهن على نحو تفاعلي، يربط الماضي بالحاضر وقد يؤشر على المستقبل في كثير أو قليل، كما يسبغ على الشبكات الجيو – سياسية المرتبطة بالبلد سلسلة أبعاد جدلية منبثقة، على وجه التحديد، من صلة التاريخ الأفغاني بالجغرافيا الأفغانية؛ بعيداً، في كلّ حال، عن التبسيط الراهن أو القديم المتجدد حول عودة الطالبان وما يُطرح فيها أو بسببها من فرضيات تنميطية مسبقة الصنع، حول الإسلام السياسي أو الجهادي أو الأصولي. الأكثر سهولة والأيسر افتراضاً، والأقرب إلى الخمول التحليلي بالطبع، إلقاء البلد في قبضة الملا برادر على غرار ما كانت عليه أيام الملا عمر خلال سنوات 1996 وحتى اندحار الحركة في سنة 2001؛ وبالتالي استعادة المقولات ذاتها حول ما سيُستأنف من نهج طالباني بشأن الحريات العامة وحقوق المرأة والتربية والثقافة وتطبيق شريعة متشددة والانغلاق الداخلي والإقليمي والدولي. الأكثر مشقة، ولكن المطلوب والحيوي والواجب، هو وضع الطالبان في بدايات العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين وليس في أواسط العقد الأخير من القرن العشرين؛ وقد يكون أفضل، وأنفع أيضاً، وضع الماضي على محكّ متغيرات الحاضر، وليس ردّها إلى ثوابت الماضي الساكنة المجمدة.
ولعلّ من الخير الابتداء من حقيقة أنّ البلد يحتل موقعاً ستراتيجياً مميزاً بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشبه القارّة الهندية، ويجاور الجمهوريات الإسلامية السوفييتية سابقاً، فضلاً عن الصين وإيران وتركيا والباكستان. لم يكن غريباً، والحال هذه، أن تصبح أفغانستان واحدة من مسارح ما عُرف في القرن التاسع عشر باسم «اللعبة الكبرى» بين التاج البريطاني وقياصرة روسيا، وأن تُخاض ثلاث حروب أنغلو ـ أفغانية على سبيل منع الدبّ الروسي (حسب الرطانة السائدة يومذاك) من الوصول جنوباً إلى مياه الخليج الدافئة والمحيط الهندي.
جغرافياً، تتراوح أفغانستان بين سلسلة جبال شاهقة في الشمال الشرقي، وصحارى مترامية على طول الحدود الغربية؛ وهذا عامل جوهري وضع تضاريس أفغانستان في رأس المعضلات التي واجهها أيّ غازٍ للبلد. وحين اجتاح الإسكندر الأكبر البلد من جهة الغرب، عام 331-326 قبل المسيح، واجه المشكلات الستراتيجية ذاتها، مع فارق تقنيات الحروب وعدّتها وأساليبها، التي واجهها الجيش الأحمر في ثمانينيات القرن المنصرم. كذلك فإنّ الطرق الحديثة التي شُقّت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين إنما تقتفي مسار الوديان وتحاذي سفوح السلاسل الجبلية الكبرى، وبالتالي لم يكن مدهشاً أنّ الطريق الرئيسي الواصل بين حيرات وقندهار يتبع المسار ذاته الذي طرقه الإسكندر الأكبر.
لهذا فإنّ غزاة أفغانستان لا يملكون سوى التخلي عن الجبال لصالح أهل البلد، وأبناء القبائل اعتادوا العيش في الأعالي، والمحاربون منهم خبروا فنون القتال الجبلي ومزاياه؛ وهذا بعض السبب، الجوهري مع ذلك، في أنّ الطالبان انسحبت من المدن إلى الجبال وقاتلت من هناك وأوجعت جيوش القوّة العظمى والحلف الأطلسي، ولم تكن في حاجة حتى إلى كرّ وفرّ أمام الجيش الحكومي حين هبطت مؤخراً إلى السهول والصحارى والبلدات والمدن. وهو، أساساً، السبب في أنّ جميع حكّام أفغانستان عجزوا عن إخضاع قبائل الجبال، أو تفادوا ذلك عملياً، وأنّ مختلف الإمبراطوريات الأفغانية التي عرفها تاريخ البلد نشأت في سهول الجنوب والغرب، وأرخت العنان لأبناء القبائل حيثما تواجدوا، فترسخت الاستقطابات القَبَلية والعشائرية سواء في نطاق المجموعات المحلية أو المجتمع الأفغاني على نطاق أوسع.
وأبعد من أي استقطابات مقبلة حول الشريعة، أو حول الانقسامات المذهبية بين سنّة وشيعة، سوف يضطرّ طالبان 2021 إلى مجابهة السيرورة الشائكة ذاتها التي جابهها طالبان 1995، ولكن بوتيرة أشدّ وعورة ومشقة هده المرّة: سيرورة اتحاد القبائل ضدّ الغازي الخارجي، ثمّ انحلالها من جديد إلى مجموعات محلية ذات مصالح متضاربة على خطوط شاقولية تبدأ من الأسرة، فالعشيرة، فالقبيلة؛ حيث تتقاطع في هذه المستويات الثلاثة حقوق وواجبات شتى، اجتماعية وسياسية ومذهبية. ولا تتضح تعقيدات هذه السيرورة، من الاتحاد فالانقسام فالاتحاد النسبي، إلا إذا استعاد المرء حقيقة انتماء 55 في المئة من السكان إلى الباشتون، مقابل 30 في المئة إلى الطاجيك؛ وصولاً إلى فسيفساء أفغانية مؤلفة من الأوزبيك والبلوش والهزاري والإيمق والتهكان والنورستان والقرغيز والكازاخ والعرب. هذا التفتّت الإثني يعمّقه تنوّع لغوي زاخر: معظم الباشتون يتكلمون الـ»باشتو» ومعظم القبائل الأخرى تعتمد لغة الـ»داري» الأقرب إلى تنويع أفغاني للفارسية وبضع لهجات تركية. وبينما تضرب التمايزات القلبية بجذورها في عمق الاستقطابات الإثنية، يظلّ الدين عامل توحيد عامّ: 90 في المئة من السكان يعتنقون الإسلام، ويتوزعون بنسبة 80 في المئة للسنّة، والباقي للشيعة المتركزين في قبائل الهزاري.
السياسة، في مستوى الأحزاب الأفغانية، اقتصرت تقليدياً على الطبقة الوسطى المدينية بصفة عامة، ولم تحظَ إلا باهتمام محدود من فئات الأغلبية الريفية وسكان الجبال. العام 1978 شهد نقلة نوعية مع تحوّل بعض هذه الأحزاب إلى حواضن لأنساق التدخل الخارجي العسكري والاستخباراتي والمالي، فصارت بمثابة أقنية لإنعاش «الصناعة الجهادية» التي تولت المخابرات المركزية تأسيسها برعاية مباشرة من مستشار الأمن القومي الأمريكي زبغنيو برجنسكي. ومع ذاك فقد عجزت هذه الأحزاب، على شاكلة فصائل «المجاهدين» في واقع الأمر، عن قطف ثمار التنظيم العسكري والمعونات المالية والتسليحية التي انهالت عليها؛ فظلت، استطراداً، أسيرة الانتماءات القبلية والتصارعات المحلية والتمسك بالهويات الإثنية. وهذه خلاصة سوف تستعيد القسط الأعظم من زخمها مع انتصار الطالبان، وثمة الكثير الذي سوف يتكفل باستيلاد تناقضاتها مع الحركة، أو بين بعضها.
ما هو جدير أيضاً بالتدقيق، بغية التصويب أساساً، هو التنميطات المسبقة الشائعة حول الهويات الإيديولوجية لتلك الأحزاب، وما تردد مراراً في دراسات غربية وأمريكية حول التيارات الإسلامية تحديداً؛ لجهة انقسامها إلى «أصولية» أو «راديكالية» أو «تقليدية» أو «معتدلة». وكان الباحث الأفغاني المتميز شاه محمد طرزي قد أثبت أنّ هذه التقسيمات تبسيطية وخاطئة ومضللة، إذْ لا توجد خلافات عقائدية كبرى بين تلك المجموعات، فالإسلام عندهم شرعة حياة لا تسري على العلاقات الروحية والاجتماعية فحسب، بل هي دليل شرعي لسياسة الدولة حتى في المسائل المتصلة بالتخطيط والإنماء الاقتصادي وتطوير نظام اجتماعي وتربوي وثقافي… وهذه، يصحّ التذكير، ليست ميادين اتفاق واتحاد وائتلاف فقط، بل هي كذلك حقول اختلاف وتنازع وتضاد، وليس للاعتبارات الفقهية التأويلية وحدها، بل على وجه التحديد لأنّ «شرعة الحياة» هذه يصعب أن تتخذ صفة المنظومة المتسقة الآمنة الثابتة؛ وما سيدفع التيارات الإسلامية إلى احتمال الالتفاف حول الطالبان، ينطوي في الآن ذاته على عناصر أخرى سوف تدفعهم إلى انشقاق عنهم ونزاع وصراع.
أفغانستان الأخرى هي هذه الشبكات التاريخية والجغرافية التي إنْ كانت تستمدّ بعض دروسها من الماضي فإنها ليست منفصلة عن، أو هي خارج، ديناميات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وقبائلية وإثنية ولغوية معقدة ومتشابكة. ومن التسرّع، فضلاً عن الخطأ المنهجي الفادح والخمول التحليلي، أخذ البلد على محمل واحد وأحادي هو كابوس الطالبان في تنميطاته المستعادة ماضوياً فقط، وكأنّ التاريخ في هذا البلد لم يتحرّك قيد أنملة؛ أو كأنّ جدل البلد الوحيد هو مقولات مثل استسلام الجيش الحكومي أمام زحف الطالبان، أو ذاك الذي اختزلته دراما «التعربش» بالطائرات المغادرة من مطار كابل، أو حتى نبش شخصية مثل حامد كرزاي لاح إلى حين أنه أقرب إلى عظام رميم…
*كاتب وباحث سوري يقيم في باريس