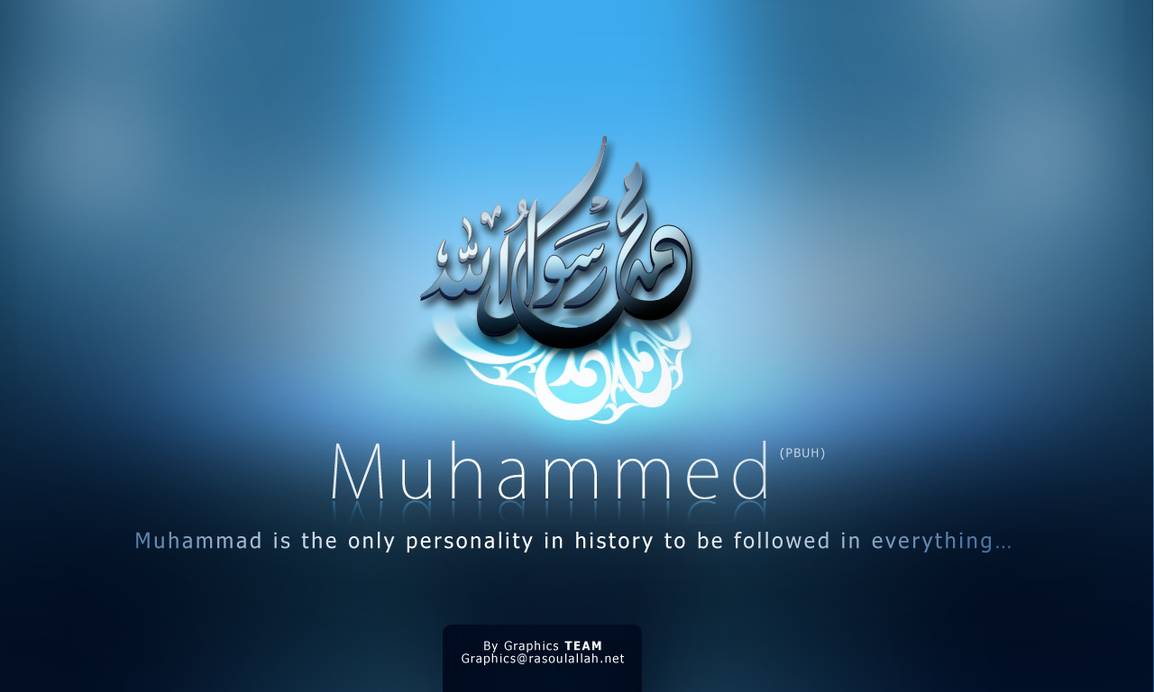فجر يعقوب الفائز بجائزة كتارا: هكذا كتبت “ساعات الكسل” في جزيرة ساموس
2021-10-16
 شام مصطفى
شام مصطفى
بينما القارب المطاطي يشق عباب بحر إيجة باتجاه الجزر اليونانية، كان المخرج والروائي الفلسطيني فجر يعقوب يخط على متنه أبياتا من الشعر مستعينا بجهازه المحمول لكي يلتقط اللحظة ويسجل التجربة، بعد أن تعطلت كاميرته وتبللت أوراقه.
تجربة أعاد يعقوب توثيقها في عمله الروائي التسجيلي "ساعات الكسل- يوميات اللجوء"، مستعيضا عن الصورة وغوايتها بقلم دوّن من خلاله حكايات الهاربين من جحيم بلدانهم التي لفظتهم إلى البحار لتبتلعهم أو تنجيهم، مستلهما حكاية "أوديسيوس" الإنسان الإغريقي الذي حُكم عليه ألا يصل إلى أرضه أبدا ليظل تائها في البحر حتى فنائه.
وتتصدى الرواية -الفائزة بجائزة كتارا في دورتها السابعة- لمجموعة من القضايا التي رافقت موجات الهجرة الجماعية إلى أوروبا منتصف العقد المنصرم، فتطرح قضية "قوارب الموت" وقضية الاتجار بالبشر عبر ما يعرف بـ"التهريب" وغيرها من القضايا، عبر مزيج من السيرة الذاتية والمتخيل الروائي.
والجدير بالذكر أن للمخرج والروائي فجر يعقوب عشرات الأفلام الروائية والوثائقية، وفي جعبته 4 مجموعات شعرية، إلى جانب العديد من الأعمال الروائية والكتب النقدية. فإليكم هذا الحوار:
الجائزة كتجسير للهوة بين المؤلف والقارئ
حصدت روايتك "ساعات الكسل- يوميات اللجوء" جائزة كتارا للرواية العربية قبل ساعات من الآن. فما الذي يعنيه لك هذا الفوز، وما الذي أضافته الجائزة للرواية؟
الجوائز عموما مسألة إيجابية في حياة المؤلف والقارئ معا في عالم أصبح يقوم على التفكيك أكثر وأكثر، بل ويمعن فيه. ربما تعيد الجوائز توصيف هذه العلاقة الملتبسة (اليوم)، وتعيد ترسيم الحدود التي مُحيت بفعل الابتعاد عن القراءة، والانحياز حد الغرق الطوعي والكلي في عوالم "السوشيال ميديا".
الرواية مكتوبة ومطبوعة، وما تفعله الجائزة هنا هو تأمين واسطة الانتشار لها وإقبال القراء عليها، البعض بدافع الفضول طبعا، والبعض الآخر بدافع التخصص، وثمة القارئ المتلصص، والاندفاعي، وهناك المتهور.. إلخ، وفي المحصلة، وبغض النظر عن هذه التعريفات، فإن وجود هؤلاء القراء الظرفاء جميعا في حياة أي كاتب لم يكن ممكنا دون الجوائز حتما، وسواء وقفنا معها أو ضدها فهي ضرورية اليوم.
ولنأخذ حالة الروائي التنزاني عبد الرزاق قرنح الفائز بجائزة نوبل مؤخرا، فلولا هذه الجائزة لبقي غير معروفا، أقله بالنسبة لنا، بالرغم من أنه يشترك معنا بسمات وصفات كثيرة، والخلاصة هنا أن الجائزة خففت من مأزقنا الأدبي كثيرا في حضرته.
في البحث عن الرواية العظيمة
ركبت البحر فتعطلت كاميرتك ولا أوراق لديك للكتابة، فاستعنت بجهازك المحمول، ومن هنا بدأت رحلتك مع الكتابة عن الهجرة. لو تحكي لنا عن هذه التجربة؟
كتبت مجموعتي الشعرية "بياض سهل" بالهاتف النقال بين مدن كثيرة استغرقت مني أكثر من شهرين وأنا أتنقل بينها حتى بلغت بر الأمان، ولم أكتب روايتي عن البحر إلا قبل عامين بعد أن أرقني إهدار الفيلم الوثائقي، وسبب لي أزمة وصدمة نفسية وثقافية إن جاز التعبير، لأنني ضيعت فرصة لن تتكرر إطلاقا.
ولكن، مع الوقت، اكتشفت أن الفيلم ربما لم يكن ليضيف شيئا إلى مجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية التي حاكت قضايا اللجوء وزوارق الموت وتهريب البشر، ولهذا بدا لي أن الكتابة الروائية عن تجربة بهذه الأهمية، في حياتي وحياة الآلاف من اللاجئين، ربما هي التحدي الأكبر والأهم الذي واجهته حتى الآن. وربما بوسعي أن أضيف أن مخرجا إسبانيا كبيرا مثل بيدرو ألمودوفار حكى لنا في كتابه "سينما الرغبات" أنه مستعد للتخلي عن أفلامه كلها مقابل كتابة رواية عظيمة.
تحكي رواية "ساعات الكسل- يوميات اللجوء" عن تجربتك الذاتية في قطع مسافة أرض وبحر للوصول إلى بر الأمان، ولكن كما نعلم يشكل المتخيل (التخييل) أساسا للفن الروائي. فإلى أي مدى حضر المتخيل في الرواية وما الوظيفة النصية التي أداها إلى جانب الذاتية؟
أعتقد أن الكشف عن الحدود بين ما هو متخيل وما هو واقعي مسألة ملقاة على عاتق القارئ بالدرجة الأولى، فلو حاولت التفصيل في هذه القضية لأفقدته متعة التخييل نفسها.
ولا نجزم هنا أن إعادة تركيب الواقع حرفيا يمكن أن تلقى الاهتمام، وقد تضع الكتابة نفسها في قوالب جامدة في زمن متحرك لم يعد ممكنا التحكم به، وهذا قد يخلق صدمات متتالية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي في وعي المتلقي الأخير للمادة الأدبية.
طرحت الرواية أسئلة وجودية كبيرة عن الإنسان والموت والحياة. فلماذا يعيد الإنسان طرح كل تلك التساؤلات الكبيرة على نفسه في تلك اللحظات بالذات، لحظات الهجرة والاغتراب؟
ستظل هذه الأسئلة موجودة بيننا وترافقنا في هجراتنا واغترابنا ما حيينا على هذه الأرض، والأفضل لنا اكتشافها دون وجود الهجرة والطغيان والاستبداد والفقر. لقد كانت فرصة كبيرة لي أن أنزل في جزيرة "ساموس" اليونانية، مسقط رأس عالم الرياضيات والفيلسوف الإغريقي فيثاغورس الذي اصطدم مبكرا جدا بالدكتاتور بوليكراتس (حاكم الجزيرة)، فاعتقل، وعذب، وجرب الهجرة إلى أرض مصر وبلاد الهند.
وأعتقد أن فيثاغورس كان منشغلا بذات الأسئلة التي ما زلنا نهجس بها اليوم، وسيأتي آخرون من بعدنا ويهجسون بها، ويعيدون تشكيلها وتكوينها بما يتناسب مع الزمن الذي يعيشون فيه. فالسؤال هو هل سيتوقف الاستبداد يوما؟ لا أعتقد ذلك.
عرضت في روايتك لتجار البشر من مهربين عتاق في المهنة ومحدثين وكيف تتم هذه الأعمال بشكل عام. فكيف بدت لك عوالم تلك الشخصيات وطبائعها؟
من المؤكد أنه لا يمكن اختراق عوالمهم بالكامل، إنهم كائنات زحارية تعيش في محيطات غامقة ورمادية من زلال البيض، ومن نتعامل معهم نحن بشكل مباشر هم الواجهات الكلسية لهذه الكائنات.
قال لي المهرب أبو إبراهيم الإدلبي أنهم (المهربون الصغار) مجرد واجهة لمافيات منظمة لا أحد يعرف عنها شيئا فهي تتحرك وتضرب في العتمة. وصحيح أنني التقيت ببعض المتسلقين الصغار في مهنة التهريب، ولكن حتى هؤلاء موضوعين على سكك الحيتان الكبيرة دون أن يشعروا بذلك أبدا.
أخرجت في مسيرتك عشرات الأفلام وكتبت 15 كتابا. فمتى يختار فجر يعقوب السينما كأداة للتعبير ومتى يقع الخيار على الكتابة؟
لم يعد هناك قطع في الأشكال الفنية التي ألجأ إليها في كل مرة، ولكن السينما خيار صعب ومعقد ومقلق بسبب طبيعة الإنتاج الجماعية نفسها، أما الكتابة فهي عامل توازن بالنسبة لي، فأنا أتوازن عندما أكتب بعكس الفيلم الذي يسبب لي قلقا هائلا وأنا أعمل عليه، وأنتظر أن أنتهي منه بفارغ الصبر، وأتوارى وحيدا في العتمة.