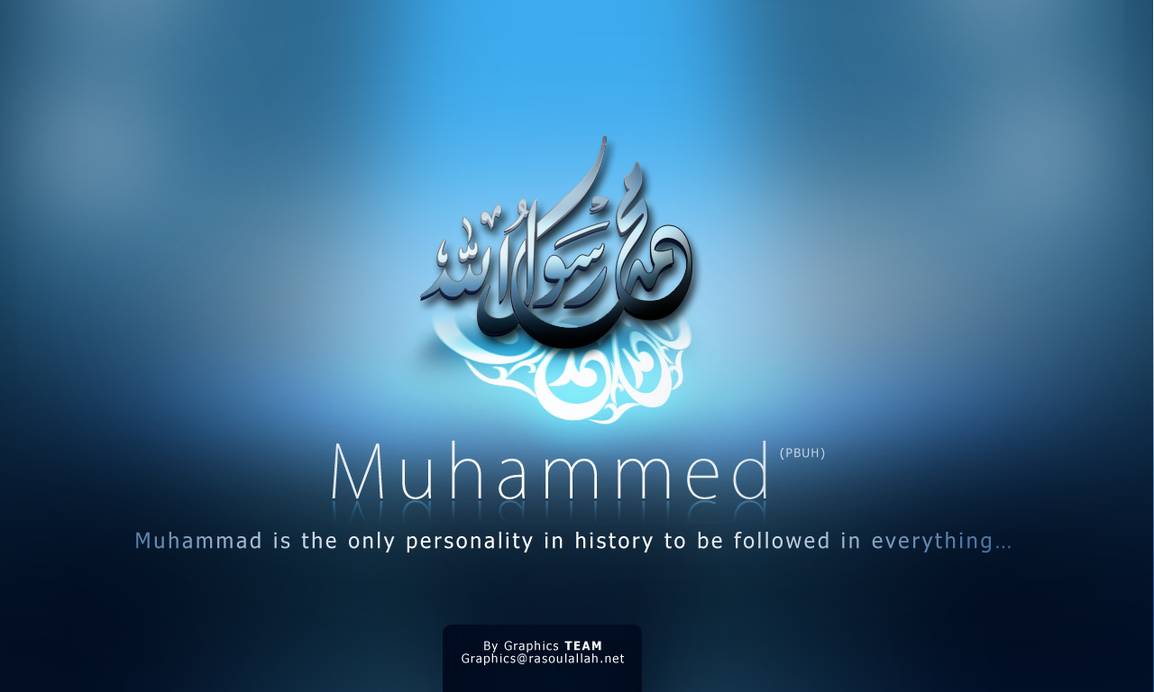رواية «نصف ما تبقى»: استعارة فلسطين وفائض أسئلة المثقف الصعبة
2022-01-20
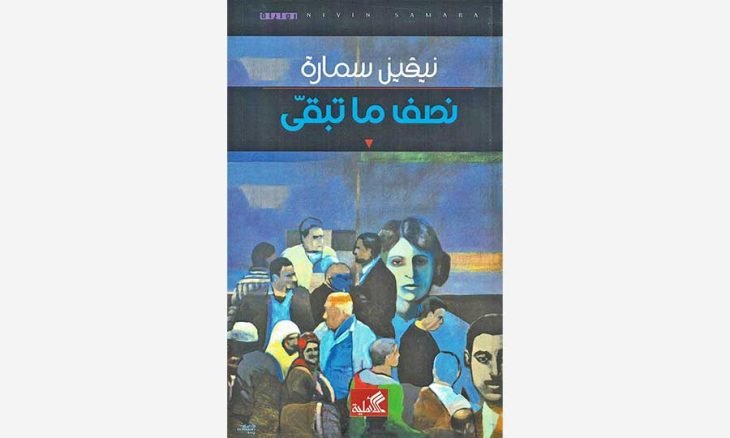
عايدة فحماوي وتد
في رواية «نصف ما تبقى» لنيفين سمارة علينا أن نبدأ من النهاية، لأن النهاية -وفق الرواية- هي لحظة ما تبقى لمن بقي من شعب قُطعت أوصاله وضُللت قيادتُه السياسية وأُفقد مثقفوه دورهم في التغيير، وغرقوا في التفسير، وشُوهت البوصلة لدى كل جيل جديد.
من نحن اليوم؟ ماذا نريد؟ وإلى أين نذهب؟ وكيف علينا أن نفعل ذلك؟ هذه هي الأسئلة الحارقة التي تطرحها هذه الرواية التي حبكت بذكاء أدبي واقتصاد لغوي، يشبه البساطة لكنه أبعد ما يكون عنها، وبنسج بعيد عن الترف البلاغي وأقرب ما يكون إليه. تتأمل هذه الرواية في القيود غير المرئية، لما تبقى من الضحية التي حرص النظام الصهيوني الكولونيالي والعربي القمعي على رسم حدود حركتها وأفقها، وتتلمس بعناية حالة التجمد الذي أصابها منذ أن فكت قيودها، أو هكذا شبه لها.
في هذه الرواية ومنذ الغلاف، بحث عن طريق للنصف الغائب التائه من خلال النصف الحاضر الرائي، حيث يتزامن موت جيل النكبة الفاجع ورحيله الهادئ دون انتباه، مع موت ضاج صارخ آخر، موت قاتل وفقط، يقتحم الجيل الثالث بطريقة مبتكرة تجعله يقتل نفسه بيده، موت اجتمعت كل الأسباب المتراكمة سبعين عاما كي يحدث «كيف قتل؟ لا نعرف، تسلمناه جثة مرفقة بتقرير طبي مفصل، لم أقرأه».
لنعد الآن إلى ما قبل البداية، منذ العتبة الأولى يتخاطب العنوان مع عناوين حاضرة في الموروث الفلسطيني الأدبي الجمعي، تشده بقوة وتضاد إليها كـ»باقون» لتوفيق زياد، و»ما تبقى لكم» غسان كنفاني؛ فالبقاء والتبقي فعلان متنافران مشتبكان بـ»الصابرة» ذلك المكان الاستعارة الذي تجعلك الرواية تصدق أنه اسم قرية موجودة، فلا يتساءل القارئ عن صبرها وصَبّارها أيهما أكثر حدة ووجعا؟ هل هي صَبّارة باقية متحدية؟ أم متبقية عالقة حائرة لا تعرف النكوص ولا تتقن الإقدام. نصف ما تبقى هو الغياب والتلاشي البطيء هو البقاء الباهت الفاقد لمعناه.
في الرواية أربع دوائر متداخلة ومترابطة، تمر من خلالها صراعات «ميسم» الدائرة الأولى المجتمع الفلسطيني في الخط الأخضر، الثانية مع المجتمع الإسرائيلي، الثالثة مع فلسطينيي خارج الخط الأخضر والرابعة مع العالم العربي.
في مركز الرواية «ميسم» التي يمر الحدث وزاوية الرؤية من خلالها، اختيارها طبيبة للأطفال من بلد «الصابرة» هو استعارة بليغة لعجز المثقف العضوي في موقع الفعل (غرامشي). تقول ميسم: «ألا أمارس كل يوم حياة طبيعية، ألقى الناس وأعيش ما يعيشه البشر من حب وحزن وشفقة وغضب ومقت. ويتعطل كل هذا أمام أبناء شعبي، وهم في ما هم. ما معنى هذا؟ ماذا يبقي هذا مني وماذا يبقي منكم فيّ؟». فهي ترى الموت والحياة والعطب المزمن، ويراها القارئ تقف على خط التماس عاجزة عن إنقاذ ما تبقى من علامات حياة: حياة جدتها التي تمثل الموت الاستعاري لجيل النكبة الأصلاني، وحياة أخيها «أمير» الذي يتورط مع مافيا الإجرام وهو يمثل فائض فقدان السيطرة الفلسطيني، والسيطرة الفائضة للمؤسسة الصهيونية، وهي عاجزة عن إشفاء العطب والتوحد المزمن لدى الحفيد رشيد، الجيل المتوحد الذي ستخنقه العزلة، عاجزة عن إعطاء الأمل لمنال النابلسية، في أن يسير طفلها محمود على قدميه وقد ولد وسَط تداعيات المشروع الأوسلوي الكسيح، تقف عاجزة أمام استباحة غزة، ولا تملك إلا أن تستعيض بصمت المراقب «نحن نطبب أنفسنا بلم التبرعات لما بعد الحرب». لكنها أيضا الأم والحبيبة والبوصلة التي تنجب للحياة بيسان، وتلك حكاية أخرى مفتوحة سنعود إليها لاحقا.
في الرواية أربع دوائر متداخلة ومترابطة، تمر من خلالها صراعات «ميسم» الدائرة الأولى المجتمع الفلسطيني في الخط الأخضر، الثانية مع المجتمع الإسرائيلي، الثالثة مع فلسطينيي خارج الخط الأخضر والرابعة مع العالم العربي.
في الدائرة الأولى – وهي الأكثر مركزية واتساعا في الرواية – ثلاثة أجيال فلسطينية ورابعها من الأطفال. جيل النكبة الأول يتجلى من خلال جدة ميسم «سهام أم رشيد» التي تقدمها لنا الرواية كاستعارة لأسطورة البقاء الفلسطيني فهي تحمل من القوة والعاطفة وقلق البقاء ما جعلها تحافظ على انتصاب هالتها السخية بالبياض، تتفنن الكاتبة في رسم الهالة البيضاء لأم رشيد، ولباسها الأبيض الفضفاض السخي بالقماش والمطرز بالأبيض وطرحتها البيضاء: «امرأة تجاوزت الثمانين لكنها تملك حيوية وشعورا دائما بالأهمية لم يتكون بفعل الغرور إنما بفعل البقاء» نجت من النكبة ومات زوجها «صلاح العبادي» «فلاحا أجيرا في أرض اليهود، وليس في أرضه التي لم يتبق منها إلا بيته وساحته الخلفية، كل ما كان له أصبح ملك أسياد البلاد الجدد».
علاقة ميسم من الجيل الثالث بجدتها هي علاقة المرساة التي تجعل ميسم تفتش عنها عند كل تيه، وكل أزمة، «أحبك يا أم رشيد، كما لا أحب أحدا في هذا الوجود». لكنها تدرك أنها تختلف عنها إذ تقول: «لسنا امتدادا لكم، لا نشبهكم كما كل البشر، تشكلنا إسرائيل حين ترخي وحين تشد. هل نبقى صخرا؟ جائز، لكنه صخر لا حياة فيه أم أن الحجر حياة؟ «دخول الجدة في غيبوبة قبيل رحيلها النهائي يبدو استعارة لرحيل بطيء وهادئ لهذا الجيل، وللفقد المتكرر دون انتباه لبديهية الأصيل والمتجذر في الهوية. وهو رهان المؤسسة على فلسطينيي الخط الأخضر «الكبار سيموتون والصغار سينسون». بالمقابل يظهر الجيل الثاني للنكبة مهزوما ممثلا بأبي رشيد من «أصحاب الأحلام الكبيرة والشعارات» الذي تضيق همومه «بفعل الهزائم» نحو الخاص رغم اتساعها للعام، «وينصاع قهرا لكل ما يناقض ما نشأ عليه» ورغم اختلاف ميسم معه سياسيا لكنها ترى وجوده ضرورة: «من قال إن حمل البلاد هو الذي يعيق؟ حماك الله ستظل تحكي للأحفاد».
يبدو حضور الأب في الرواية باهتا، وقيادة لا تقود، عاجزا مهزوما مشككا في دوره السردي للحكاية، هو ذاته الجيل الذي أنجب ميسم كما أنجب أمير، أمير الذي «لن ينجب أحدا ولا شيئا وترك لنا الألم والحسرة» قتل ولم يقل شيئا، فقد كان موته حتميا، فوباء العنف إذ تقول ميسم: «طال الجميع بمن فيهم من رسموا لأنفسهم قالبا متوقعين من أنفسهم تفوقا، دون خوض حقيقي في امتحانات الحياة، فكل ما يحدث لغيرهم لا يحدث لهم، يحميهم دين لا يطبقونه ووطنية يختبئون منها». تختزل الكاتبة ببراعة فجيعة هذين الموتين الاستعاريين حتميي التزامن بجملتين بليغتين: «كيف تخوض الموت؟ وكيف تخوض القتل؟». ترافق ميسم بالتزامن جسد الجدة الميت الحي، لتستقبل الفراغ في قلبها، حصة أمير في روحها. ترى الرواية من خلال «ميسم» في الجيل الثالث الجيل الأكثر عجزا، رغم التحصيل العلمي والمادي، وهي تلامس بذلك أزمة المثقف الفلسطيني في الخط الأخضر في صراعه مع الأسرلة الممنهجة من زاوية أخرى: الخلاص الفردي الذي يجعل الخلاص الجماعي أكثر تعقيدا وذوبانا: «مع نجاحهم واستقرارهم يأتي عجزهم، بين مطرقة إسرائيل وسندان العاقين، ومن كانوا جُذوة الأمل بغد أفضل يبتعدون إما عن المشاكل وإما عن البلد». فنبال أخت ميسم وزوجها يعيشان بواقعية وبراغماتية بمنأى عن التفكير، وصلاح أخوها يعيش معطلًا في فقاعته الفكرية، ووليد زوجها المحامي المتواطئ مع مافيا الإجرام وأمثاله، رغم قلتهم يقودون المشهد الفاسد والمفسد، هكذا – وفق الرواية- يترك المثقفون أدوارهم ويلعبون وفق شروط صممت لهم، يعيشون في فقاعاتهم، أو ينكمشون في تخصصاتهم ومجدهم الشخصي، أو يغادرون إلى بلاد أخرى ابتعادا عن الصراع والملاحقة، فينجحون جدا لدرجة أن يصبحوا أقل تأثيرا، أو بكلمات الرواية: «مجتمعات مهزومة يبحث فيها الرجال عن انتصارات وهمية وتبحث النساء عن مكانة عالية في الحضيض». وهنا نلتقي بالدائرة الثانية من خلال عمل ميسم في سفرها اليومي، وفي تقاطعات علاقتها مع «تالي» وزملائها في المشفى. يتجلى الأبرتهايد الفكري رغم التماس اليومي، النظرة الاستعلائية الكولونيالية، رغم ندية الأداء في الميدان، حيث تتمزق ميسم يوميا وتزيد مساحة الصمت في حياتها، خصوصا في زمن الحرب على غزة، بين وجعها ويأسها، «وصلت إلى قناعة أننا مجتمع مجنون. لا تفسير لكل التناقض في المشاعر والأفعال، لا أحد سويّ في فلسطين وليعرّفوها كما شاءوا: تاريخية، مجزأة، محطمة، مع حدود، دون حدود، هي معادلة صعبة، الادعاء بأنك تحافظ على بقائك، بينما أهلك يقتلعون فوباء العنف لتبقى حتى لو فرغ البقاء من معناه».
إدراك ميسم أن المجتمع الإسرائيلي العام أصم وبليد ومتعال، كما صممته المؤسسة الصهيونية، بحيث لا يمكنه الإصغاء للسردية الفلسطينية يجعلها تغلق باب الحوار كي تحافظ على نديتها مع تالي، ولا تبدو ضعيفة.
إدراك ميسم أن المجتمع الإسرائيلي العام أصم وبليد ومتعال، كما صممته المؤسسة الصهيونية، بحيث لا يمكنه الإصغاء للسردية الفلسطينية يجعلها تغلق باب الحوار كي تحافظ على نديتها مع تالي، ولا تبدو ضعيفة. وتتفادى البقاء مع الزملاء كي «تتفادى أحاديث الحروب والسياسة. تنجح منذ سنين بتفاديها، ليس عجزا ولا خوفا، لكنه الشعور بأن الجدال لا يغير شيئا. لم تمر أكثر من بضع دقائق حتى اختفت غزة من بالها تماما».. رغم علاقة ميسم بزميلتها الطبيبة «تالي» إلا أنها كانت حريصة بشكل استعاري على إبعاد تالي من تطبيع علاقتها بـ«علي» الطبيب المصري الذي تلتقيانه في مؤتمر في برلين «شعرت بأن واجبها أن تحمي عليًا من لقاء تالي» وهنا نتصل بالدائرة الرابعة حيث تبدو علاقة ميسم وعلي العلاقة ذات الدلالة الأعمق، التي تقود خط الرواية من الناحية الفكرية، فهي علاقة لا تبدأ ولا تنتهي، هي موجودة دوما قبل أن توجد ضمن ذلك العهد الأبدي، الذي تكلله جملة «بسم الله». علي وميسم بينهما ميثاق لا يمكن لأحدهما التحرر أو التحرك إلا بحراك الآخر. فـ»علي» الذي يخرج مهزوما مزعزع اليقين كمعظم المصريين بعد الثورة المضادة وقمع رابعة، يبحث عن يقينه من خلال ميسم – فلسطين، وميسم التي جعلها الحراك العربي تحب «نفسها من جديد في ميدان تحرير لم تكن فيه يوما» جعلها تتخلى عن قصة الأميرة الوهمية وتشحذ وعيها السياسي وتنبهه وتتجرأ على القول لزميلها الإسرائيلي: «اخرجوا منها أنتم، لا شأن لكم بما حدث في مصر» الميدان لنا ولا مكان لكم فيه». لكن الثورات المضادة وفجيعة المهاجرين، كسرت ميسم قبل أن تكسر السوريين والمصريين «كسروهم فكسروها».
علي المصري رغم مرحلة التيه يمثل – وفق الرواية – الصوت العربي الحر رغم أنف القمع يخوض طريق البحث عن اليقين، يُسمع صوته ضد الفساد، ويختفي ككل المثقفين المشتبكين، لكن اختفاءه جعل ميسم تفكر في أن تتحرك كي تفهم دورها «أنا لم أكن تائهة، كنت متجمدة، فسأفعل وأقول ما أراه صوابا وفورا، علّ الحركة توصلني إلى الفهم والطمأنينة، قد لا أصل، المهم الطريق، هذا ما تعلمته من علي». نهاية النص بتقنية Overview Ending /Extra- textual reality هي بداية حراك محتمل لما تبقى من الفلسطيني والعربي: «نحن أحياء لأننا نصارع، لأن بعضنا يسقط وليس كلنا. أحياء لأننا لا نتعلم من كتب المدرسة، ولا من كتب الحكام ولا من كتب الطغاة، لقد سمى علي ابنته بيسان ثم اختفى، بيسان هو اسم شيء منها. كيف لها أن تضعف؟ أن تعيش حياة لا تكون فيها كقوة علي؟ للعهد الأول بينهما أن يبحثا عن اليقين معا». استعاريا يبدو أن بيسان المصرية هي بوصلة رسالة علي لميسم، هي ما تبقى منه. أما ابنتها بيسان فهي ما تبقى منها «لم يعد يهم من هو علي ومن هي، المهم ما فعله علي وما عليها فعله هي». هنا تنتهي الرواية بين حراك محتمل وتجمد حاصل. تماما كما في بينية لحظة فلسطينيي الخط الأخضر الراهنة، بينية جعلتهم يبقون لكنها قد تفقدهم ما تبقى.
أكاديمية فلسطينية