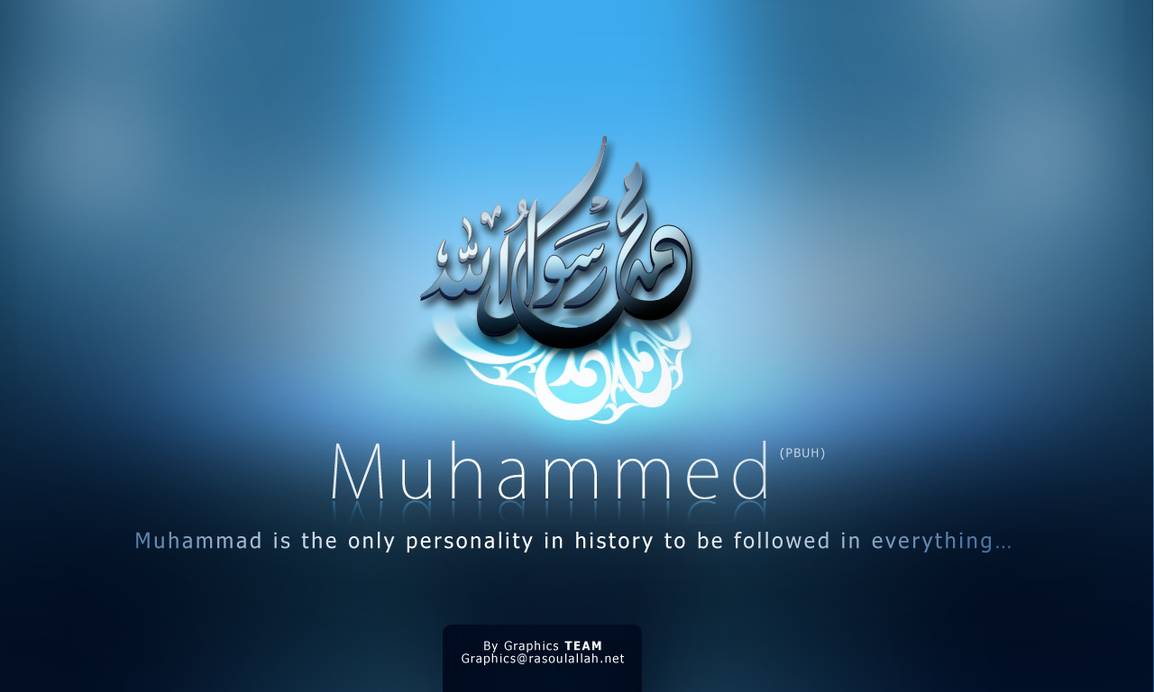عبد الغني طليس.. تجربة متنوعة لم ينصفها النقاد
متابعات الامة برس:
2022-09-06
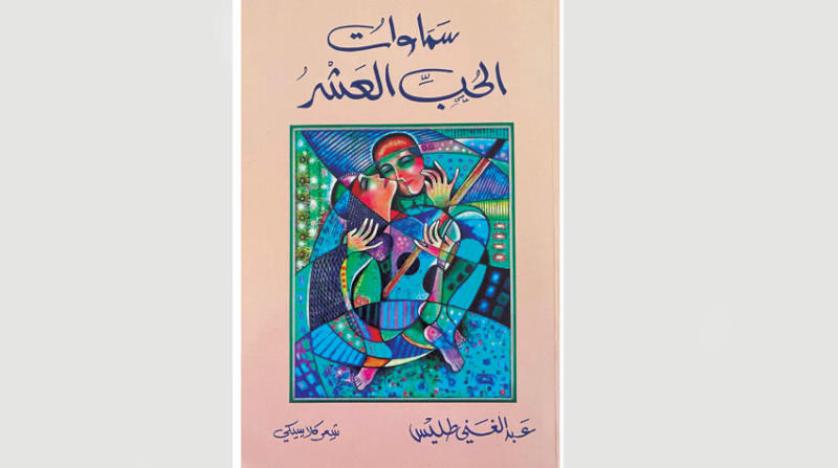
شوقي بزيع: منذ فوزه بالمركز الأول عن فئة الشعر في برنامج «استوديو الفن» في سبعينات القرن الماضي، لم يكف الشاعر اللبناني عبد الغني طليس عن تأكيد حضوره الفاعل والمتنوع في الحياة الثقافية اللبنانية. والواقع أن البرنامج المذكور، وإن كان قد وفّر للشاب البقاعي الممتلئ حيوية وطموحاً، قدراً غير قليل من الشهرة، فهو قد حمّله من جهة ثانية عبء البحث عن معنى للكتابة، أبعد غوراً من الانتشار العابر وبريق النجومية الخلّبي. ومع ذلك؛ فإن طليس، وقبل أن تشق هويته الإبداعية طريقها إلى التبلور، قد آثر أن يختبر قدراته الكامنة عبر غير مجال أدبي وإبداعي، فخاض إلى جانب الصحافة الفنية والأدبية، غمار التلحين وكتابة الأغاني والتمثيل، وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، حيث لا يزال يقدم برنامجه الثقافي «مسا النور» على إحدى المحطات المرئية اللبنانية، منذ عقدين ونيف من الزمن.
على أن هذه الخلطة المتنوعة من مواهب طليس واهتماماته، لم يكن لها أن تغيّب عن باله حقيقة أن الشعر، دون سواه، هو الفن الألصق بوجدانه، بقدر ما يمثل بالنسبة إليه هويته الإبداعية الحقيقية. وهو ما يفسره تأخر طليس الواضح في النشر، وإحجامه لسنوات عدة عن إصدار قصائده ونصوصه المتنوعة في كتب وأعمال مستقلة.
والأرجح أن الأمر ليس عائداً إلى المزاج الشخصي فحسب؛ كما يذكر طليس في إحدى مقدمات دواوينه، بل إلى شعوره؛ وقد تأخر في النشر، بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه من جهة، وإلى ارتباط الشعر عنده بعنصر المشافهة والأداء الصوتي، قبل أن يصل إلى الاستنتاج أن التدوين؛ دون سواه، هو ما يوفر للنصوص فرصة المواجهة الحاسمة مع الزمن.
وإذا كان عبد الغني طليس قد شاء لكتابه الأول «ما تيسر من عبد» أن يكون خليطاً متنوعاً من النقد والسياسة وأدب السيرة والشعر المحكي والفصيح، فهو سرعان ما أوقف أعماله اللاحقة على الشعر وحده، بوصفه الفن الأكثر فرادة وتطلباً، والأقل قابلية للشراكة والتقاسم. ومع ذلك؛ فإن طليس الضجر من القوالب النهائية للخيارات والمأخوذ بهاجس التنوع، لم يتوان عن نقل نزوعه «التعددي» ورغبته في التنوع، إلى داخل الشعر نفسه، فارتأى أن يكتب بعض نصوصه باللغة المحكية، وأن يوزع قصائد الفصحى بين النسق الكلاسيكي الخليلي وبين الشعر الحر، أو ما سمي «قصيدة التفعيلة».
ومع أن هذه المقالة لا تتسع لتقصي خيارات طليس الثلاثة، والوقوف المفصّل على أبعادها الرؤيوية والأسلوبية، فإن أية قراءة متأنية لأعماله العديدة، لا بد من أن تقودنا إلى الاستنتاج أن قصائد الشاعر المكتوبة بالمحكية، هي الترجمة الفعلية لانحيازه إلى لغة المشافهة التي تنتقل بشكل فطري من القلب إلى اللسان، ومن اللسان إلى الورقة البيضاء. وإذا كان الحب في تلك المرحلة هو موضوع الشاعر الأثير، فإن المرأة المعشوقة عند طليس لا تحضر مجردةً من «جماليات المكان» وتجلياته المتعددة، كما يقول باشلار. وعلى نسق التجارب الريادية لميشال طراد والأخوين رحباني وطلال حيدر وغيرهم، تُظهر نصوص طليس ميله الواضح إلى استلهام التراث والفلكلور الشعبي، كما ينعكس في قصائده نوع من جدلية الصورة - الصوت، إضافة إلى ثنائية الإنسان - المكان.
وليس من قبيل الصدفة بالطبع أن تحتل قصيدة الشطرين الخليلية الجزء الأكبر من نصوص طليس ودواوينه؛ بدءاً من مجموعاته الأولى ووصولاً إلى عمله الأخير «سماوات الحب العشر» الذي يكاد يقتصر على النماذج الشعرية الكلاسيكية. وليس الأمر عائداً إلى حساسية الشاعر الفطرية تجاه الأوزان فحسب؛ بل إلى إصراره المستمر على عدم الخضوع لما يعدّه «رهاب» الحداثة، وقبض سدنتها المحكم على عنق الكتابة الشعرية. وهو تبعاً لذلك لم ير في بحور الشعر خطيئة ينبغي التبرؤ منها، عادّاً أنها تحمل من ضروب الجوازات وأنظمة النبر الإيقاعي ما يستعصي على النفاد.
وإذا كان عبد الغني طليس ينطلق من الفكرة القائلة إن الشعر الحقيقي لا تحدده الأشكال وحدها؛ بل رؤاه ومعانيه وكشوفه، فإن إصراره على كتابة القصيدة الخليلية هو ضرب مزدوج من ضروب التحدي. فهو إذ يريد الإثبات للآخرين أن الشكل الشعري الكلاسيكي ما زال قادراً على استيلاد لغته وتجديدها، وفقاً لموهبة مستخدميه، يحاول من جهة أخرى أن ينازل من غير زاوية ومكان، رموز الكلاسيكية الكبار؛ بدءاً من المتنبي؛ ووصولاً إلى سعيد عقل. وهو ما يظهر واضحاً في ديوانه «أغني لعودة الملك»، حيث يدعو في قصيدته «ليسمح المتنبي لي» إلى إنزال أبي الطيب من خانة الأسطورة إلى خانة الواقع، كما يدعو الشعراء الجدد إلى محاورة المتنبي من موقع الشراكة الندية، إن لم يكن من موقع التجاوز والمغايرة، بعد قرون طويلة من تقليده وتبجيله ومحاكاته. وهو ما يعكسه قوله:
وصار ألف لزامٍ أن نسابقه
في ما استطعنا إلى إدراكه سُبُلا
وفي الإطار ذاته يقيم الشاعر حواراً مماثلاً مع سعيد عقل، الذي يسميه «حامل الكواكب» ويخاطبه بالقول:
وهذا هو الدهرُ العظيم مسلّمٌ
بكفّيه كفّيك اللطاف كتابا
فمن رقَصات النثر رقرقتَ أنهراً
وعن آلهات الشعر شلْتَ نِقابا
شهدتكَ في المجهول فُكّ حجابه
شهدتكَ في المعلوم صار حجابا
شهدتكَ حتى الموت والموتُ لعبةٌ
يصير بها درب الذهاب إيابا
وإذا كنا نعثر في قصائد طليس الخليلية على كثير من اللقى الرؤيوية والجمالية، خصوصاً حين يخلد الشاعر إلى ذاته العميقة وأسئلته الميتافيزيقية، فإن نصوصه لا تستقيم في سوية واحدة، خصوصاً تلك التي تتحول إلى سرديات وشروح ذهنية لبعض العناوين والموضوعات الاجتماعية والأخلاقية، التي يتقصد الشاعر معالجتها والإجابة عنها، كما في مقطوعته القصيرة «ربّ العمل» على سبيل المثال لا الحصر، حيث يقول:
أقلعْ عن خوفٍ أو دجلِ
واعلمْ هذا قبل الأجلِ
في أرفع أو أدنى عملٍ
لا ربّ له ربُّ العملِ
لكن من الضرورة بمكان ألا أختم هذه المقالة دون التوقف قليلاً عند التجربة المتقدمة والمتميزة التي يقدمها عبد الغني طليس في إطار النسق التفعيلي. فرغم أن كثيراً من الشعراء المتمرسين في القصيدة الكلاسيكية، يقعون في مزالق الوهن والافتعال الممجوج حين يقاربون قصيدة الشعر الحر، بحيث تبدو كتابتهم لها نوعاً من المجاراة لموجة الحداثة السائدة، يُظهر صاحب «فوق رؤوس العالمين» في قصائده التفعيلية امتلاكاً واضحاً لناصية النص الحداثي، سواء في إطار حرصه الدؤوب على اقتفاء أثر المعنى ومنعه من التشتت، أو في إطار حرصه المماثل على رفد الشكل بكل ما يلزمه من أسباب المرونة والدينامية الأسلوبية والانسياب التلقائي للإيقاع. وهو ما يظهر جلياً في ديوان «فوق رؤوس العالمين»، وعلى الأخص في قصائد «هذيان» و«سيرة ذاتية» و«حوار من طرف واحد مع الموت»، أو في القصيدة المهداة إلى زوجته وبناته الأربع، أو في قصائد الحب التي رفدت قلبه بنيران الشغف والافتتان، وأترعت مخيلته ببروق الاستعارات، وبالأطياف المخاتلة للمرأة المعشوقة، التي يخاطبها الشاعر على شفير الاختناق، بقوله:
لا تطلبي شيئاً
ولا تتخيلي أني سأطلب منكِ شيئاً،
واسمعي ماذا يدور على حوار اللمس فينا
والهواء يكاد ينضبْ
ولدتكِ نفسكِ فانتبهتِ وما انتبهتُ،
وكنتِ وحدكِ تمنحين معالمي حبّاً
يعود إلى كنوز الفطرة الأولى
وفوق معابر الأقدار يُصلبْ
ولدتكِ نفسُكِ كي أصدّقَ أن لي يوماً
إليه الآن أذهبْ