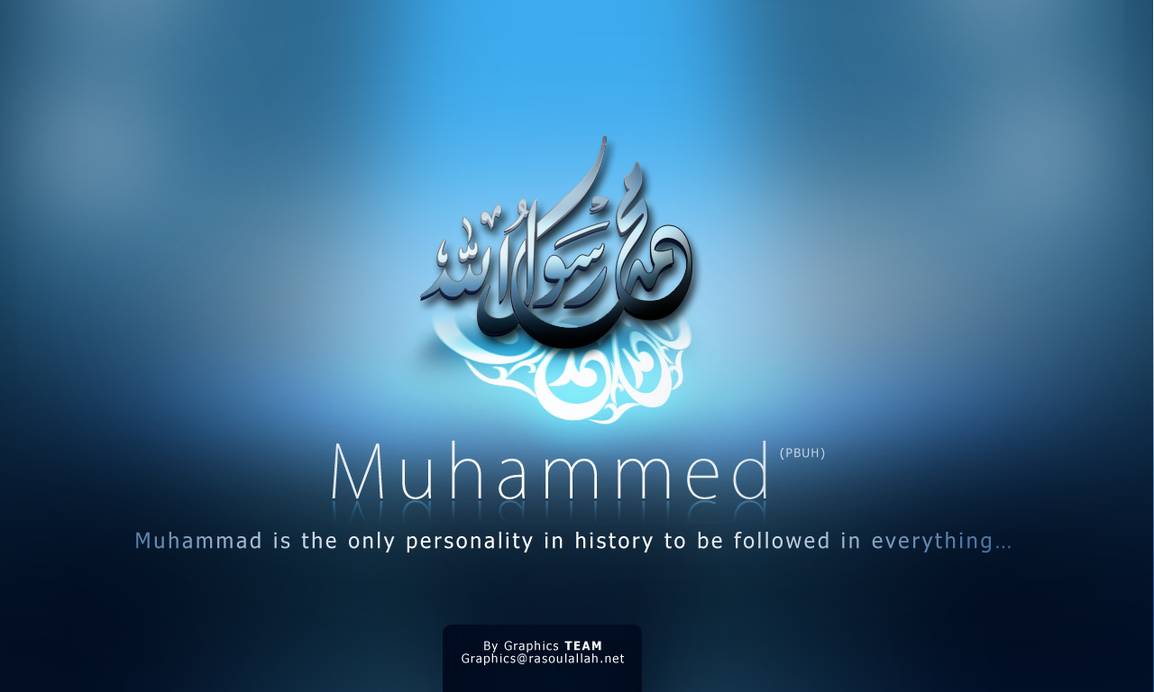سرديّات الفرح والفجيعة
2022-09-26

علي جعفر العلّاق
(1)
لن أنسى تلك اللحظة. زيارة قريتي، في محافظة واسط، حيث ولدت وعشت فيها طفولتي، بعد أن غبت عنها طويلاً. لم يكن معي يومذاك، في السيارة، غير أسرتي الصغيرة، وكان يملؤني إحساس لذيذ بكلّ ما حولي: ها أنذا أعود إليك ثانية أيّتها الطفولة! هكذا كانت أحاسيسي متزاحمة، جيّاشة. لم أكن أقود سيارتي على طرق أرضيّة، من حجر أو تراب. بل كانت تندفع بنا، أو بي على الأصحّ، مأخوذة بنداءات غامضة كانت تهبّ علينا من كلّ صوب.
كنت أتخيلها أجمل القرى وأكثرها عذوبة؛ تسترخي بمحاذاة دجلة، وكأنّها تدلّي أذيالها في مياهه المتدافعة ليصعد ذلك البلل الجميل إلى قلبها فيزيده رقّة ورهافة، ويهبّ نسيمه الأخضر على أيّامها، وحكاياتها، وأغانيها، فيجعل لها، في ذاكرتي، طراوة لا تنفد.
ورغم إنني تركت قريتي مهاجراً مع أسرتي إلى بغداد، وأنا ما أزال دون التاسعة، فإنها لم تفارقني أبداً: ظلّت كائناتها وأشياؤها تفوح من لغتي باستمرار، وظلّت طيورها الصباحيّة تملأ مخيّلتي بالضجيج الحيّ، والأعشاش الدافئة حتّى وأنا في أكثر حالاتي هدوءاً وإحساساً بالعزلة.
رائحة الجنة التي تقطر من ثيابي، تغذّيني بالحلم حيناً وبالوهم أحياناً أخرى، لأظلّ لصيقاً بذاتي وعصيّاً على التفتّت. كانت الفردوس الطينيّ الذي تفوح منه، حتى الآن، رائحة الكمأة والطين الحرّي، نباتات الخُبّاز ورِشّاد البرّ، فاكهة الرقّي والبطيخ ونكهة الشمام. وكم حدّثت زوجتي وابنتيّ وصال وخيال عنها وعن أعيادها وأغاني الأمهات أو الزوجات التعيسات فيها.
كانت لنا أيامنا الحافلة بالمناسبات الاجتماعية التي تموج بكل ما يثري النفس. وما تزال ذاكرتي تضجّ بتلك الانفعالات المنفلتة من عقالها، أيام الأعياد والأعراس، أو مآسي التاريخ، والمناسبات الاجتماعية، وتقلبات الفصول ومواسـم الحصاد، والتنادي لدرء الفيضانات، أو استعراضات القوة والتلاحـم من خلال التجمعات القبلية. فعاليات كثيرة، كنت أحضرها بصحبة والدي غالباً. ولا يتم أداؤها عنها، بغزارة استثنائية، إلاّ عبر الصوت، والكلمة، والإيقاع.
كان الصوت، الذي هو صميم تلك الفعاليات وممرها المفضي إلى الروح، يأخذني إلى أقصى مديات الانفعال ممثلاً بهلاهل النساء، أغاني الريف أو الأغاني الغجرية، نايات القصب النائحة، إطلاق النار في الأعـراس والمآتم والأعياد.
وكان للكلمة أيضاً حضورها الملهب للوجدان، أعني القصيدة الشعبية، بإيقاعاتها العديدة، كالموال أو الزهيري، والأبوذية.
والحركة التي ترافق هـذه الفعاليات جميعاً: رقصات الغجر النضّاحة بتشهيات الجسد ونداءاته، وقـع الأقدام المنفعلة في دبكات الجوبي، اندفاع الأجساد وتراجعها وسط الغبار وحركة الريح. ولا أنسى ما تتركه الأهزوجة المرتجلة من انفعال رجولي فـذّ، في تلك اللحظات العامرة بالانفعال والتباهي.
كان هـذا المزيج، من الإيقاع والكلمة والحركة، يذوب في أعماق ذلك الطفل الذي كنته آنذاك، ثم ينسرب إلى ذاكرته ومخيّلته، ويضفي على لغته، لاحقاً، ما يتلبسها من جسدية ودفء وانفعال يقيها خطر الانزلاق إلى التجريد واللغة الناشفة.
(2)
وفي الطريق إلى قريتي تلك، رأيت مدينة الكوت أيضاً، أول مدينة أراها في طفولتي. تلك التي شيّدّتها مخيلتي من أضواء وأقمشة متوهّجة وحلوى. من شوارع تضجّ بالمارة، والمقاهي، ونداءات الباعة. أشياء كثيرة لم يكن لي عهد لي بها قبل أن أرى هذه المدينة للمرة الأولى: الراديوات الجديدة، السيّارات اللامعة، الدرّاجات الهوائية، والدوندرمة، قناني البيبسي، والسينالكو، والكوكا كولا. وها هي مخيّلتي تسحب ذلك الدثار المائج بالألوان عن مدينة الطفولة تلك لتبدو على حقيقتها الموجعة: أزقّة موحلة، وغناء شجياً، وأناساً مهمومين حتى عظامهم.
كان عليّ أن أعجّل في مغادرة تلك المدينة، لا بد أن أقاوم فداحة الحقيقة الماثلة أمامي. أن ألوذ بالمخيّلة، أو أستنجد بها من جديد، علّها تسدل ستارة تحجب عني هذه المدينة المغبونة. وكان عليّ أن أواصل طريقي متجهاً إلى ما بقى من طفولتي هناك، في قريتي البعيدة:
دافئـاً كالخـرافـةِ يقتـادني الفجـرُ..
أو كالحـاً مثلمـا غيمـةٌ من شعيـرْ..
سنمرُّ على حلْمنا، ونخيِّمُ بـينَ يديهِ
نقيـــمُ لنـا منزلاً ممطراً
أو ربيعاً صغيـرْ..
سأمـرُّ على والـديَّ اليتـيمينِ:
يقتـسمان الأسى، والبشاشةَ وارفـةً، والسريـرْ..
ذاكَ تنـّورنا يتعافى من النومِ يبدأ سيرتَهُ:
حين تحضنُ أمّيَ نيرانهُ المرهفـةْ..
حافـلاً بالحنـينِ وبالأرغفـةْ..
(3)
يبدو أن بيننا وبين الأمكنة شبهاً أكيداً؛ فهي مثلنا تعصف بها الذكرى وتتلوّى حرقة على من تفارقه. وهي– أيضاً– تذوي، وتنحني ظهورها، ويعلوها الشيب والتجاعيد. وهذا ما اكتشفته حين وصلت إلى قريتي تلك.
اكتشفت أنها لا تبعد كثيراً عن مدينة الكوت، ويا لها من مفاجأة محزنة حقاً! كيف إذن كنت أحسّها بعيدة إلى ذلك الحدّ الخرافي؟ ولماذا تقلّصت الطريق؟ ولماذا تغضّن وجه الأرض إلى هذه الدرجة. كنت أتفحّص السدة الترابية المهملة مقارناً بين حاضرها الذي لا يسرّ، وماضيها وهي تتألّق في الخاطر ممتدة بين قريتي والمدينة. كانت هذه السدة، فيما مضى، مصدراً للكثير من المباهج. كنت أستمتع، في أيام طفولتي، بصخب الرجال الساهرين على متانة السدة وتماسك التراب، يقظتهم الطويلة وهم يتابعون تدفق الأنهار، والجداول، في تجوالها الليلي، يفتحون جرحاً مائياً هنا، أو يلْحمون جرحاً مائياً هناك. ولم يكن لدينا، تلك الأيام، غير باص خشبيّ واحد يمر على هذه السدة الترابية، يجمع الفلاحين صباحاً من قراهم، ثم يعود بهم عصراً تفوح من عباءاتهم روائح المدينة وغبار أزقّتها الغريب.
تملّكتني الدهشة مرة أخرى، حين اجتزت مرتفعاً ترابياً صغيراً هو آخر ما تبقّى من حافة أحد الأنهار القديمة. كان يلوح لي، في ليالي الطفولة البعيدة، وكأنّه أفق من الجبال الموحشة لا يسكنها غير الجن، والنسور، وبنات آوى. هكذا كان إحساسي بذلك النهر المتآكل، حين كان يغذّي خيالي بالمخاوف، والخرافات، والتفاصيل المربكة.
(4)
وللغجر فضل لا ينسى على تجديد أيام القرية. كنا نظنهم معروفين في قريتنا والقرى المجاورة فقط. فمن أين لنا، نحن الأطفال آنذاك، أن ندرك أن هذه المجاميع من البشر كانت تجوب العالم كله تائهة مشتتة منذ زمن طويل. مواطنون عالميون. يمتهنون التشرد أو الغناء والرقص، وبيع اللذة، أو اللصوصية أحياناً. لهم وطن شاسع ومليء بالحرمان، يمتد من الصين وجنوب شرق آسيا والهند وإيران إلى أميركا مروراً بأوروبا الشرقية والغربية. حاملين معهم أساطيرهم وغربتهم وأغانيهم، ومعتقداتهم الغريبة، في الموت والحياة والولادة وفي تفسير تشردهم من مكان إلى آخر.
لم نكن نعرف عنهم شيئاً. غامضون منبوذون، لكنهم مطلوبون في شهور معينة. لم نكن نرى الغجر إلا عند قدوم الربيع. وكأنهم مظهر من مظاهر الطبيعة. فهم إخوان الكمأة حين تستجيب لنداء الرعد في الخريف، وهم أصدقاء طيور القطا حين يجيئون متلهفين إلى مواسم الحصاد.
في القرى، كنا نحس أن للربيع مذاقاً خاصاً تماماً؛ وكان الغجر جزءاً من هذا المذاق، وعلامة من علامات هذا الفصل الذي لا يدخل قرانا خفية، ولا يكون إحساسنا به، نحن الأطفال، نسبيّاً. كنا نحس به جميعاً، وفي وقت واحد، وبطريقة متشابهة، نراه في كل شيء: في حفيف الشجر المنتشي بطراوته من جديد، في الحقول العريضة وهي تتموّج تحت الريح وكأنها أفق من السنبل الممتلئ. في الغجر الذين يأخذون في التوافد على الحقول لمعاونة الفلاحين في جمع الحاصل لقاء أجر، وممارسة عدد من الأعمال الأخرى التي تكون أحياناً أكثر ربحاً وإمتاعاً.
وكنّا نحسّ، بعنف ودونما وعي ربما، أن الربيع يتجلى في كلّ ما يعترينا أو يعتري العالم الحسيّ المحيط بنا: صداح الطيور الذي يتناهى إلينا من كل مكان، قطعان الماشية وهي تتحرّك في شتّى الاتجاهات أو تحتّكّ ببعضها بعضاً بمرح وهياج واضحين، السواقي الطافحة بالماء، والجوّ المعبّأ برائحة الحصاد الوشيك، والعشب الطالع من الشقوق.
حين يقترب موعد الحصاد، أو مع بدايته تماماً، ينصب الغجر، في طرف بعيد من القرية، خيامهم المصنوعة من الشَعْـر في الهواء الطلق. ويبدأون العمل مع الفلاحين في جمع المحاصيل، وممارسة حياتهم الغريبة، وعاداتهم الأشد غرابة بتلقائيّة تبعث على الدهشة والفضول حقاً.
كان وجودهم، الذي لا يطول كثيراً في العادة، يثير البهجة والحيويّة في القرى المجاورة كلّها. يعملون في صناعة الخناجر، ويتفنّنون في صناعة مقابضها من العاج، أو الفضة المرصّعة بالأحجار الكريمة. وكانوا، أيضاً، يصوغون الأسنان الذهبيّة للنساء. انتقالة غريبة، غرابة حياتهم، بين أدوات القتل ووسائل الإغراء، بين خشونة الرجل وجاذبيّة المرأة.
وتظلّ هناك ذروة المتع الحسيّة وأشدها خفاءً: جسد المرأة. وهي متعة لها طقوسها، وأوقاتها، وطالبوها. مشهد لا يمكن تصديقه: ينبري الرجال للعزف بينما تندفع النساء في الغناء، والرقص، ومعابثة الرجال بأكثر الحركات إثارة. قد يعزف الغجري حتى تدمى أصابعه لامرأة تتلوّى بجسدها أمام الليل والأحداق الملتهبة. يفعل الغجري ذلك ليهيىء هذا الجسد الأنثوي لأكثر الجالسين شراهة، أو أكثرهم قدرة على الدفع. وقد تكون هذه المرأة، في الغالب، ابنته، أو شقيقته، أو زوجته!
ورغم هذه المشاهد الحسية المثيرة، يظل في حياة الغجر وتقلبات أحوالهم ما يجعل للغجري فضاء رمزياً شديد الجاذبية والإثارة. يغدو الغجري، في أحيان كثيرة، رمزاً للقطيعة مع السائد والمستقر من القيم، أو الدلالة على الهامشي والثانوي، وعلى الحرمان مما يندرج فيه الكل من انسجام وتجانس ورسوخ في المكان.
وحين يجمع الغجر خيامهم الرثّة في نهاية الموسم، ويرحلون بنسائهم وذكرياتهم وآلاتهم الموسيقية البسيطة، نحسّ كأن شيئاً ما في حياتنا قد انطفأ فجأة: كنّا نراهم يبتعدون متجهين إلى جهة مجهولة يحجبهم عنا الليل وِمبالغات المخيلة، لتعود قريتنا شيئاً فشيئاً إلى حياتها السابقة وإيقاعها اليومي المألوف.
أمر واحد شديد الغرابة، كان يحدث دائماً، وما زلت لا أجد له تفسيراً: لا أذكر أنني، أو أحداً من أقراني، قد صاحب طفلاً غجرياً، أو جالسه في حقل أو طريق. هل كان الغجر كلهم يولدون كباراً؟ هل كان آباؤنا يمنعوننا من مصاحبتهم لأنهم غجريون، أم لأنهم، أي الغجر، هم الذين كانوا يأنفون من صداقة كهذه؟ كم يحزنني أننا لم نكن نرى فيهم إلا أشخاصاً عابرين: يصنعون البهجة والبشاشة لسواهم، ثم يذوبون، بعد ذلك، في الهواء أوفي الظلام، دون أن يترك غيابهم هذا جرحاً في ذاكرة أحد.
(5)
كانت القرى تتناثر على يميننا، ونحن قادمون من مدينة الكوت، بينما يمتد نهر دجلة على الجهة اليسرى في استرخاء غامض. مررنا بقرية كانت تشهد، في العاشر من محرم من كل عام، تمثيل واقعة كربلاء. كان الشيخ وأبناؤه هم المنظمون لتلك الفعالية الشجية. وكنا نتوافد من قرانا البعيدة متجهين، مع خيوط الفجر الأولى، إلى تلك الساحة الترابية الكبرى، حيث تمثل المعركة على الطبيعة، مع بداية الصباح. كنا نتماهى منذ البداية مع الضحايا، فمَن يقومون بتمثيل تلك الشخصيات هم من أبناء الشيوخ وملّاك الأراضي الشاسعة. شباب، متعلمون، وعلى شيء واضح من الترف، وجمال الطلعة، وكأنّ خيال الطفولة يرى في الضحية ملتقى للعدالة والجمال والتعاطف. أما مَن يمثلون أدوار القتلة، فهم، على النقيض من ذلك تماماً. قباحٌ، قساةٌ، متجهمون، وليسوا من ذوي السمعة الطيبة ربما. هكذا كان الخارج، خارج القاتل، في تصورنا، ترجمة لما يعتمل في داخله من شرور وشهوة للقتل.
وتصل بنا حالة الانفعال، بما يقع أمامنا من أحداث، حد الاندماج أو الوقوع على الحافة. كان الضرب بالحجارة أو العصيّ أو الشتيمة حصة مؤكدة لبعض من يؤدون تلك الأدوار البغيضة. نصبح جزءاً من فجيعة تتسع كل لحظة، ويختلط فيها كل شيء بكل شيء. نشم رائحة الدم وعطّاب الخيام المحروقة، والنساء الندابات يتشحن بالسواد القاسي، وتعود الخيول من المعركة دون فرسان. ويرتفع، ملء الكون، نهارٌ من العطش الذي لا يرتوي إلا بالموت.
مشاهد لا تفارق الذاكرة: سروج خالية، وأرسان مخضبة بالدم والتراب. ومرأى الحسين مثخناً بالجراح، وهو يذبح، وحيداً، تحت سماء مكفهرة. لا يمكننا أن ننسى تلك المشاهد. لقد كانت تحفر آثارها في ضمائرنا وعقولنا وقلوبنا الصغيرة. وبعد أن تنتهي تلك المراسم الكربلائية نعود مخذولين إلى قرانا البعيدة، مع الظهيرة، لا أحدَ منا يجرؤ على الأكل أو الشرب أو البشاشة في ذلك اليوم.
(6)
وعلى مبعدة من سيارتنا، على يسارنا بالضبط، كان النهر. المصدر الثاني لفرح الطفولة. كنا نتعلم فيه السباحة على أيدي آبائنا التي تفيض حنوّاً وخوفاً. أو نأتي بصحبتهم لننتظر معهم رسوّ المراكب القادمة من البصرة محملة بالتمر. كنت، وما أزال، لا أجد حلوى أخرى تضاهيه حلاوة لا في الشكل ولا في الطعم، وأكثر ما كان يثير شهيتي منظر خصّافة التمر، والدبس يقطر، مضيئاً، من جوانبها.
ولمشهد الموت أحياناً حيزٌ واضحٌ في مسيرة هذا النهر. طالما شاهدت وأنا برفقة والدي، في تلك السن، كيف يقف الناس مفجوعين على جرف النهر وهم يرقبون الموج، أو يسيرون مع حركة الماء في انتظار غريق يطفو بعد أن ارتوى، حدّ الموت، من رمل القاع.
بطاقة
شاعر وناقد وأكاديمي عراقي من مواليد عام 1945 قرب مدينة الكوت. تخرّج في قسم اللغة العربية بـ"الجامعة المستنصرية" في بغداد عام 1973، وحصل على درجة الدكتوراه في النقد والأدب الحديث من "جامعة إكستر" في بريطانيا عام 1983. عمل أستاذاً في العديد من الجامعات العربية.
صدرت مجموعته الشعرية الأولى، "لا شيء يحدث، لا أحد يجيء"، عام 1973، وأتبعها، منذ ذلك الحين، بأكثر من عشر مجموعات أُخرى، من بينها "شجر العائلة" (1979)، و"فاكهة الماضي" (1985)، و"ممالك ضائعة" (1999)، و"سيّد الوحشتين" (2006)، و"ذاهـبٌ لاصطياد الندى" (2010)، و"طائر يتعثّر بالضوء" (2018). كما صدرت أعماله الشعرية الكاملة في أكثر من طبعة.
تناول في أعماله النقدية مواضيع عدّة، مثل خصائص القصيدة الحديثة، ونظرية النصّ، ومسألة تلقّي الشعر، إضافة إلى علاقة النصّ بالآخر. من آخر أعماله النقدية: "من نص الأسطورة إلى أسطورة النص" (2017)، و"الحلم والوعي والقصيدة : مقالات في الشعر وما يُجاوره" (2018)، و"المعنى المراوغ: قراءات في شعرية النص" (2020).
كما صدرت حول تجربته الشعرية كتبٌ عديدة، من بينها "شعرية الذكرى: قراءة في كتابات علي جعفر العلّاق" (2008) لمصطفى الكيلاني، و"علي جعفر العلّاق: حياة في القصيدة" (2015) لعبد اللطيف الوراري، و"علي جعفر العلّاق، شعرية الحداثة وحداثة الشعر" (2019) لإبراهيم خليل.
فصل من كتاب "إلى أين.. أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية" الذي يصدر هذه الأيام عن "الآن ناشرون"