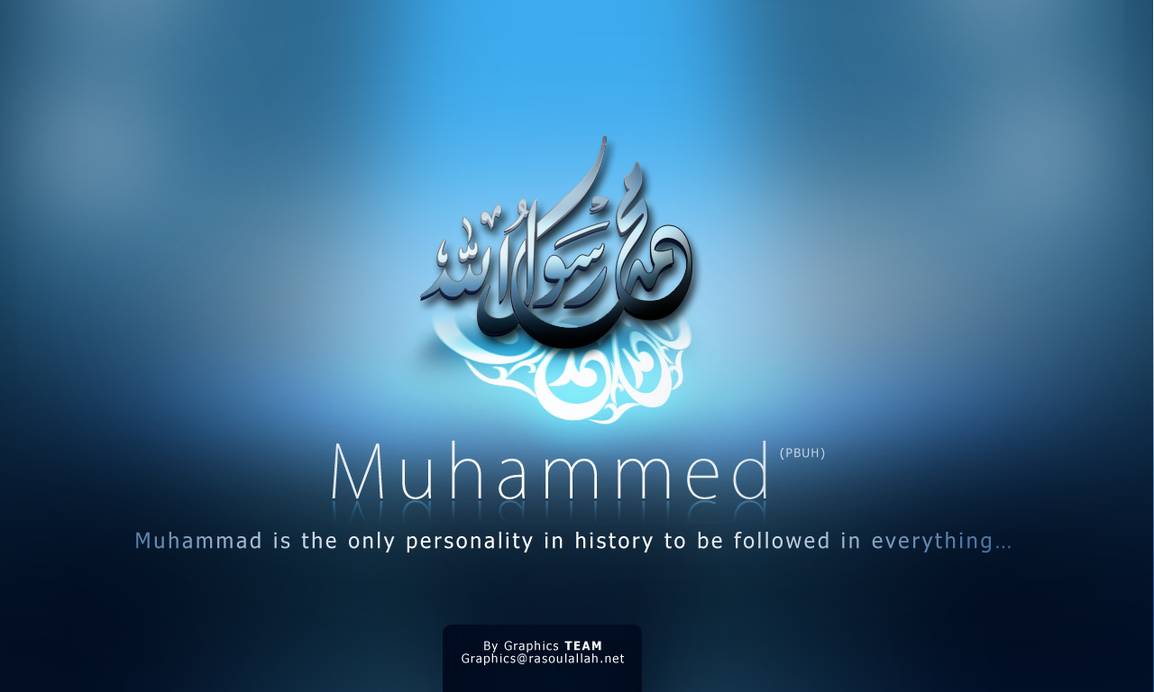«حين تتشابك الحكايا» لسلوى الجراح: التغريبة الفلسطينية مجددا
2022-10-04

خالد بريش
مع بداية القرن الواحد والعشرين بدأنا نلاحظ أن الرواية الفلسطينية أخذت تقدم للقراء العرب وللعالم أجمع نوعا جديدا من السرد، لم يألفوه في أنماط الرواية العربية. وكما كانت لهم مدرستهم الريادية في الشعر، وأنتجوا ما أطلق عليه «شعر المقاومة» فإنهم أخذوا يغرسون أقدامهم في عالم السرد الروائي بأسلوب وحلة جديدين، مستفيدين من تجربة الكتاب الرواد الذين سبقوهم، وكذلك من التجارب العربية والعالمية متخيلا وأفكارا ونمطا وأساليب تعبير.
وعلى هذه الطريق سارت الكاتبة سلوى الجراح في روايتها الجديدة « حين تتشابك الحكايا » الصادرة عن دار المدى في العاصمة العراقية بغداد، التي تعتبر رواية حداثية من حيث تقنيات السرد والأسلوب، وطرحها لقضايا اجتماعية جد شائكة، مبتعدة بذلك عن المدرسة الكلاسيكية، التي اعتدنا عليها في الرواية العربية، حيث أفسحت المجال لكل واحد من بطلي روايتها، ليروي الحكاية نفسها من وجهة نظره الخاصة وبأسلوبه. البطل يروي حكايته بأسلوب محمل بمشاعر الرجولة، ونظرته الخاصة إلى الأمور التي طرحتها الرواية. في الوقت نفسه الذي أعطت الكاتبة البطلة فرصة التعبير، فقامت بدورها برواية الحكاية نفسها من بدايتها، بأسلوب الأنثى وأحاسيسها، ورهافة مشاعرها الآسرة فتجعل القارئ يقترب منها، فيشعر وكأنه يستمع إلى حديثها الحميمي مباشرة، فتتشابك بالتالي حكاياها التي عنتها في العنوان مع دواخل القارئ.
سرد سلس بإيقاع منتظم، هو أشبه ما يكون في كثير من فقراته بالتداعي الحر، المُحْتوي على كثير من البوح والحكايا الخاصة، التي تستريح في ثنايا السطور بشكل غير مباشر، مُسْتخدمة في ذلك أسلوب القناع والتخفي وراء المفردات، تاركة القارئ يكتشف ذلك بنفسه، لكنه بلا شك سوف يتوه في بوتقة السرد وأسلوب الكاتبة الشيق، الذي لن يعطيه فرصة لكي ينتبه إليه، ولا لكي يتحكم بمتخيله كثيرا، حيث يلفلفه إيقاع النص الروائي بشكل تام، خصوصا أن الكاتبة أخذت على عاتقها الترويح عن نفسه في محطات خلال السرد، باعثة من خلالها رسائلها السياسية، وأيضا لتدلي بدلوها في الواقع السياسي الفلسطيني، عبر عبارات باعثة على الابتسام، ما يولد لدى القارئ دفئا، ويقربه من النص أكثر، ويشرع أمامه النوافذ ليطل بدوره على الواقع السياسي والإنساني بحلاوته ومرارته، كتلك العبارة « ياسر عرفات بيحب يبوس »…
هذا ويلعب المكان أو مسرح السرد دورا مهما، كونه ليس شوارع ومدنا أو بلدا بعينه، لكنه عالم محدود بمقهى ومكتبة جامعية، وأخرى لبيع الكتب، وبيت فلسطيني في عالم الغربة يختلف عن بيوت بقية البشر، حيث يتصدره المفتاح الحامل لأسرار فلسطين، أرضا وشعبا وتاريخا وتراثا وسحجات وأغاني.. بيت في أساسه صورة طبق الأصل عن حياة الفلسطيني الذي خرج من بلده ولم يخرج بلده من أعماقه، فكان كعصافير السنونو لا يستقر في مكان لأن الاستقرار بالنسبة له موت ونهاية لذكرياته عن بلده، وعملية استبدال للأصل بوطن بديل مزيف.
فهو في حركة وطيران بلا توقف بانتظار شجرة الزيتون في قريته، والميرامية في بيارته وأرضه هو، ليستقر عليها لأنها هي رحمه.. وعندما يتغير المكان، فالحديث يكون عما يطلق عليه « الشتات » فتنقلنا الكاتبة لتأخذ بأيادينا ما بين عكا وطولكرم وبغداد ولندن والقاهرة ومخيمات غزة.. لكن يبقى الحلم في كل صفحات السرد يسير في خط متواز في اتجاه واحد، ويتجسد في فلسطين.. أما الزمان فهو زمن ما بين الوطن الحلم، أجبر أهله على مغادرته، وحرم هو من العيش على أرضه، وغربة قاسية أليمة، بدأت مع الخروج وتغريبة العصر الحديث المرة من أرض فلسطين.
يتحول المكان ضمن السرد إلى خشبة مسرح محدودة المساحة، لكنها تتسع شيئا فشيئا كلما انخرط القارئ في صفحات الكتاب وسطوره، لتنطلق من فوق خشبتها القصص الصغيرة، التي تجعل القارئ يدخل في حياة أفراد شخوص الرواية الأساسيين بسهولة، ما يتيح بالتالي للكاتبة حرية الحركة والإمساك بخيوط أحداث الرواية. فالبيت عندما يكون منطلقا، تكون الذكريات قسيمه، فتسافر الأفكار عبر نافذته بزيارة إلى كل الأماكن الأخرى التي يعرفها سكان البيت أو عاشوا فيها… ما يسمح أيضا باستدعاء كل أنواع الذكريات المرتبطة ببعض قطع الأثاث كالكنبة، التي جعلت منها الكاتبة مدخلا إلى عوالم البيت وحميميته.
تعشش الرومانسية بين سطور السرد وتركيبته الفنية من بداية أحداث الرواية التي تبدأ بصدفة ككل الصدف التي تمر في حياة البشر، ولقاء كلاسيكي من لقاءات الشتات بين رجل وامرأة، سريعا ما يتداخلان نظرات وقلبا وروحا لتصبح كلمات أغنية فيروز «نسيت من يده أن أسترد يدي» هي حال كل واحد منهما. لتأتي مجموعة القصص الصغيرة كمُكمِّل للرواية من حيث البنية والتركيب، فتستدعيها الكاتبة إلى سردها، لتقوم من خلالها بإسقاطات تمررها بهدوء ما بين ابتسامة وجرعة من المرارة والأسى…
تتناول الرواية في أحد جوانبها مأساة التغريبة عن الوطن، والحنين الذي يمزق الدواخل إلى تلك الأرض الحاضرة في الوجدان، وكل اليوميات والتصرفات وتقلبات الزمن التي يمر بها الفلسطيني.. حكايات الدموع والحسرات على أرض عجنت بدماء وعرق الأجداد، وعن البيت والمفاتيح والحياة داخل المخيمات الفلسطينية « حيث يرث الأبناء مهنة الوالد ودوره كأب، وأن تتعلم البنات الصغيرات كل ما تجيده الأمهات» أي يتحولن إلى أمهات وهن ما زلن في عمر الطفولة.. إنها رحلة استبطان في عالم الذكريات، وتطواف في الماضي بشكل مباشر تارة، وغير مباشر تارة أخرى. لتذكرنا الكاتبة جراح عبر سطورها، ومن دون أي تنافر مع السياق، بكثير من الأحداث التي عصفت في فترات معينة بوطننا العربي، وشكلت معالم وأحداثا فاصلة لا يمكن نسيانها، مثل نكبة 1948 ونكسة 1967 وحرب 1973 إلى حرب العراق إيران، واحتلال الكويت إلخ. وتعرض الكاتبة خلال سردها لبعض المواقف القاسية التي تبعث ألما في الداخل، كأن يحتاج الفلسطيني إذنا لزيارة بلده فلسطين ممن احتلها وصادر أراضيها، وإذنا آخر للعبور على الحاجز من مجندة شابة، ولدت في مكان ما من العالم، لا يربطها بهذه الأرض رابط على الإطلاق.. لكن انتماءها لدين معين، يعطيها على هذه الأرض حقوقا، لا يمكن لأصحابها وملاكها الحقيقيين ممارستها، وهل هناك ما هو أشد إيلاما، من أن يشعر الإنسان بالغربة وهو على أرض وطنه، وبين شعبه «لا أستطيع أن أفهم لما هناك مخيمات للفلسطيني في فلسطين، ولما لا يعيشون في المدن التي لجأوا إليها؟ ». مبينة عمق المأساة، وذلك العبث اللامفهوم «المخيم مهما كبر حجمه سجنا بأسوار لا يحق لسكانه الخروج منها».
كاتب لبناني