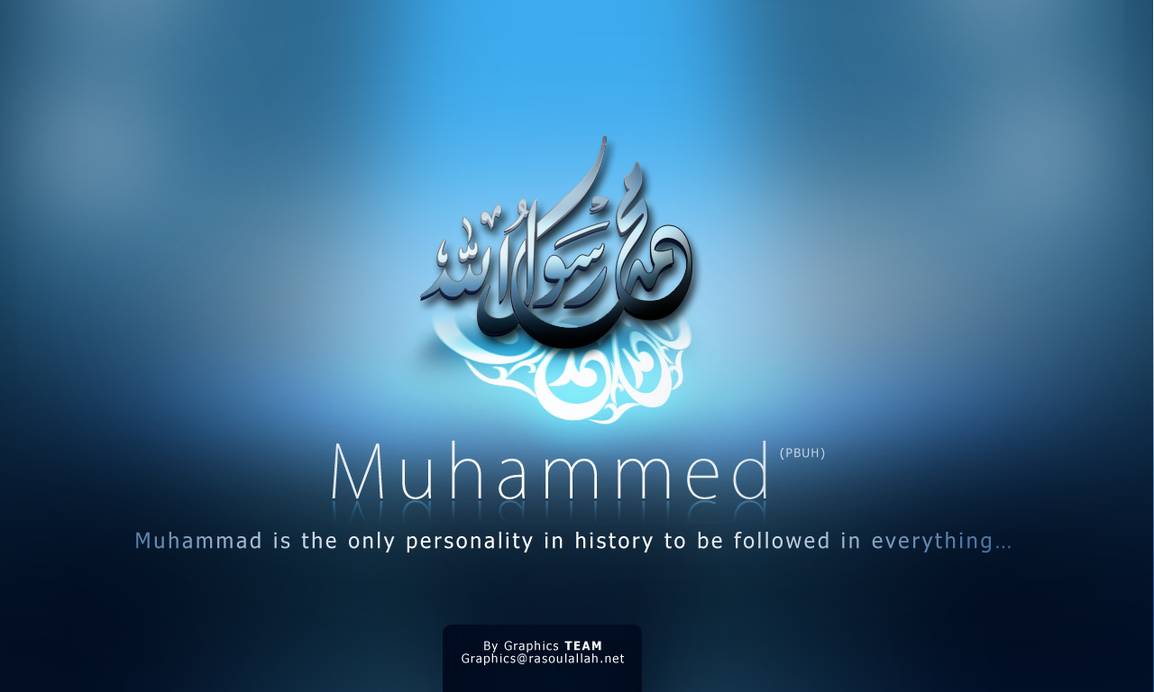ديك الطقس
2022-10-06

حسن ناصر
شعرت بوخزة في صدري وخالجني شعور بالرعب. استيقظت مبكرا قبل طلوع النهار مشوّشا بأضغاث حيرة ممزوجة بالتسليم خلّفتها أحلام ليلة عاصفة. رياح كادت أن تقتلع الأشجار من مكانها أو هكذا خُيّل إليَّ وأنا في فراشي أحدق في سقف غامض ومصباح مطفأ. لعل هدير الرياح المخيف طوال الليل هو ما أجّج الفتيل في قناديل عتيقة رقدت مطفأة لدهور، وأشعل ذكريات أوهنها النسيان. بدأ النهار ينبلج رويدا وأصوات العجلات البعيدة التي تسرع على شارع فكتوريا في پاراماتا في سيدني ما تزال قليلة تئز بين الحين والآخر.
ما زلت أسكن في هذه الشقة منذ ما يقارب الثلاثين عاما. يوم نزلتها أول مرة كنت أتوقع أن إقامتي فيها لن تتعدّى الشهور، لكنها طالت وامتدت وتواصل شعوري بأني على وشك المغادرة. واصلت دون دراية تأثيثها بما تبقّى لديَّ من الماضي؛ بكتب وصناديق رسائل، وصور، ولوحة واحدة. لكن الشقة ظلت غريبة طارئة لسنوات. لم تكن تشي باستقرار كما يمكن أن يفعل البيت، بل على العكس ظلّت لأعوام تشي بالمرور بالعبور الدائم في رحلة بدت وكأنها لا تنتهي. في البداية لم تكن أكثر من مجرد محطة، لكنني صحوت بعد اثني عشر عاما لأحس فجأة بأنها بيتي ومنتهاي. كنت أقف لأطل عبر النافذة على البناية المجاورة، لاح لي ديك الطقس متحركا مؤشرا اتجاه الريح مهتزا معها، فجأة امتلكني شعور غامض بأنها مكاني الأخير.
بقيت راقدا في مكاني أراقب النمو البطيء لقوة النهار تتجلّى قبالتي على جدار أبيض علّقت عليه طوال السنوات صورة قديمة وساعة عاطلة وصورة للوحة بت أراها ضحلة وربما ومبتذلة (ساعات سلفادور دالي المائعة). نظرت من مكاني أحدق في وجهي قبل ثلاثين عاما جامدا في الصورة القديمة. نعم أتذكّر اللحظة. كنت مليئا بالأمل، أتذكّر ذلك الوجه وأعرف ما وراءه تماما، لكنه في واقع الأمر لم يعد وجهي. وجهي الآن وجهٌ آخر. حاولت مرارا رفع الصورة من مكانها لقرفي من رؤيتها أمامي كلَّما أفقت. لكني لم أجرؤ على ذلك رغم قرفي من الاستيقاظ كلَّ صباح على عقد المقارنة بين وجهي الفتي في تلك الصورة ووجهي الآن. لم أعد أعرف الآن كم تبقّى من وجوهي الأخرى عبر المحطات. أما وجهي القديم في طفولتي البعيدة فقد غاب تماما، ولا شيء يدل عليه الآن. كان وجهي في الصورة، في بداية غربتي الطويلة، ملاذا وحيدا آوي إليه. كان الهوية التي تجمل الماضي، لكن الملامح مرايا الزمن والأماكن ولم أعد أعرف الآن كم تبقّى منه أو من وجه ذلك الطفل المسكين في عتمة مساء يلف باحة بيت فقير، رددت جدرانه صوت صراخ موجع.
للوجوه أسرار لا تدرك. قد تكون نعَمة أو نقمة مزمنة. إنها شاشات أنواتنا والمضمار الذي تنفلق فيه ألعاب انفعالاتنا. صدمني وجهي في لحظتين غريبتين على هذا الكوكب فتوقفت وتأملته. في المرة الأولى كانت أيامي المسمومة بمجريات الحرب دمىً تسقط على الإسفلت من بنايات شاهقة، هكذا وصفها صديقي ونحن نتسكع في بغداد غير بعيد عن مرقد السهروردي عام 1984. في صباح من تلك الصباحات التي كانت تكتنز بالفواجع أيضا، حيث كانت أجيالنا طعاما للمواضع والقنابل، وعند بوابة كلية الآداب في بغداد تأملت وجوه الطلبة المزدحمة من حولي حيث تلوح بقايا أحلام وكوابيس معلقة على الرموش. تأملت الابتسامات المتنوعة كألوان الثياب المستعملة في سوق الملابس المستعملة «تحت التكية» والعبوس الذي بدا مبررا ومقبولا.
مكياج الطالبات الذي كان ينقذ أيلول/سبتمبر من كاكيته، أو يبدو مفرطا مهذارا كنشرة الأخبار. فجأة تكشَّفت لي كوميديا الوجه البشري: الأنوف الاعتباطية، العيون التي تتوهم الاتفاق، الأفواه ذات المزيج الجنوني من المهام، الآذان وشحماتها التي تشي بالكثير، والجباه التي تحمل نقوش المصير. ضحكت كالمجانين، تركت لرئتيَّ لفظ ما فيهما من قهقهات. الضحك لحظة حياة في لجة الموت. جبت أروقة وحدائق الكلية جذلا قبل أن يستعيد اليوم رتابة عام 1984. لم أكن متآلفا مع ملامحي قبل ذلك الصباح، ولطالما وددت لو أجري تغييرات عليها. في غرفة عمليات المرآة أيام صباي المبكر افترضت تعديلات كثيرة: رفعت منخريي، وسّعت عينيَّ وافترضت شكلا آخر لحاجبيَّ، لكنني أدركت في ذلك الصباح فخ الوجه الشخصي ورحت أتأمل وجه الوجود.
كان ديك الطقس قطعة المعدن يلوح عبر النافذة لامعا، دون وجه أو تفاصيل يشهد مرور الوقت وحركة الرياح كما هو دائما، قبلي بكثير وبعدي بما لا يقاس.
في المرة الثانية تحاملت على وجهي وأصبحت أكنُّ له الكراهية. في آخر اتصال هاتفي مع أمي قبيل موتها، قالت لي إنَّ أمنيتها الوحيدة هي أن ترى وجهي ثم بكت. سمعت نحيبها فأغدقت عليها وعودا هزيلة ولم أتمكن من حمل وجهي والذهاب إليها. كانت تموت وحيدة يعذبها الحنين إلى ملامح أصغر أبنائها. يوم سمعت بموتها وقفت أمام المرآة وهمست من ذروة الندم: الوجه ذنب.
أشعر في أعماقي بالحنين إلى العصور التي لم يكن متاحا للمرء فيها رؤية وجهه سوى بضع مرات، إلى عصور بلا مرايا ولا مصابيح ولا صور. لعل أسلافي من مزارعي الرز على أطراف البحيرات الشاسعة التي يغذيها فيضان دجلة جنوب بابل كانوا أكثر وفاء لوجودهم؛ لذواتهم وهوياتهم. لم تشوّشهم رؤية وجوههم المتغيرة في المرايا والصور، وما تدل عليه من وهمٍ وزوال. رأوا حتما التغيرات على وجوه الآخرين ولم يتح لهم إلا لماما وبصورة ضبابية، أو رجراجة تأمل ملامح وجوههم. نحن محاصرون برؤية وجوهنا أنّى التفتنا، نحصي ما انتابها من تحولات، نعيد لعب الماضي في عصر يسمونه؛ عصر إعادة لعب الماضي بالصور؛ بالثابت منها والمتحرّك.
شعرت بوخزة تخترق كياني.. يندلع حريق النهار من ضوء وصخب. الريح ساكنة وأنا ساكن وديك الطقس ساكن دون أن تظهر عليه بقية من الدوران مع الريح العاتية طيلة الليلة الماضية. ديك من المعدن يقف منتصبا على سهمين متقاطعين يؤشران الجهات الأربع. أتذكر أني رأيت ديك الطقس في أفلام الكارتون في طفولتي البعيدة وفي الأفلام الغربية. وصرت أحس بشيء من الغرابة، أو ربما الألفة تجاه شكله ومغزاه. صرت أراه كلّ صباح من نافذتي وأرى حركته أحيانا وهو يدور مع الريح بحياد مخيف. مرت عليّ أيام هنا في هذا المكان الضئيل جدا من هذا الكون اللانهائي، وأنا أتساءل بألم هل أنا مجرد ديك طقس يستجيب للرياح؟
كاتب عراقي