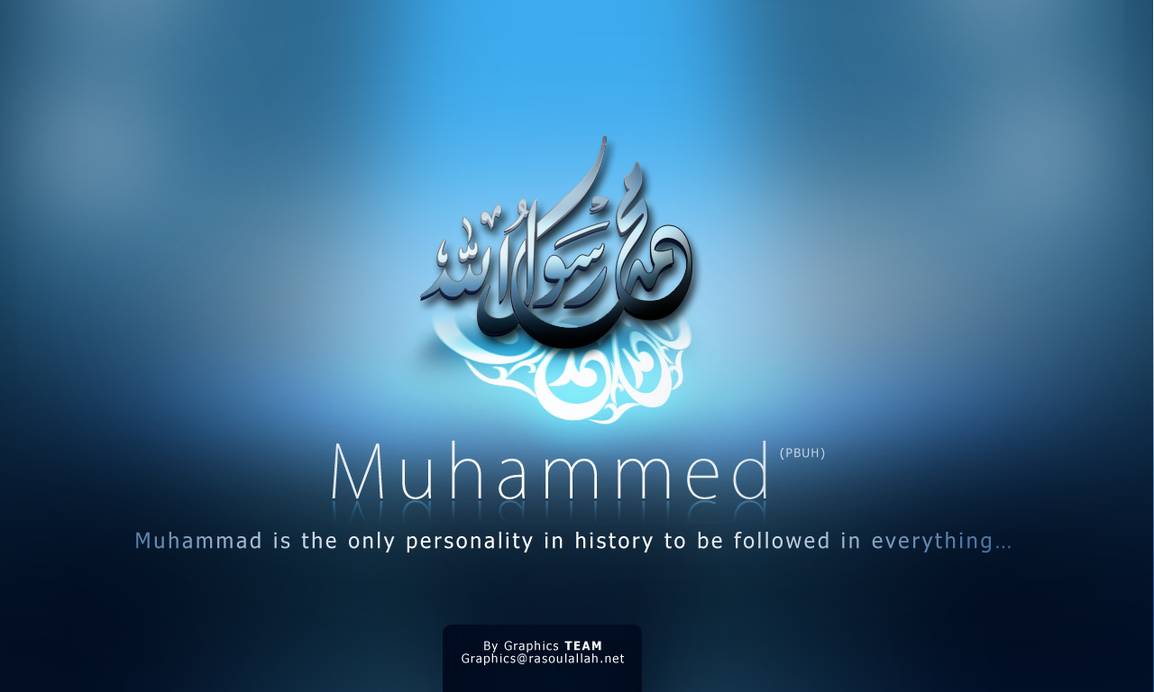«كجثةٍ في رواية بوليسية»: عائشة البصري تسرد حياة الإنسان أيام كورونا
2023-01-29
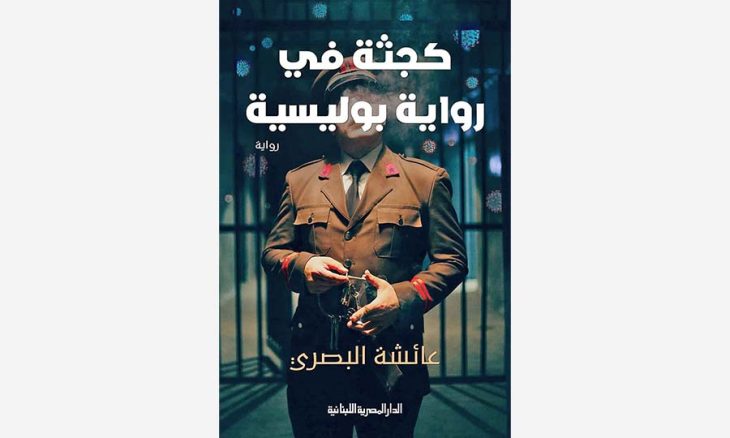
سفيان البراق
الأدب والجائحة
يُخبرنا التاريخ بالعلاقة الوشيجة التي تجمع الأدب بالنوائب والبوائق (الأوبئة والحروب) المِصدامة التي عصفت بحياة الإنسان. خلف الأدب، رغم المآسي التي حركت خزان الأحزان، تحفاً سردية بديعة.
التاريخ المكتوب وثق وأرخ لعدة أوبئة، لا يسع المجال لذكرها كاملة، نجد من بينها: وباء الطاعون الذي استشرى في زمنٍ غابرٍ، وفتك بالإنسان، وأدمى قلوب الأهالي، فوباء الكوليرا الذي قضى فيه الألوف من البشر، ثم الإنفلونزا الروسية والإسبانية، وصولاً إلى أوبئة عرفها الإنسان لكن الأدباء لم يترجموا وقائعها ومخلفاتها في نصوصٍ سردية؛ أعني: السل، الجدري، الإيدز، إلخ.
انطلاقاً من التاريخ نستشف أن كل هذه الأوبئة تَمكن الإنسان من حصرها في منطقة جغرافية معينة، دون أنْ يتسع نطاق انتشارها، وبالتالي فهي بقيت محلية معزولة، بيد أنه في الشهر الأخير من سنة 2019 بدأ وباءٌ مارق يجتاحُ الصين، ثم ما لبث أن زحف في اتجاه مختلف دول العالم، قاطعاً الفيافي والقِفار والمحيطات والقارات، يضرب ضرباته الشرسة، وما ترك مكاناً إلا احتلهُ، ليبث الخوف في النفوس، ويزنر الأعصاب، ويُسعّر مشاعر الحزن والسأم، دون رأفة بالإنسان، الذي لم يفتأ يكتشفُ ضعفهُ الكبير في مثل هذه الحالات العصيبة.
اختلال في الذاكرة
اعتنت بعض النصوص الأدبية، في المغرب تحديداً، بجائحة كورونا، وبلورت التحول الذي طرأ على حياة الإنسان في ظل الوباء. ولعل رواية «كجثةٍ في رواية بوليسية» للكاتبة المغربية عائشة البصري، نموذج بارزٌ لهذه الأعمال التي واكبت جائحة كورونا. صدرت هذه الرواية في طبعتها الأولى سنة 2020، وتقع في 156 صفحة من القطع المتوسط. اخترتُ هذه الرواية كنموذج لكونها اتسمت بعدة خواص جعلت منها روايةً متكاملةً ومُتفردة. أبانت الكاتبة في هذه الرواية عن تمكنها من حِرفة السرد ببراعة عز نظيرها، كما أنها قفزت على حبال العبارات برشاقة كبيرة؛ إذ كَتبت بعبارة لغوية تُلهبُ وجدان القارئ وتستميلهُ، كما عمِدَتْ إلى استخدام تقنية فريدة أثناء السرد تمثلت في إقحام حكاية داخل الحكاية، أو ما يُصطلح عليه في لغة النقاد بـ«ميتا القصة». جنحت الكاتبة في الأخير إلى توظيف تقنية حديثة مفادها أن الساردة التي روت مرويتها بضمير الـ«أنا» كانت مرويتها مجرد تهيؤ ووهم، وهذه التقنية يجنحُ إليها الروائيون بهدف الخلاص من نسق الحكي الذي يأبى التوقف، وشبيهها في ذلك أن يظل السارد يحكي، وفي الأخير يفاجئ القارئ في أنه يعيش كابوساً، وما إنْ يستيقظ حتى يتبدد الكابوس، ويجد يدهُ قابضة على ريحٍ هاربة.
تبدأ صاحبة الرواية روايتَها بوصفٍ دقيق لغرفة غريبة الشكل: كانت النوافذ على شكل مثلثات وكذلك الباب والسرير والطاولات، وتضمنت ثلاثة مجلدات للكتب السماوية: التوراة، الإنجيل، القرآن. توجد هذه الغرفة في مركزٍ شديد الحراسة ترقدُ فيه الساردة وتخضع للتحقيق من طرف رجل يرتدي بذلة عسكرية، يعرف عنها كل شيء تقريباً، وكان يتغيى من وراء استجوابه لها معرفة مدى صدقها، برفقة مساعدته، وقد منحته الكاتبة سمات غريبة جداً تتنافى مع الخواص البشرية المتعارف عليها، ونقرأ في هذا المضمار: «فور إغلاقنا الملف، لا أنا ولا مُساعدتي سنتذكرُ ما بُحتِ به خلال هذه الساعات. حين سنغادرُ الغرفة سيمحو المُدير العام للمركز ذاكرتي تماماً» . معظم الأسئلة التي وجهها إليها كانت ذات صلة بحادث اختفائها منذ سنة 2010. هذا المركز الذي ترقد فيه الراوية لم نتعرف على طبيعته إلا مع توالي الصفحات، فهو مركز يراقبُ الصحة العقلية بالدرجة الأولى، وقد يجرد من يرقدُ فيه من عقله.
الشخصية البطلة في هذه الرواية تدعى سعيدة، تعاني من اختلال في الذاكرة، حيث نست كل شيء عن حياتها تقريباً، وتستعيد ذاكرتها لوقتٍ وجيز قبل أن تفقدها مجدداً. وقد احتجزت في هذا المركز بعدما جُردت من جميع ثيابها وحواسها. وكانت الغاية من وراء احتجازها في هذا المركز، معرفة أرشيف ذاكرتها منذ سنة 2010، وهي السنة التي لاذت فيها بالفرار من هذا المركز، حتى يتأكدوا من جاهزيتها للموت، لأن من بين اختصاصات هذا المركز هي تقديم رخصة رسمية لمغادرة الحياة، بالإضافة إلى أرشفة حياتها منذ صرختها الأولى في الوجود إلى أنْ تُغمض عينيها إلى الأبد.
في ظل سرد الكاتبة لهذه الحكاية العجائبية، كانت تستطرد بالقول، إن البطلة المحتجزة في المركز كانت تسمعُ، من حين لآخر، في الجهاز اللاسلكي للمحقق أنباء عن اجتياح فيروس للعالم شل حركته اسمه: كورونا. وقد ظل الصوت يأتي من اللاسلكي يحمل العواجل، المثقلة بالخطر والخوف، حول هذا الفيروس. وفي لحظة استعادت البطلة، كما خُيل إليها، ذاكرتها دفعةً واحدة لتستحضر أحداثاً تتنافى كلياً مع الواقع، فانتبه المحقق إلى الجرأة التي تتصفُ بها هذه الأحداث والطابع الغرائبي الذي يطبعُها، ليعتقد في بداية الأمر أن السيدة التي تحكي الآن ليست هي من عاشت هذه الأحداث.
أبعاد الفنتازيا
هذه الرواية تندرجُ ضمن صنفٍ أدبي معروف هو «الفانتازيا» الذي يعتمدُ على الخيال الجامح والحكي عن أمورٍ يستحيلُ أن تحدث، كالحديث عن قوىً خارجية مثلاً، مع إضافة عنصر الواقعية، لتكون الرواية متأرجحةً بين الواقع والتخييل. وتتجلى الغرابة بقوة في هذه الرواية عندما ادعت البطلة، وهي كاتبة، وأعمالها توجد في الغرفة التي ترقدُ فيها، أن ما تعيشه الآن سبق وكتبت عنه، وأن شخصية المحقق ومساعدته سبق لها وأنْ كتبت عنهما، وقد خرجا من روايتها ليجدا طريقاً إلى الواقع. ظل استجواب بطلة الرواية متواصلاً بلا انقطاع، سواء بالترغيب أو الترهيب، وجهاز اللاسلكي يصدحُ منه صوت مبحوح، يؤكد ضرورة الاحتراز من الفيروس التاجي، دون أن يُعير المُستجوِب لذلك أدنى اهتمام، وحينا آخر تخرج النداءات من مكبر الصوت للمركز تنبه المحققين والمقررين عدم التجوال بين أجنحة المركز إلا للضرورة القُصوى. بعد تواصل الاستجواب أدركت البطلة، بما لا يدعُ مجالاً للشك، أنها تعاني من اختلالٍ عقلي، وهو ما يظهر بجلاءٍ كبير، في مختلف أطوار الرواية. لذا فإن الرجل والمرأة اللذين أقدما على استجوابها هما من ابتداع عقلها المُهتز، لتبوح قائلةً: «أعاني منذ سنوات الصبا من تضخم الوهم، أتوهم أشياء، أحداثاً، مشاعر… هل تحول التوهم إلى انفصام، وأنا الآن أتخيل رجلاً وامرأة في غرفةٍ بيضاء». كانت للبطلة، المكبلة في السرير في المركز، ثلاثة مصادر للتواصل مع العالم الخارجي؛ الذي يرمزُ لأبنائها: المصدر الأول يتمثلُ في المحقق ومساعدته رغم اقتصادهما المُفرط في التواصل، والمصدر الثاني يتجلى في جهاز اللاسلكي للمحقق ومكبر الصوت الذي يوجد في المركز، بينما المصدر الثالث يكمنُ في التمثلات التي تُشيدها مخيلتها الواسعة بسبب العطب الذي لَحِق ذاكرتها. في أحد المشاهد، وبعدما توالت التنبيهات والأخبار العاجلة من اللاسلكي بخصوص شيءٍ غيّر ملامح الحياة الاعتيادية؛ عنيت: جائحة كورونا، بدأت الأسئلة تقفزُ إلى ذهنها دفعةً واحدة محاولةً استيعاب الوضعية التي هي فيها وربطها بما يصدر من مكبر الصوت وجهاز اللاسلكي، رغم الخلل الذي ينخرُ عقلها. يلحظ القارئ من خلال هذه التنبيهات أنها كانت في البداية أقل رعباً، ومع توالي الأحداث، ازدادت حدتها، وهذا يظهر بجلاء للقارئ عندما يقارن بين أول تنبيه وآخر عبارة صدرت من اللاسلكي. انثالت الأسئلة على سعيدة وأحدثت رجة في ذهنها، لتكتشف بعد أن استعادت ذاكرتها جزئيا، أنها عاشت في السابق تجربة مماثلة لها في هذا المركز الذي بلا هوية، وكتمت سر مكوثها فيه لسنوات، أو بالأحرى التلف الذي أصاب ذاكرتها هو من تسبب في نسيانها لكل شيء.
لقد شيدت الكاتبة روايتها هذه بسردٍ أنيق ومميز، يشي بتمكنها من حرفة السرد، وكانت خيوط الرواية، أربعة خيوط تفننت في القفز عليها برشاقة: الخيط الأول هو الذاكرة التي تمثلها الطفولة في المقام الأول، والخيط الثاني هو الأوهام، بينما الخيط الثالث هو سؤال الموت الذي حضر في النص بشكلٍ بارز وقوي، أما الخيط الرابع فهو التضاد بين الروح والجسد، إذ تتبدى لنا حسرة الجسد وغضبه من الروح التي كانت سلبية وباردة بلا مشاعر.
كشفت الكاتبة من خلال استجواب سعيدة عن الانقياد والخضوع الذي يستلبُ شخصية المرأة العربية، وذلك يظهر من خلال تعامل المحقق ونبرته الحادة في التواصل، بالإضافة إلى الدناءة التي تعاملت بها مساعدته مع الحالة، وقامت بقمعها في أكثر من مرة. فجرت الساردة في نهاية الرواية، التي دارت أحداثها في ليلةٍ واحدة! وهذا ما أبرزته الكاتبة في الصفحات الأخيرة من روايتها العجائبية، مفاجأة مدوية بعدما أفشت بالعلاقة التي جمعتها بالمحقق في التجربة السابقة، وهذا ما يستشفهُ القارئ من خلال بعض الانزلاقات التي تسللت من لسانه في شكلٍ مباغت.
تمثلُ هذه الرواية حضوراً قوياً للحس العجائبي الذي يتجلى أساساً في طبيعة المادة الحكائية التي اشتغلت عليها الكاتبة وبلورتها. هذا الحس العجائبي يُجافي الواقع، ويتنافى مع العقل والمنطق، لكنه يستفزه (العقل) ويستميل القارئ وهو مشدوهٌ، ويستلهمُ شخوصاً لا تتصفُ بالقواعد الآدمية (شخصية المحقق نموذجاً) ويختلقُ أحداثاً يستحيلُ أن يُعاينها الإنسان، كما أن هذا الصنف الروائي ينفصلُ عن الطبيعة المنهجية التي تطبع الرواية وصنوفها المتعددة، وهذه أبرز سمات الأدب العجائبي. يمكن أن يستخلص المتلقي في الأخير ملاحظتين أساسيتين: الملاحظة الأولى هي أن الكاتبة اقتصدت في بناء شخوصها في تبنٍ واضح لمقومات الرواية الحديثة، وأسرفت في استدعاء تقنية الـ»فلاش باك» في كل وقتٍ وحين، ربما لأن الرواية رحاها هي الذاكرة.
كاتب مغربي