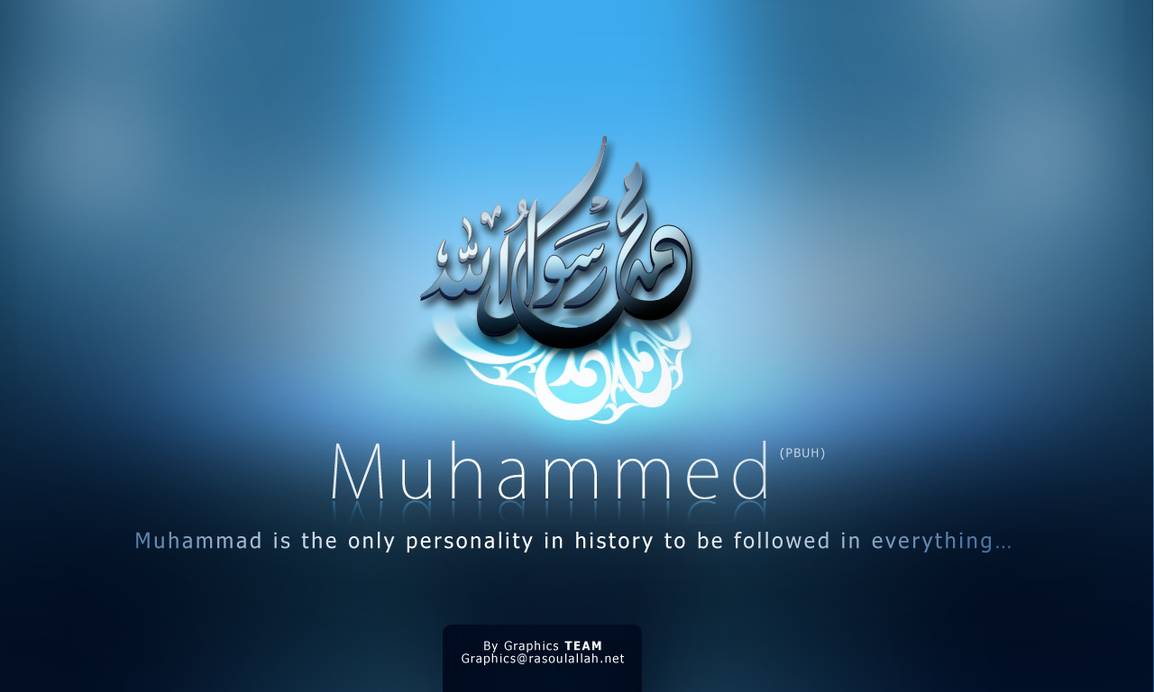الروائية التونسية عفيفة سميطي: حرية التعبير تُحرر الكاتب من فكرة أن «كل ممنوع مرغوب»
2023-02-02

حاورها: عبدالله الحيمر
تأتي كتابات الروائية التونسية عفيفة سعودي سميطي حاملة رؤية استشرافية لمجتمع ما بعد الثورة التونسي، من خلال أعمالها.. «هبني أجنحة» (2009)، «صدأ التيجان» (2011)، «غلالات بين أنامل غليظة» (2014) وأخيرا رواية «مرايا عمياء». حول تجربتها وعالمها الروائي كان هذا الحوار..
الفضاء الهامشي روائيا يصبح بقوة مركز الحراك الاجتماعي أثناء الثورة. كيف عبَرتِ كصوت نسوي روائي جسر التحرر من القبضة السياسية؟
يتصف الحراك الاجتماعي عند الثورات بالعنف والدموية والانتقام، يطفو العفن المجتمعي وتظهر الأشياء على حقيقتها، ويصبح هامش المدينة متنا، فكل ما كان متواريا يخرج إلى السطح، وتصبح اللاشرعية والفوضى مركزا ونظاما بديلا للبلاد، تتحول الرغبة العارمة في اعتراف الأفراد وكشفهم للمكبوت بما يحويه من أسرار محرجة وأفكار مرضية، إلى ردة فعل أولية تجاه السلطة القمعية، إذ يتعاظم عندهم الشعور بالعظمة والفخر عند إسقاطها حد النرجسية. ويتلذذون في جو الحرية بمتعة الانفلات من الكبت السياسي والأخلاقي والمجتمعي، ثم لا يلبث أن يتحول هذا الشعور المتضخم في أناواتهم إلى سلوك سلطوي، يصل حد الترهيب والإرهاب. ولأن كل حراك ثوري يصحبه حراك فكري، فالأمر في الكتابة يأخذ المنحى نفسه، من حيث الطفرة والتخمة فيطفو الهامش بنوع من الكتابة التسجيلية الخالية من كل الأشكال الجمالية والفنية، يُزكيها الوضع فتحظى بالانتشار والربح. كان مشروع روايتي يرتكز على إسقاط الأنظمة العربية المهترئة، خصوصا نظام تونس الذي بلغ من العمر آنذاك ثلاثة وعشرين سنة، في يقيني ككاتبة أن تغيير نمط الحكم الواحد هو السبيل الأمثل لتحرير الشعوب والمضي بها نحو التقدم مثل سائر الأمم المتطورة.
في روايتك «غِلالات بين أنامل غليظة»، طرحت العنف والإرهاب والتطرف من منظور إنساني نسوي، كيف رسخت مفهوم النسوية في أحادية المفهوم الرجالي لهذه القضية؟
إذا كان المفهوم النسوي يناضل لأجل المساواة مع الرجل، فعليه أن يدرك أن النضال سيظل منقوصا ما لم يكن مصحوبا بوعي إنساني تجاهه، رغم ما اتسم به من عنف ذكوري على مدى العصور الماضية، وحتى الحاضرة منها، وعي يدرك جيدا أن هناك ذكرا واحدا معنيا بالمحاربة الشرسة ألا وهو «الإرهاب الفكري»، هذا العدو الخطر الذي احتجز الرجل لمدى طويل على اعتبار أن الفحولة والقوة الجسدية ميزتان لا ترقى إليهما المرأة، وبالتالي سترتكز عليهما كل تنظيراته المتطرفة والمهينة لإنسانيتها، التي تسعى بالأساس لتكريس الاستغلال البشري مثلها مثل التمييز العنصري والعرقي. المتأمل للعنوان سيدرك أن الغلظة مكتسبة، فالغلالات واقعة بين أنامل أكسبها التضليل والنفخ الماكر سلوكا عنيفا، سلوكا مرضيا حتى غدت غليظة، لم أحشر في هذه الرواية الرجولة في خندق العنف، بقدر ما عدت لأصل العنف المتمثل في الفكرة الخبيثة التي تعشش في الذهن النرجسي المريض، وتتحول بعملية البث والزرع إلى دغل يسد مدخل الغاب.. عبدالله، بطل الرواية، لم يكن إرهابيا، كان طفلا حالما ككل الأطفال، حتى وقع ذات يوم هو وصديقه زيد في قبضة المنظر المتطرف، الذي كان يحمل من أدوات الخداع والاستقطاب ما لا طاقة لوعي مراهق بمقاومتها، حوله شيئا فشيئا إلى سلاح فتاك يستعمله ضد مدينته، يفجر به أمنها وسلامها .
هل يعيش الأدب النسوي في تونس، كماشة هوية عمياء، أم هو مصطلح عضوي منذ دولة الاستقلال وإلى ما بعد ثورة 2011؟
يظل مصطلح الأدب النسوي ملتبسا، إذ الحديث عن الاضطهاد والعنف وتعرية الواقع هو حديث لصالح انعتاق الإنسان بصرف النظر عن لونه وجنسه وسنه. صوت المرأة ظل يتأرجح بين التعبير عن إشكالها الذاتي مع الذكورة، وتجاوزها لهذا الإشكال بانصهارها في أتون الألم الإنساني وانضوائها تحت أهداف الأدب الكبرى، التي تعالج قضايا الإنسان المعقدة. لا ننكر أن الغرب كان المصدر الأول للوعي بقضيتها، في مرحلته الأولى عالجها الذكور، ثم في مرحلة ثانية تأنثت قضيتها عندما تشكل وعيها بضرورة التعبير بنفسها عن قضاياها، فانطلقت في مجالات ظلت حكرا على الرجال، كالإبداع والكتابة والعمل الاجتماعي والسياسي، نجحت نخبة في تخطي عقبة الجهل، وبرزت الصحافة النسوية كرافد يمد شخصية المرأة العربية بالحركة والحرية، وكجسر ينقل إليها أفكار النسوية الغربية، لم تتخل فيه عن الأوجه الإيجابية لثقافتها.
مزيج من الثقافة الوافدة والثقافة الأصيلة أظهر مدى الصلة المقترنة بين وعي الكتابة لدى المرأة، وتسخيرها لخدمة الأفكار الناهضة والتحررية، ذلك كان رافدا مهما لتغذية الأدب والنقد والإبداع النسوي، ولأنْ تأخر ذلك عند المرأة التونسية، رغم مساهمتها الفعالة في الحياة العامة وسعيها الجاد للتحرر من العزلة والعقلية الذكورية التي حبستها فيها التشريعات والقوانين المجتمعية، حيث تطلب الأمر أكثر من عشر سنوات بعد الاستقلال لتظهر أول مجموعة شعرية لزبيدة بشير سنة 1968 بعنوان «حنين»، ثم ليلى مامي في مجموعتها القصصية «صومعة تحترق»، فقد اختلف الأمر في المشرق وظهرت أسماء مثل نازك الملائكة في العراق، التي يعتقد الكثيرون أنها أول من كتب الشعر الحر سنة 1947، مي زيادة في لبنان، ثريا ملحس في سوريا، فدوى طوقان في فلسطين، ومن دون أن ننسى النشاط المكثف للمرأة المصرية في الحياة الفنية، إلا أن الملاحظ للعشرية الأخيرة من المسيرة الأدبية النسائية في تونس يلاحظ فيها طفرة تلفت الانتباه مقارنة مع المراحل السابقة، حيث ما نُشر من روايات ومجموعات قصصية ودواوين شعرية لا يضاهي أي مرحلة سابقة.
تقولين في روايتك «صدأ التيجان».. «انظر إلى هذه الأسراب إنها تْحدث شكلا في السماء رغم ضآلة أجسادها». كيف تنسجين التفاصيل الدقيقة في سرديتك؟
عندما يتحدث الكاتب عن التفاصيل فالأمر يصبح عاطفيا حميميا، فالتفاصيل هي سبيله إلى الارتقاء بالقارئ إلى مصاف الصداقة. في التفاصيل يرصد الكاتب تقنيا هذه العلاقة، وبها يُشبع فضوله ويُغريه بالبقاء والمتابعة والاستمرار في القراءة. التفاصيل هي الطعم الذي يرميه الكاتب ليعلق به القارئ، وكلما كان جيدا في استخدامها، نجح في إقناعه بأن يظل عالقا بالنص، فالغاية هي الإقناع والإبْهار. طبعا الأمر لن يتوقف عند لوحة واحدة، بل سيتواصل وستتنوع التفاصيل حتى تُصبح اللوحات مُجَمَعَةً معا بانوراما تُنْبِئُ بالصور المتتالية عن نص يزخر بالأماكن والأزمنة والأحداث، فالتفاصيل عندي هي فن الإقناع. فكرة توريث الحكم وتداول السلطة والعلاقة العمودية التي فرضها صُنَاعُ السياسة على شعوبهم اسْتعرْتُ لها صورة النحات والتمثال، وكل الأدوات الحادة الماثلة خلف المشهد، فما من نحت دون مطرقة وأزميل ومبرد، تمضي في جسد الصخر لتُشكله، والأدوات نفسها، تستعملها الأنظمة الديكتاتورية لحفر الطاعة على أجساد شعوبهم سواء بالممارسة الفعلية أو بالممارسة المعنوية.
الإبداع الإنساني عند المتطرفين مرذول، محنط، تكفيري، نحن بحاجة إلى مزيد من التفكير الواعي الثقافي كعرب لنحارب فلاحة الجهل، كيف تريْن ذلك؟
الإبداع الإنساني سمات معقدة تؤهل الفرد للإنجاز المرتفع في بعض المهارات والوظائف، والمبدع هو الفرد الذي يملك استعداداً فطرياً وتصقله البيئة الملائمة، لذا يظهر الإبداع في الغالب في مجال محدد مثل الموسيقى، الشعر، الرسم، الكتابة، كثيرا ما يواجه المبدع في المجتمعات المغلقة عداء ورفضا وعنفا يصل حد التكفير والتجريم والتصفية، لتعاطيه مع الفنون التي تحرر الجسد من سلطتها وتمنحه جرأة هي ـ في نظر المنغلقين والجهلة المتعصبين ـ انحلال أخلاقي وتمرد على التقاليد والأديان وبث للفجور والعصيان، خصوصا إذا تعلق الأمر بجسد المرأة. تركيز التوازن في هذه المجتمعات وتعليمها التصالح مع أجسادها لا يتم سوى بنهضة شاملة تنسف التقاليد البالية والتفكير الظلامي المعيق للتقدم والإبداع، ويتم الأمر بنهضة تعليمية ترفع من مستوى الوعي، تنجزها الدولة على مستوى برامجها وتشمل تركيز الثقافة وتشجيع المبدعين والفنون.. ككاتبة أؤمن بأن الكتابة تحرر الإنسان من عقده وتمنحه هذا التصالح.
كيف تقرئين الرواية التونسية بعد الثورة؟
يبدو لي أن حرية التعبير تُحرر الكاتب من فكرة أن كل ممنوع مرغوب، حيث في ظل الرقابة ظل الكاتب مركزا على تقنيات التورية، ومتفانيا في الإبداع فيها أحيانا حتى على حساب المضمون، بل غدت عند بعضهم هدفا، حالة الخوف من بطش السلطة انعكست على سلوكه الكتابي فتحول بدوره إلى سلطة تسجن أفكاره داخل دائرة التمرد السلبي، الذي يركن للاستهلاك الروتيني المبتز للقارئ التائق إلى الحرية والعدل، يحضرني مشهد دون كيشوت وهو يحارب طواحين الهواء، كان يمكن أن يتفطن إلى أن هناك طواحين أخرى تدور، لكنه لشدة هوسه بفكرته ظل يكرر حربه الممجوجة ظانا أنها الحرب الأمثل لتخليص العالم من الشرور، وعَمي عن رؤية الطواحين الأخرى التي تفوقها سرعة، الإبداع ليس كرة حديد، هو كرة مطاطية تقفز عاليا كلما ارتطمت بسطح الأرض، كوننا الإنساني يعج بالتنوع وواقع الأنظمة البائدة غدا أرضا محروقة في ظل التحولات الرهيبة التي غيرت خرائط العالم، لذلك آن الأوان لأن نرفع سقف الكتابة عاليا متخلصين من قيودنا النفسية ونرجسيتنا الأدبية القديمة، وولوج الفضاء الواسع للإبداع، الذي يتطلب الذكاء الحاد والمواكبة الحقيقية للسرعة الرهيبة التي يدور بها العالم واختلاق مضامين منفلتة من قبضة الأنا.