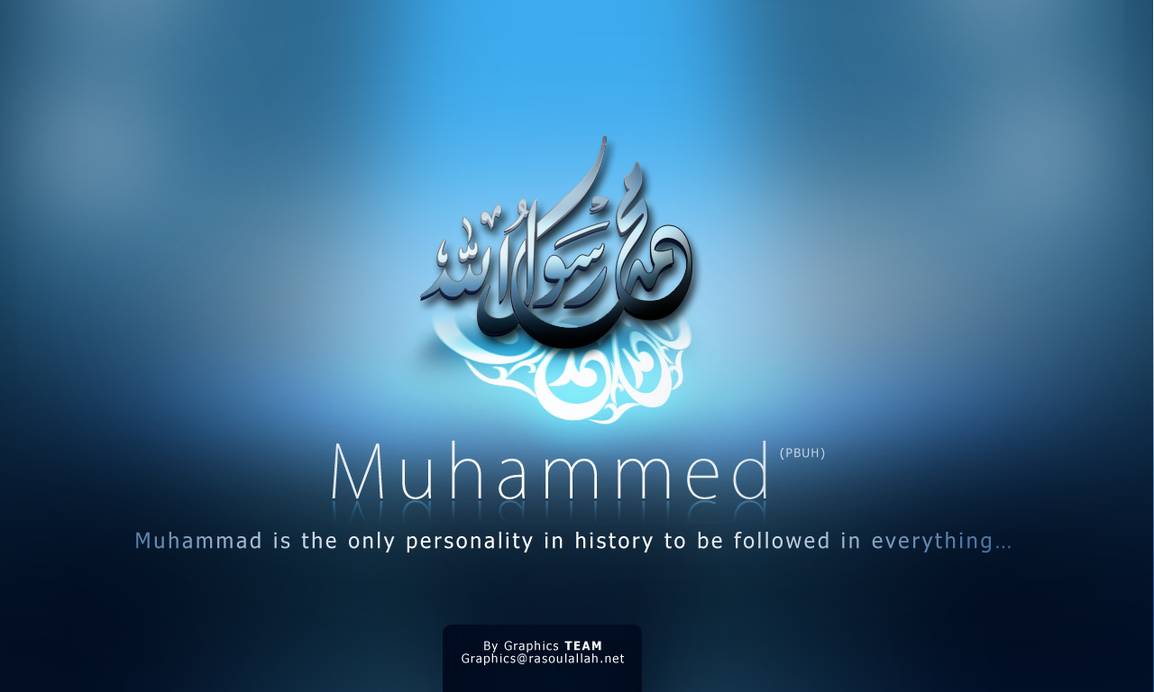كلوفيس مقصود: انحياز أمريكا لـ "إسرائيل" مستمر لأنه ليس مكلفاً:
الخليج - خدمة شبكة الأمة بر س الإخبارية
2008-08-02

الوضع العربي الواهن، الحالة الفلسطينية المخجلة، تنافس المرشحين للرئاسة الأمريكية على التغزل ب “إسرائيل” أكثر من بلادهم، والمستقبل العربي القابع تحت علامة استفهام كبرى، كلها وجبات دسمة حين نناقش حولها دبلوماسياً سابقاً، أكاديمياً راهناً ومفكراً دائماً . كانت لنا فرصة اللقاء مع المفكر كلوفيس مقصود لنرصد من خلاله مسار الحالة العربية في ظل ما يحيط بها من تفاعلات وتغيرات، بدءاً باتفاقات أوسلو “المصيدة”، كما وصفها، مروراً بصدمة مواقف أوباما في “إسرائيل”، وليس انتهاء بمصير الأمة العربية، ونحن نلقي التحية على الذكرى السادسة والخمسين لثورة 23 يوليو/تموز، ولكن البداية كانت مع السياسة الأمريكية .
قبل أيام ذهب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، باراك أوباما إلى “إسرائيل”، واعتمر القلنسوة اليهودية، وتعبّد في حائط البراق ونصب المحرقة، وهي تقريباً الطقوس ذاتها التي أداها الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش، كما أن تصريحاته لم تختلف عن تصريحات بوش، إن لم تكن أكثر غزلاً في “إسرائيل” . هل هي لعبة انتخابية أم مؤشر إلى ما ستصبح عليه سياسته؟
هناك فرضية أنه لا يستطيع أي مرشح أن يستعدي اللوبي “الإسرائيلي”، ولكن أيضا لا يستطيع أن يكون متجرداً أو موضوعياً في هذه المسألة، ويتعزز هذا الانحراف الشرس بمقدار ما يكون الوضع العربي مفككاً، بحيث لا يستطيع أي مرشح أن يحتمل تكلفة أن يكون حيادياً، أو حتى ميالاً لوجود “إسرائيل”، من دون أن يتبنى كل أهدافها المعلنة وغير المعلنة . ولذلك، فإن جزءاً من هذه السببية للتملق ل “إسرائيل” بهذا الشكل ناتج عن قوة اللوبي “الإسرائيلي”، وجزء ثان يعود للتفكك العربي وتغليب العلاقات الثنائية بين كل دولة عربية والإدارات الأمريكية المتعاقبة . وبالتالي فإن المواقف العربية المعلنة بتأييد القضية الفلسطينية تبقى غير حائزة على التصديق بالمقدار المطلوب والمرغوب . فيما يتعلق بزيارة أوباما، فإنه أثار توقعات، نتيجة لبدايات حملته الانتخابية التي شكل فيها اختراقاً للجغرافيا السياسية الأمريكية، وألهب الأجيال الجديدة بوعود مهمة أدت إلى تعبئة غير مسبوقة، بحيث إنه لم يكن هناك توقع بأن يكون إفريقي أمريكي له حظ باستثناء استقطاب العديد من الأمريكيين الأفارقة . هذا كان حال جيسي جاكسون ،1982 ولكنه لم يستطع أن يجذب أحداً خارج إطار الأمريكيين الأفارقة . تبدّلت الأوضاع وصار هناك نوع من الوعي، خصوصاً بعد غزو العراق وافتضاح الأكاذيب المتعلقة بمبررات الغزو، وما نتج من خسائر معنوية وأخلاقية وسياسية أظهرت أن ما حصل من اندفاع كان نتيجة سياسة المحافظين الجدد، الذين استولوا على صناعة القرار فيما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط، وبخاصة تبرير غزو العراق .
وعندما افتضح التشويه للحقائق والدوافع الحقيقية لهذا الغزو وحرف الأنظار عن قانونية التدخل في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول ،2001 وبالتالي عدم شرعية وعدم قانونية وعدم أخلاقية التدخل والغزو في العراق، أدى هذا إلى ردة فعل أساسية جاءت تماما عكس التأييد الذي ناله الرئيس بوش في انتخابات ،2004 والآن هناك ردة فعل أدت اليوم إلى انخفاض شعبيته واعتباره أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة . كان هذا الوضع دليلاً على أن الرأي العام الأمريكي يؤمن بأن المرشح عندما يصبح رئيساً لا يكذب على الشعب، ولا يسمح بالكذب على الشعب من جانب صانعي القرار، ولذلك نجح عام ،2004 وكان تتويجا لرئيس انتخب بدوافع كاذبة .
أوباما كان بدوره معارضاً بشدة لغزو العراق، حتى قبل انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ، وكان عضواً في مجلس ولاية ايلينوي، وبقي على هذا المنوال في مقاومة ومعارضة الغزو الأمريكي والاحتلال الأمريكي للعراق، كانت تلك نقطة الانطلاق التي دفعت بترشيح أوباما ليصبح ترشيحاً جديّا يشمل شرائح المجتمع الأمريكي، خصوصاً الأجيال الجديدة التي تجاوزت الحزبيات واعتبرته مرشحاً للتجديد الأخلاقي في الحياة الأمريكية . وكان العرب والمسلمون الأمريكيون، وما زالوا، شديدي الحماسة لهذا الترشيح، حيث اعتبروا أن هناك بوادر إيجابية من خلال أنه ضم إلى حملته مستشارين مثل زبيجنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي في عهد (الرئيس الأسبق جيمي) كارتر، وروبرت مالي مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط في عهد (الرئيس السابق بيل) كلنتون، وهما معروفان بالتجرد والموضوعية فيما يتعلق بالنزاع العربي - “الإسرائيلي” عموماً والفلسطيني - “الإسرائيلي”، خصوصاً .
وبالتالي أجيز مجال من جانب شرائح عربية وإسلامية في أمريكا، وما يمكن أن نسميها دائرة الضمير في الولايات المتحدة، للمرشح باراك أوباما أن يكون مسالماً ل “إسرائيل” ضمن الشرعية الدولية، لأنه لن ينجح إذا استعدى اللوبي “الإسرائيلي”، أو بدا وكأنه محايد تجاه “إسرائيل” . وبالتالي عندما زار الضفة الغربية و”إسرائيل” توقعت هذه الشرائح أن أوباما قد يعي حقائق كانت مغيّبة، وقد يستوعب أيضاً معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني إذا طبق المعايير ذاتها التي يطبقها في سياساته الاقتصادية والاجتماعية ومواقفه الدولية إجمالاً كما ظهرت أثناء الحملة الانتخابية .
ولكن عندما زار “إسرائيل” وبالنظر إلى ما صرح به وما لم يصرح به، أحدث صدمة للشعوب العربية وللعرب والمسلمين الأمريكيين، وذلك لأن معاييره المعلنة لم يطبقها على النزاع العربي - “الإسرائيلي” . فمثلاً يتساءل العربي وأي إنسان له ضمير: لماذا في برلين رحب أوباما بسقوط الجدار، بينما لم يشر إلى جدار الفصل العنصري المقام داخل الأراضي الفلسطينية والذي أدين في محكمة لاهاي الدولية، رغم أنه مر بجانبه؟ لماذا أصابه العمى والطرش، ولم يسمع عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والمعاناة الناتجة عن الحصار؟ ولماذا لم يسمع ما أدلى به نائب ما يسمى وزير الدفاع “الإسرائيلي” عندما هدد بمحرقة في غزة؟ لقد أعلن عن تعاطفه مع قلة من “الضحايا”، وهذا ليس مستنكراً، ولكن المستنكر التطبيق الفاقع لازدواجية المقاييس والمعايير، وبطبيعة الحال هذا لا يعني أن أوباما يُنتظر منه أن يؤيد القضية الفلسطينية، ولكن ألا ينحاز لممارسات “إسرائيل” ويعطيها رخصة من دون مساءلة، ناهيك عن أية معاقبة .
هل تتوقّع أن ينتج عن هذا تغيّر حاسم في مواقف العرب الأمريكيين منه؟
بالرغم من الصدمة التي أحدثها، فإن العرب إجمالاً، والعرب الأمريكيين خصوصاً، استمروا في تفضيل أوباما على جون ماكين، الذي إذا نجح سيكون اجتراراً لسياسة بوش مع بعض التعديلات الطفيفة، في حين أن أوباما لديه جديد في قضايا حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، والانفتاح على التطوير الاجتماعي للطبقات المهمّشة . كل ذلك أدى إلى استنتاج يقول إن العرب الأمريكيين لن يكونوا مثل “ايباك” التي تضع بنداً واحداً على برنامجها هو مصلحة “إسرائيل” وبقاؤها خارج أية مساءلة، في حين أن الصدمة حولت تأييد ترشيح أوباما من تأييده كمرشح إلى حد ما مثالي، إلى مرشح أفضل نسبياً من منافسه، فالعرب والمسلمون الأمريكيون معنيون بقضايا المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى التزامهم بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتزامهم بأن لا فلسطين من دون القدس . ومن الواضح أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانفلات في التأييد من جانب مرشحي الرئاسة والكونجرس، ليس لوجود “إسرائيل” بل لأهدافها، ولإعطائها قدرة العمل من دون فرامل لسياستها الاستيطانية والتهويدية، أنه لا تكلفة لهذه المواقف من جانب السياسات العربية، وغياب موقف عربي موحد تجاه هذه القضية، وثانياً أنه حصل اجتياز للخط الأحمر من جانب حركتي “فتح” و”حماس” بنسب متفاوتة، حيث عطّل الانشطار الجغرافي، ضفة غربية وقدس وغزة، والتشرذم الذي حصل في المواقع القيادية الفلسطينية المناعة السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، وهذا عيب كبير .
ياسر عرفات الحائز على جائزة نوبل للسلام والرئيس المنتخب للسلطة أصبح بقرار “إسرائيلي” - أمريكي حبيس المقاطعة في رام الله، ثم رأينا جميعاً ما الذي انتهى إليه مصيره “حماس” أيضاً فازت في انتخابات شفافة ونزيهة بشهادة المراقبين الدوليين وها هي تتعرض للحصار والمقاطعة، إذاً ما هي مواصفات القيادة الفلسطينية التي تحظى برضى “إسرائيل” وأمريكا؟
الإجابة عن هذا السؤال تتطلب مراجعة نقدية للعمل الفلسطيني منذ اتفاقيات أوسلو، المصيدة الخانقة للعمل الفلسطيني المناضل، حيث توهمت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأن الاعتراف “الإسرائيلي” بالمنظمة هو إنجاز سوّقته القيادة آنذاك بأنه الطريق لإقامة الدولة على 23% من الوطن الفلسطيني . هذا الوهم هو بدوره أيضاً من نتاج خروج مصر، الدولة وليس الشعب، من دورها الرادع لتمادي “إسرائيل” في استباحة حق الشعب الفلسطيني . وبالتالي توهمت هذه القيادة، وإن كان بمنطق ما، أن اتفاقات “أوسلو” هي “أهون الشرين”، وهنا كانت المصيدة، وهنا كانت الشرذمة، وهنا كان التخلي الواقعي من النظام العربي عن القضية الفلسطينية . النقص الأساسي في العملية السياسية من “أوسلو” إلى “أنابولس” أن الولايات المتحدة الراعية للاتفاقات لم تستطع، ويبدو أنها لن تستطيع، أن تنتزع من “إسرائيل” إقراراً أو اعترافاً بأنها في الأراضي المحتلة منذ يونيو/ حزيران عام 1967 سلطة محتلة، وهذا يعني أن الاحتلال لا يجوز له بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، إجراء أي تغيير في التركيبة السكانية، ولا تعديل الحالة الجغرافية للأرض المحتلة، فهي منذ “أوسلو” وقبلها وبعدها، تبني المستوطنات وتمعن في تكثيفها وتسيطر على المياه، وتنشئ الطرق الالتفافية وتمارس التمييز، وتبني الجدار داخل الأراضي المحتلة، لماذا؟ لأنها تعتبر نفسها دولة مالكة لهذه الأراضي، في حين أن السلطة تتفاوض معها على أنها دولة محتلة . هذا النقص هو ما يفسر أنه لم يكن هناك رجال قانون عندما حدثت المفاوضات السرية في “أوسلو” .
هذا الذي أدى إلى عزل الفريق المفاوض برئاسة د . حيدر عبدالشافي رحمه الله، الذي كان يفاوض على قاعدة أن “إسرائيل” محتلة . وف ي الواقع لم تكن هناك منذ “أوسلو” مفاوضات، التفاوض ينطلق من الاتفاق على نتيجة، ليس تفتيشاً عن نتيجة . إذاً لم تكن هناك مفاوضات، بل هناك مباحثات تفصيلية لا تمس الجوهر وإن كانت هناك عناوين لهذا الجوهر . المباحثات هذه هي التي حولت القضية الفلسطينية من قضية إلى مسلسل مشاكل، وإحدى المشاكل هي أن السلطة التي يفترض فيها أن تكون قيادة لمقاومة الاحتلال، تحولت إلى إدارة، وجاءت الانتخابات، وبوعي أو من دون وعي دخلت “حماس” فيها، وإلى حد ما، مع التباين والاختلاف بين السلطة و”حماس”، قامت حكومة الوحدة الوطنية . هناك انبهار بشكليات السلطة، وزارات وسفارات ووظائف كلها خالية من مضمون السيادة . حصل التباين وحصل ما يحصل من هتك لوحدة الشعب الفلسطيني، ولدور المنظمة كإطار للمقاومة وليس كإطار يفرز الانقسام، منظمة التحرير وجدت لتكون إطاراً للوحدة وللشعب في غياب الدولة، وهي تمثل ليس فقط فلسطينيي الضفة وغزة، إنما كل الشعب الفلسطيني الذي يحدد ما هو شرعي، لذلك فإن حق العودة هو جزء من شرعية أي مفاوض فلسطيني .
ي الواقع لم تكن هناك منذ “أوسلو” مفاوضات، التفاوض ينطلق من الاتفاق على نتيجة، ليس تفتيشاً عن نتيجة . إذاً لم تكن هناك مفاوضات، بل هناك مباحثات تفصيلية لا تمس الجوهر وإن كانت هناك عناوين لهذا الجوهر . المباحثات هذه هي التي حولت القضية الفلسطينية من قضية إلى مسلسل مشاكل، وإحدى المشاكل هي أن السلطة التي يفترض فيها أن تكون قيادة لمقاومة الاحتلال، تحولت إلى إدارة، وجاءت الانتخابات، وبوعي أو من دون وعي دخلت “حماس” فيها، وإلى حد ما، مع التباين والاختلاف بين السلطة و”حماس”، قامت حكومة الوحدة الوطنية . هناك انبهار بشكليات السلطة، وزارات وسفارات ووظائف كلها خالية من مضمون السيادة . حصل التباين وحصل ما يحصل من هتك لوحدة الشعب الفلسطيني، ولدور المنظمة كإطار للمقاومة وليس كإطار يفرز الانقسام، منظمة التحرير وجدت لتكون إطاراً للوحدة وللشعب في غياب الدولة، وهي تمثل ليس فقط فلسطينيي الضفة وغزة، إنما كل الشعب الفلسطيني الذي يحدد ما هو شرعي، لذلك فإن حق العودة هو جزء من شرعية أي مفاوض فلسطيني .
إذاً ما العمل الآن؟
على الأقل، كخطوة تصحيحية لا تلبي كل ما يجب أن يكون، ولكن لفرملة هذا الانقسام، ينبغي العودة إلى اتفاق مكة كحد أدنى ونقطة انطلاق لتحديد أن منظمة التحرير هي سلطة المقاومة لكل الشعب الفلسطيني، قد يكون هناك تباين في وجهات النظر، بحث عن بدائل، ولكن من منطلق التباين الذي يكون صحياً ليس الخصومات التي تتحول إلى عداء وتشرذم .
عندما اقتحم الفلسطينيون الحدود مع مصر، وكان المناضل جورج حبش يحتضر في المستشفى، قلت حبذا لو اعرف الآن إذا كان هذا المناضل الكبير شاهد في آخر ساعات حياته جماهير غزة تؤكد أن الشعب العربي مثله لا يعترف بالحدود، فإذا عرف يكون هذا بحد ذاته تعزية لنا جميعا . وإن لم يعرف، علينا أن نعوض له على الأقل باستعادة الوحدة الوطنية في فلسطين والاستمرار في العمل للوحدة العربية التي نذر جورج حياته من اجلها .
ولكن هل تعتقد أن السلطة في ظل هذه الظروف تستطيع أن تكون سلطة مقاومة؟
هي تقول إنها تقاوم بالمفاوضات، ولكن لا توجد مفاوضات، المفاوضات ليست مناقضة للمقاومة، هي إحدى الخيارات التي تشمل أيضاً التظاهرات والعصيان المدني وتعبئة الوجدان العالمي، وإذا استنفدت كلها يبقى الكفاح المسلح خياراً شرعياً، لا أن تلغي الكفاح المسلح ولا تلجأ للعصيان ولا تتفاوض بل تتباحث وتوهم الشعب بأن هناك أملاً، في حين أن الاستيطان والتهويد مستمران، وكلما جاءت كوندوليزا رايس للمنطقة يبنون مستوطنات . لذلك التحيز الأمريكي هو في حالة انفلات من دون رادع ومن دون تكلفة ومن دون إنجاز .
الفلسطينيون في صراعهم مع “إسرائيل” تركوا وحيدين، والآن في صراعهم الداخلي يتركون وحيدين، لماذا لا يفعل العرب لهم دوحة ثانية؟
أنا طلبت بالعودة إلى اتفاق مكة كحد أدنى، وأشدد على أن نقطة البداية يجب أن تكون باستعادة منظمة التحرير، لا أن تبقى هناك منظمة و”حماس”، هذا غير مقبول . يجب أن يحصل تلاقح لإنشاء قاعدة انطلاق تحفظ الإطار مع التباينات . كذلك يجب إعادة النظر في طرائق العمل . يجب أن تكون هناك قيادة مقاومة وأن المقاومة ليست انتقاماً إنما تعبير شرعي عن نقمة قائمة، والانتقام يؤدي إلى هدر مناقبيتها، صلاحيتها، ونجاعتها والفوائد المتوخاة منها . يجب أن نبدأ بضبط المصطلحات لأن الكلمة مفتاح الفكرة، وبمقدار ما تكون الكلمة مسؤولة تكون تعبيراً عن فكر واضح، وبمقدار ما يكون الوضوح تعبيراً عن تجربة أصيلة . لذلك يجب أن يدعى الآن إلى مؤتمر لكل الفعاليات الفلسطينية، لتوسيع إطار المعالجة . ولننظر لماذا استطاعت المقاومة اللبنانية أن تحقق إنجازات كبيرة . ما يجري في فلسطين
انتحار للقضية الفلسطينية، فيما “إسرائيل” تمارس المحرقة بالتقسيط .
هل ترى الأزمة اللبنانية منتهية، أم أن مشروع الشرق الأوسط الكبير لا يزال يراود الأمريكيين وحلفاءهم؟
عندما تتفكك الأمة إلى دول وأوطان متباينة ومتخلفة، عندئذ يتم التفتيت داخل الأوطان، وهذا ما نراه خصوصاً في العراق ولبنان وفلسطين والسودان والصومال، وإلى حد أقل النزاعات الطائفية والقبلية التي تنشأ وتفقدنا المناعة المطلوبة . هذا أصبح مدخلاً للقوى المتربصة بالعروبة لأن تلغي الهوية العربية من خلال تعريفنا جميعاً كشرق أوسطيين وكمتوسطيين، كذلك عندما يتم هذا التصنيف، فإن ما يجمع العروبة من قوى فاعلة تصبح عناصر مهمشة وتعتبر وجهة نظر بدلاً من حالة عامة . القومية العربية يجب أن تعيد النظر بذاتها، بأن تعتمد المواطنة أساساً وليس العرق أو الانتماء الديني أو المذهبي . من يربط مصير مستقبله فهو عربي أياً كان عرقه أو دينه . عندما نحوّل القومية العربية إلى مواطنة، تصبح اللغة العربية الحاضنة لمزيد من التداخل والاستشعار بوحدة المصير العربي بدلاً مما هي عليه اليوم، تعددية المصائر وتناقضها . هذا هو الرد الذي يجب أن يكون على المسعى لإلغاء الهوية العربية .
كذلك يجب أن يعاد بناء المجتمع من خلال ثقافة التنمية وتمكين المرأة وإنتاج المعرفة بدلاً من استيرادها وتعريف حرية الإنسان بكونها حرية للتعبير والتجمع وممارسة العقائد والطقوس الدينية وتلبية حاجات الإنسان، إذ ليس هناك حقوق للإنسان من تلبية حاجاته لذلك الأجيال الصاعدة ابتعدت عن الحالة العربية، لأنها ربطت القومية العربية بالفشل أمام المشروع الصهيوني وبأنظمة القمع والاستبداد . من هنا يجب أن يكون هناك مسعى جاد لحوار الأجيال ونقد الذات كسلاح في مقاومة هدر الذات .
نتحدث الآن عن القومية العربية، ونحن نمر بالذكرى 56 لثورة 23 يوليو، هل رحل عبدالناصر فكرا وقومية، إضافة إلى رحيله الجسدي؟
23 يوليو كانت انقلاباً نضج إلى ثورة . وعبدالناصر استقطب الجماهير وكاد أن يختزل المراحل، وأبى أن يُصنع التاريخ لمصر والعرب وأراد أن يصنع العرب تاريخهم . لم ينجح ولم يفشل، وكاد أن ينجح . هذا الدور التاريخي للرئيس الراحل عبدالناصر، يجب أن يُقيم بموضوعية حتى نستفيد من إيجابية العطاء ونتجنب سلبية الاستئثار . لأن مصر في عهد عبدالناصر كانت ساحة التلاقح بين التجارب الوطنية لدول المشرق المتسمة بالعلمانية، وتجارب الحركات الوطنية في المغرب الكبير التي كان جزء مهم من انطلاقها التأكيد على إسلامية المنطقة من خلال معارضة الاستعمار . هذا التلاقح جعل العلمانية العربية متميزة عن العلمانية الأوروبية والغربية، كانت إقرارا بأن العلمانية ليست فصل الدين عن الدولة، كون الدين جزءاً من تركيبة المواطن، يمارسها بنسب متفاوتة ولكنه لا يتخلى عنها، فالدين مكون رئيسي للمواطنة . إذاً ما العلمانية العربية في المفهوم القومي؟ هي فصل الدولة عن المرجعية السياسية للمؤسسات الدينية . العلمانية ليست مناقضة للإسلام بالمعنى العميق للكلمة .
نعود ونقول إن دور مصر مهم جداً، على الأقل في أن تكون قوة رادعة للتمادي العنصري الإجرامي ل “إسرائيل”، خصوصاً في فلسطين، أما ما نراه فإنها أقامت التطبيع والعلاقات الدبلوماسية، ولم تقطعها عندما كانت “إسرائيل” ترتكب المجازر في فلسطين وقانا . حزب الله تمكن أن يخرج كل الأسرى اللبنانيين واسترجاع الشهداء، وهو حزب صغير فما بالك بدولة . يجب أن نصارح الأنظمة، لا نعاديها، لكنها تعادي المخاض الشعبي وتحول دون تبلوره إلى حالة واقعية . وهذا هو التحدي اليوم .