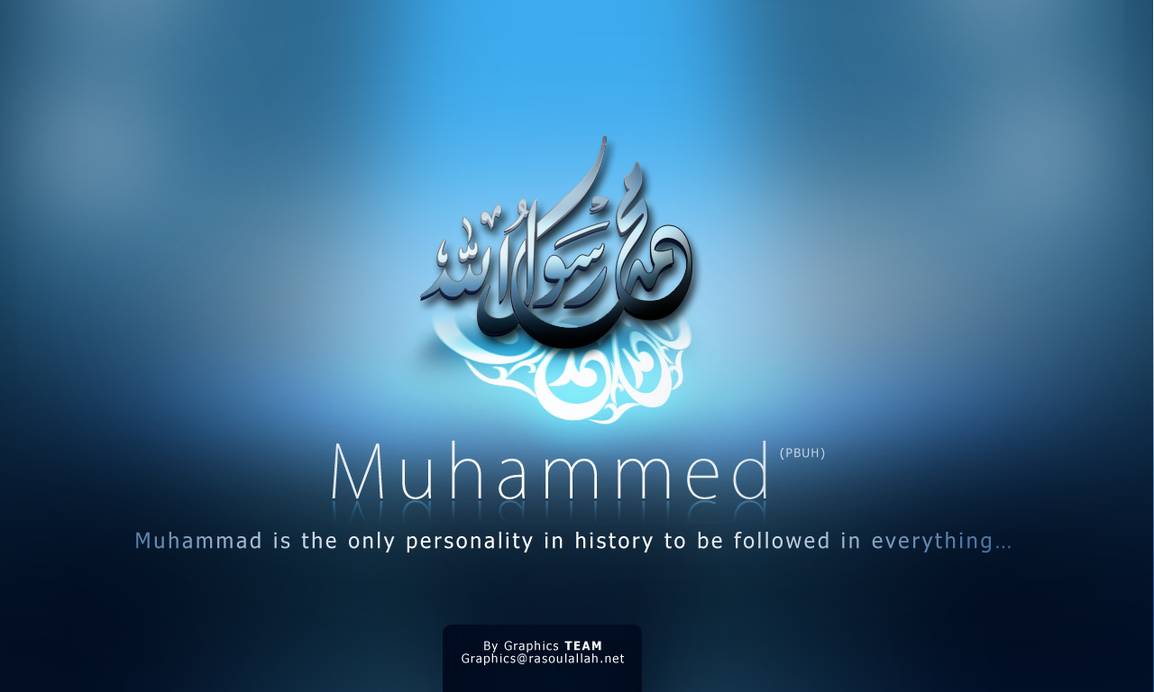الشاعر الأردني غسّان تهتموني: لا نستطيع أن نُحمّل الشعراء وزْرَ تغيير العالم
متابعات - الأمة برس
2023-04-04

حاوره: نضال القاسم
غسّان تهتموني شاعر أردني من مواليد مدينة إربد في شمال الأردن عام 1966، وهو من شعراء الحداثة البارزين في الأردن، فقد قطع شوطاً هائلاً في مساره الشعري، وأعطى أنموذجاً فنياً في وعي الشاعر بتجربته والحرص على تطويرها. صدرت مجموعته الشعرية الأولى «عصفور ليديك عشب في جرارك» عام 1999، ثم صدر له ديوان «خارج أسفار اللوم» تلاه بعد ذلك ديوان «ما كنت نسيا». يُذكر أن تهتموني عضو في رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب العرب، وقد شارك في العديد من المهرجانات الشعرية. عن الرجل وتجربته دار الحوار..
ماذا عن بداياتك والمؤثرات التي شكَّلت وعيك وأسهمت في تكوين تجربتك الإبداعية؟
البداية دفترٌ صغيرٌ ضاع أو قُل ضلَّ طريقه بين جملةٍ من الكتب، كأي طفلٍ كان يلمُّ شتاته غير عابئٍ بالفتحة وهي تطلُّ من صفحةِ الأعراب وغير مدركٍ للضَّمةِ فوق لام القتل. كنتُ في عالمٍ طفلٍ لم يعرف الإلغاء والحذف والمصادرة، كان يعلم أنه تورط بما يكفي، وأصبح من العسير عليه أن يعود أدراجه قصصاً، ولم يعد أمامه غير مفردته في بث أشجانه، كأن يتمثل المطر الساقط في صحن البيت، كأن ينزع من خدِّه فتيل دموعهِ، كأن يجد سبباً بسيطاً لتلك الفتاةِ التي مهرت قميصه على عجل. بين تورطه في الحرف وحتفه في الحبِّ، كان صوت الأم القريب/البعيد يشدني كالقوس أمام مديحها النبويِّ: «يا ذا المكِّي ْ.. يا ذا المكيِّ، حبُّ محمد عزيزُ عَلَيْ».
وما هو التصور الشعري الذي تم على أساسه ديوانك الأول؟
قد لا نجانب الصواب إن تحدثنا عن تصور واحد لمُجمل العمل الأول «عصفور ليديكَ، عُشب في جرارك»، وإن كان الإحساس بالفقر هو السمة اللافتة التي صُبغت بها قصائد المجموعة، والتي حاكت بدورها بضعاً من الأعوام التي حزنت فيها كثيراً، وضحكت فيها قليلاً. إذن ثمة انكسار آسر يشبهني ويشبه تلك النهاية القلقة للجملة الشعرية.. إنني أشبهني في كلِّ ما كتبتُ، إنني «أكْتُبني». هناك أنايَ الفرحة بالتعب، المنذورة لبسالة الطيف وشعاع الدمع الصاعد من زاوية الفم، أصعَدُ بـ»الضمائرِ» إلى كلِّ ما هو جميل في الكائنات، وفي الآن ذاته أسعى إلى ما يشبهُ التحريض ليسَ بمعناه السياسي المحض، وإنما بمعناه الإنساني الشامل الضارب في العمق، محاولاً تجاوز اللفظ إلى ما وراءه من دلالة. وأكثر ما يؤرقني هو محاولة البعض البحث عن معادل موضوعي للصورة أو الجملة الشعرية، صحيح أن الصورة قابلة للتخيل، ولكنها أيضاً عصية على التموضع والفهم القامع للحس. هكذا أرى القصيدة كائناً مكتمل الحواسْ، وإلا كيف يكون ذئبَ الفرزدق غير ذاك الذئبَ الذي تحدَّثَ عنه المعلِّمُ ونحنُ على مقاعد الدرس. عشرات النصوص مرَّت أمامنا في الصفِّ، لم يَعُدْ منها في الذاكرة سوى الحديث عن الأغراض ومعاني المفردات.
وما الذي تريده من الكتابة والشعر؟ وكيف يمكن أن يصل الشعر إلى أكبر عدد من القراء؟
كلَّ ما كتبنا وكلَّ ما سوف نُلوِّحُ به من كتابة، هي محاولةً منا لأن نكون «خارج أسفار اللوم»، كلٌّ منا مشروع شاعر إن طوَّر أدوات لغته الشعرية وبدأ في تشكيل مفرداته الخاصة به، وفق رؤيته لمختلف تفاصيل الحياة من موت وحبّ ووجود وكائنات. لكن هل من نافل القول إن تحدثنا عن الشعر بصفته مماثلاً ونظيراً للحياة ذاتها؟ هل حقَّاً أن الشعر يقابلُ الحياة في طقوسه، في أحلام الفرد وتوسلاته؟ هل نريد من الشعر أن نصبح أكثر غموضاً وأكثر لُبساً، أن نُصبحَ أكثَرَ رقَّةً أي أكثر قسوة من الحاضر الذي نعيش وهل الشعر امتدادنا بعد رحيلنا القسريِّ عن الأرض؟ الإجابة بنعم تعني أن الشعر قد أصبح قضية وجود وحضور، بالإضافة إلى كونه حالة من القلق والهاجس. أما عن الشقِّ الثاني من السؤال.. أستطيعُ أن أخبرك وبعد تجربة قد تكون متواضعة، أن هناك قراء أصحاب تجربة طويلة في القراءة، أي يمتلكون وعياً صافياً وعالياً في التعامل مع النصوص، وهؤلاء لا شك مبدعون، لأنهم يشكلون مادة الجمهور الشعري الحقيقي الذي من دونه لا تستقيم عناصر العملية الأدبية الأخرى، لأن الشعر مستوى عالٍ من مستويات اللغة. كما أننا أحوج ما نكون إلى إعادة إحياء اللغة، ليس كونها أداة اتصال بين مختلف متحدثيها، بل لأنها للروح بمثابة الشرايين والأوردة للجسد. والآن ونحن في الألفية الثالثة نُشاهد بأم العين تراجع الدور الحيوي الذي شغلته اللغة، حيث باتت وسائل الاتصال الحديثة لغات بديلة شئنا أم أبينا.
وسطَّ كل هذا كيف تبحث عن قاعدة عريضة لجمهور الأدب وسائر الفنون، وبعد أن حسم الكثير من الناس أمرهم: «الشعر الحديث غير قابل للفهم»، وإن سألته عن القديم (المتنبي مثلاً) كونه شغلَ العالم طولاً وعرضاً، يحدثك بعض الوقت عن قصيدةٍ أو قصيدتين فينتهي الأمر عند هذا الحد. السؤال الذي سيبقى ماثلاً.. هل الأدب برمته مادة للاهتمام المُلِّحِ؟ وكيف ينظر المجموع إلى الشعر؟ هل هو خاصٌ من حيث كونه شعراً وفنَّاً، أم بصفته لسان حال المجموع وما يمثلهُ من آمال وطموح وحرية؟ وأخيراً كم من الوقت نحتاج حتى نرى ذواتنا عبر ذات الشاعر ومرآته، وأن لا نحمّل الشاعر وزْرَ تغيير العالم، لأن ذلك بلا شك فوق قدرته ومشيئته، هذا لا يعني حيادية الشعر عن الأحداث والقضايا الكبرى، فالشاعر هنا يستصرخك بأن تلك الكوة المفتوحة في الجدار قابلة للاتساع، حتى نصبح جميعاً بلا جدار والشاعر أيضاً يناديك: إن هناك من يحمل جسده فوق حريته، وإنه في انتظارنا حتى نصل إلى نهاية الطريق.
كيف ترى الواقع النقدي، وماذا عن العلاقة بين النقد والإبداع؟
النقدُ ليسَ أحسن حالاً، من أطراف العملية الشعرية الأخرى، لا لأنه غير معنيّ بالتجارب الشعرية الشابة، بل لعدم وضوح الرؤيا والرؤية النقدية بصفتها منهجاً موحداً واضح المعالم. نحنُ نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى نقد يتجاوز التوثيق والأغراض، إلى نقد تشعُّ منه القصيدة من العمق، نحنُ نريد نصّاً إبداعياً آخر، يحاكي النصَّ لغةً وفلسفةً وتراثاً، فعلى الناقد أن يمتلك إحساساً عالياً بالمفردة والجملة الشعرية، وأن يكون لديه حظَّ من الفلسفة وفهم فطري لها، وأن يمتلك إحاطة غير مسبوقة بالتاريخ والتراث الإنساني، فالنقدُ فعلٌ حيويٌ بالغ الأهمية والضرورة. فالناقد مبدعٌ استثنائي، لذا علينا وقد تحققت له تلك المواهب والقدرات السالفة الذكر، الإصغاء له غير متوسمين إطراءً كاملاً غير منقوص، بل الواجبُ يدفعنا إلى امتنانه وشكره على ما أنجزَ وأجادَ وإن أخطأ فله سبقُ المحاولة، وردُّنا عليه يجب أن يأتي ضمن منظومةٍ من الأسس والقواعد والمتن الأدبية المتعارف عليه، أو تلك التي اتفق عليها الأدباء وأصحاب الاجتهاد، لأن الردّ الذي لا يَحمِلُ أسساً أدبية واضحة ويتكئ على العلاقة وردود الأفعال يهبط بالأدب والشعر خصوصاً إلى مستوى لا يُحمدُ عقباه، ونصبح سواءً بسواء أمام القراء وسائر المتابعين. فالنقد الحلقة الأهم والنقطة المركز أيضاً للحفاظ على ديمومة ونشاط الحركة الأدبية والثقافية.
ما مدى تأثير التراث في اتجاهاته المختلفة في تجربتك؟
يُشكِّلُّ التراثُ لي بمختلف أطيافه الثقافية البوصلة الأثيرة والمساحة الأكثر شمولاً في التعامل مع الذات ومع الآخر، فالتراثُ كمادة دائمة الحياة لا تخصّ الأديب وحدهُ، بل تعني الجميع بمختلف آمالهم وطموحاتهم. إنه نَحْنُ جميعاً، مثقفون وحرفيون من شتى المهن، إنه ببساطة عمرنا الكوني ِّعلى هذه الأرضِ الذي لا يقبلُ الإلغاء والتحلل والضمور. وهذا لا يعني البتَّةَ القَفْزَ عما أنْجزَهُ الآخرون، ولكن ليسَ قبل الإحاطة بالتراث، تراثنا الضارب في العراقةِ والقدم، والذي شهِدَ له البعيد قبل القريب. نحن في أَمسِّ الحاجةِ إلى بناءِ مثقفٍ عضويٍّ شامل كي ينهض ببصيرته الثاقبة ويجلو الحقيقة التي طال غيابها وإعادة الاعتبار إلى التراث ليس بصفته فنَّا خالصاً محضاً، بل لأنه أيضاً مصدرٌ رفيعٌ للخلق والسلوك.
وما مدى توظيف الأسطورة والرمز في شعركم؟
منذُ مطلع التاريخ والإنسان يبحث عن علل كثير من الظواهر التي تحدثُ حولهُ، كأن يلجأ إلى التخيل تارةً وتارةً يعكف على إيجاد وسيلة للتعايش مع سائر المفردات، راغباً تحقيق حالةً من التوازن والانسجام ما أمكن ذلك، ثم جاءت الأسطورة وارتباطها بالموت والخلود لتشكل هاجساً ماثلاً ومعيناً للقلق والبحث عن شكلٍ آخرٍ من الامتداد الإنساني الذي نسعى إليه في مختلف مسمياته. وفي الربع الأول من القرن الماضي بدأ الشعراء العرب باستخدام الرمز والأسطورة تأثراً بالمدارس الغربية الحديثة قبل تلك الحقبة، فكان الاتكاء على الرمز عارماً يصل إلى درجة الهوس والافتتان، إذن جاءت الكتابة بشرطها وفعلها الإنساني لتشكل حافزاً نوعياً للتشكيل الأمثل بعد الحياة، فالرمز كائن علينا تحريكه من زمن إلى آخر وفق مشيئة الراهن الملِّح لا لتأريخه وإعادة إنتاجه في حضوره السابق، من هنا أحاولُ جاهداً أن أمسك بهذا الخيط البالغ الدقَّة والرهافة، وهذا يحتاجُ قطعاً إلى تجربةٍ طويلةٍ وشاقةٍ، أي إلى مراسٍ حقيقيٍّ في القراءة والكتابة.
هل كان لأدبك أثر أدبك خارج الحدود؟
يؤسفني القول: إنه ليس من أثر يُذكرُ، إلا إذا اعتبرت ما نُشر لي من قصائد على صفحات بعض المجلات والملاحق الثقافية العربية، أدباً تجاوز حدود الوطن، أضِفْ إلى ذلك عددا من القصائد هنا وهناك. وليس من سبب واحدٍ خلف هذه الغربة المحدقةِ بنا من الماء إلى الماء، فهناك محررون يستقبلون فقط الشعر الملتزم بالعمود الخليلي، وهناك من يعنيه شعر ما بعد الحداثة، «أُنظُرْ» فنحنُ قد تجاوزنا ما يسمى (الحداثة) وعلينا أن نتهيأ لما بعدها! والبعضُ يعنيه مستوى معينا من اللغة، واستخدام أدوات الكتابة المنوطة بها. فكيف نتجاوز حدود الوطن ونحنُ لم نتجاوز بَعْدْ دائرة الأصدقاء والمريدين، كيف نتجاوز ذواتنا، وأنت دائم الحاجة إلى من يسبغ عليك حلة الرضا والقبول لدى المحرر هذا أو ذاك، أنت دائم الحاجة إلى التزكية المختلفة الأوجه والمحطات، وقد تصل يدك إلى قلبك النابض أبداً إن تفوهت بكلمةٍ أو عقَّبْتَ بأدبٍ جَمْ وسط أعْيُنٍ تغصُّ! ورغم ذلك.. إن ما تبقى من العمر يجعلني أكثر تحفزاً للكتابة، والإمساك بمشهدي الخاص.