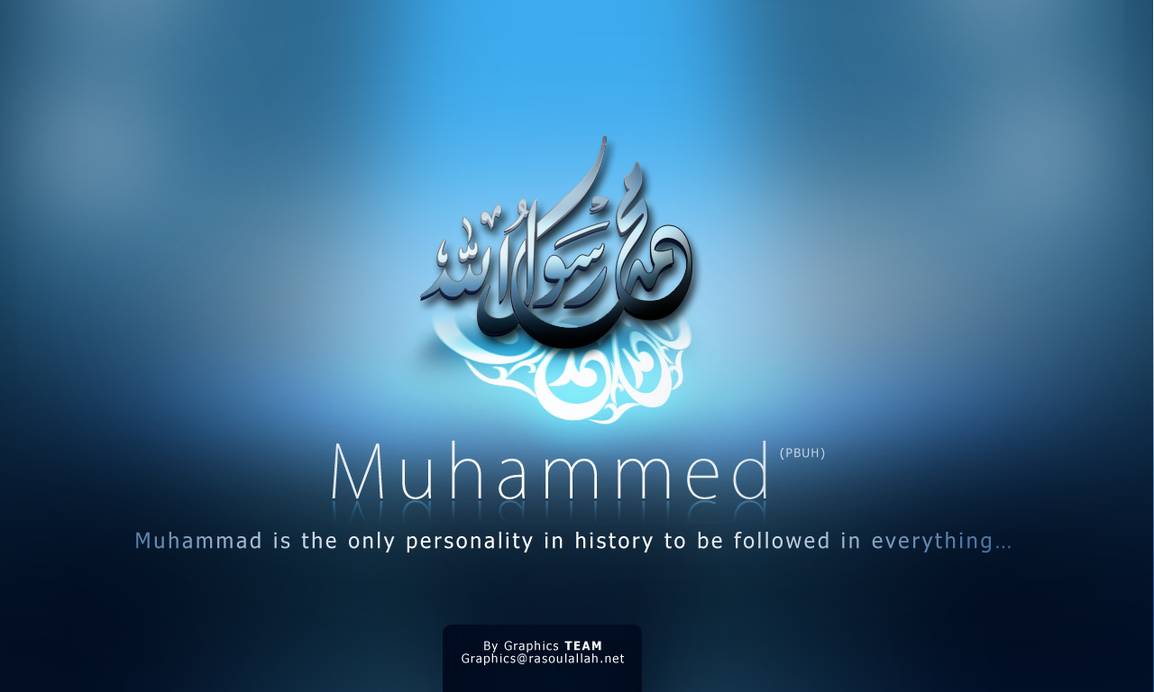الباحث التونسي محمد عزيزة: الفن المفاهيمي رعب مقدس… والشعر مهمة صعبة
متابعات - الأمة برس
2023-04-13

حوار: عبد العزيز جدير
محمد عزيزة باحث في علم الاجتماع وكاتب تونسي. تناولت مؤلفاته موضوعات شائكة، أملاً في تصحيح المفاهيم والآراء الشائعة، ومنها.. «المسرح والإسلام» «الصورة والإسلام: الصورة في المجتمعات العربية في الوقت الحاضر» كما كتب في النقد الفني، «فن الخط العربي». وحين يرغب في كتابة الإبداع يتقمص شخصية أخرى اختار لها هوية ثانية باسم مستعار هو (شمس ندير) ففي السرد أصدر «البحر والأسترلاب» و»أروقة البحر» وفي الشعر «صمت الإشارات» و»التنور». عن رؤية الرجل وهذه المساحات المختلفة من الكتابة، كان الحوار التالي..
بداية كيف أتيت إلى عالم الكتابة؟
كل كاتب، مثل نهج أي كائن حي، يحكمه البُعد الفطري والمكتسب. ويجب أن يكون الفطري يميل إلى الكتابة والإبداع بمختلف ألوانه. ويمثل المكتسب ظروف الحياة بالطبع. على أي حال، فالمبدع، بشكل عام، بعيدا عن الكتابة، هو شخص لديه استعداد خاص لمعالجة المعلومات التي يتلقاها. أعتقد أن كل الأشخاص يتلقون المعلومات ذاتها، في بيئة معينة، وفي مكان معين، لكن المبدع يعيد ترتيب هذه المعلومات، في شكل مبتكر تماما وغير عادي وغير مسبوق، وأن الإبداع في الأساس هو هذا النوع من معالجة الهامشي بشكل أكبر، بعيدا نسبيا عن نطاق قاعدة أو معيار المعلومات التي تتلقاها. اعتدت أن أقول إن الإبداع بالنسبة لي مثل المرض المبارك، أو بالأحرى خلل وظيفي مبارك. ويبدو لي أن هذه العملية هي التي تميز النهج الإبداعي، سواء كان إبداعا يجسد نفسه في الكتابة، أو الرسم أو الموسيقى، أي أن المبدع يعيد ترتيب المعلومات التي يتلقاها، مثل كل أولئك الذين يعيشون معه، بطريقة مختلة نوعا ما، بحيث يُظهر ما هو غير مرئي للوهلة الأولى، لذلك، فإن هذا الخلل الوظيفي هو الذي يبرز الفاصل بين الطريقة العادية لتلقي الأشياء والطريقة المبتكرة في رؤيتها.
ولماذا تكتب إذن؟
أكتب لأني أشعر بالحاجة إلى ذلك أولاً، حاجة داخلية أشعر بها وتجعلني أكتب، ويحرضني أيضا أمل سري للتواصل، ليس عبر الأفكار عندما أكتب باسمي الأدبي المستعار «شمس ندير» بل عبر المشاعر والعواطف بالأساس. ربما أكتب لهذه الأسباب. وهذا يعني، محاولة التواصل مع قارئ محتمل لم أكن أعرفه في البداية، ولم أسع إلى إغوائه أو أوقعه في الشرك من قبل، لكن القارئ المحتمل الذي سيضعه حسن الحظ في طريقي، والذي سيقرأني، وسيتواصل معي في حقل الانفعالات والعاطفة.
هل قادتك قراءاتك إلى ملاحظة بعض الاختلاف بين الكاتب الأوروبي والأمريكي وما يسمى كاتب العالم الثالث؟
لا أعتقد ذلك، بل على العكس، يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن يحاصرنا هذا النوع من الحجة أو البرهنة، لذلك حرصت دوما، عندما أقدم نفسي، على سبيل المثال، بمناسبة نشر كتابي، أن أقول دائما إنني مواطن تونسي، مواطن مغاربي، لكنني كاتب، لذلك إذا كنت قبلت المقارنة مع غيري من حيث الإبداع، فذلك أمر جيد، وإذا لم يكن لي وزن ولا قيمة، فذلك أمر سيئ للغاية، لكن، لا أريد أن ينظر إليّ على أنني أنتمي إلى فئة خاصة، محاصرة في حظيرة معينة مثل الهنود الحمر في أمريكا، وأبدو وكأنني كائن غريب، ينظر إليه علماء الحشرات، الذين يعتبرون «عاديين». أعتقد أنه يجب علينا المطالبة بالعالمية والانتماء إليها، وبعد كل شيء، فإن كتابا مثل غابرييل ماركيز، وبابلو نيرودا، وأوكتافيو باز، وجورج أمادو، وأنخيل أستورياس، أصدقائي في أمريكا اللاتينية، وكذلك بيير سيغيرس، وسنغور قد كتبوا مقدمات لنصوصي التي ترجمت، وأعني أني أشعر بأني الأقرب منهم من حيث الكتابات التخييلية، فلا أعتقد أنه يتعين علينا قبول أن نبقى حبيسي خصوصية سخيفة. يكتب الناس، وكتبوا دائما لأن هناك ضرورة، مهما كانت الظروف المحيطة بهم. بالطبع، ستؤثر هذه الظروف المحيطة بهم في أعمالهم. ومن الواضح أن كاتبا من أمريكا اللاتينية، أو كاتبا أفريقيا، أو كاتبا من المغرب الكبير لن يكتب الشيء نفسه مثل كاتب من السويد أو كاتب من بولندا. بالطبع، تختلف البيئات، وينتح عنها وجود خصوصيات، وتنويعات لحسن الحظ، لكن فعل الكتابة والهدف من الكتابة هو نفسه دائما.
وبالمناسبة.. تعاني أعمالي دائما من مشكلة قبولها في أوروبا، لأن القراء في أوروبا، على وجه الخصوص القراء الفرنسيين وربما القراء الإنكليز، لديهم توقع مسبق لما يمكن أن يكون عليه عمل شخص قادم من الجنوب. يجب أن تفوح من العمل رائحة البهارات، واللون المحلي، نخيل محمل بالتمر أو غير متمر، وشخصية تدعى فاطمة راقصة. لكن في أعمالي «أسطرلاب البحر» أو بشكل أقوى أكبر «أروقة البحر» تجنبت هذه الأمور بقوة. على سبيل المثال، مواضيع قصصي كونية. ومرة أخرى، أنا لا أكتب القصة القصيرة، على عكس ما يقولون، أنا حكواتي على طريقة شهرزاد وأسلوبها. لطالما اعتدت أن أقول إنني ابن مفترض لهذه السيدة العظيمة التي فجرت الخيال تفجيرا.
وهل الجامعة هي التي وجهت خطواتك نحو البحث العلمي، أقصد علم الاجتماع؟
جئت إلى هذا البحث من أبواب المحظور وهو الفضول. طرحت على نفسي هذا السؤال، قبل أن أنجز رسالتي عن «المسرح والإسلام» السؤال البسيط والواضح، لماذا الثقافة العربية الإسلامية التي تعاملت مع جميع الأجناس، بما في ذلك ما قبل التخييلية، كما جاء في حي بن يقظان على سبيل المثال، لماذا هذه الثقافة التي تعاملت مع جميع الأجناس الأدبية، لم تنتج عملاً مسرحيا مهما قبل عام 1848، وذلك عبر الاقتباس عن طريق التقليد، كانت المسرحية الأولى، وفق التقاليد أو الأشكال الكلاسيكية، التي تم تقديمها باللغة العربية هي «البخيل» لموليير، اقتبسها مارون النقاش عام 1848 في بيروت. وبصرف النظر عن ذلك، لا يوجد سوى إنتاج مسرحي واحد، أو ما قبل مسرحي مهم، وهو التعازي الشيعية، حيث يتم خلال أيام محرم، في عاشوراء مسرحة جماعية في ساحات المدن الشيعية لإعادة تشخيص مأساة كربلاء. وإذن، لماذا لم يكن هناك إلا ذلك فقط، بصرف النظر، بالطبع، عن تقليد خيال الظل، وبعد ذلك، وبشكل مؤخر جدا، مسرح العرائس المقتبس من صقلية (مضيق قِلِيبِيَة) في تونس. تساءلت، لم لا يزال هذا الأمر لغزا أدبيا. وشرعت في هذه الدراسة على وجه التحديد لأنني حاولت معرفة الإجابات التي قدمها أولئك الذين طرحوا هذا السؤال على أنفسهم. وقد انكب كثير من المفكرين من غير العرب أيضا على هذا اللغز، ولم تقنعني الإجابات على الإطلاق، مثل إجابات أحمد أمين، ولويس جارديل، وهي إجابات سخيفة تماما. إذا اعتقدنا أن المسرح لا يمكن أن يوجد في (بلاد) الإسلام لأن المرأة لا تستطيع المشاركة في التمثيل، فإننا ننسى أن جميع المسارح اليونانية تم تقديم العروض فيها دون نساء. وإذا اعتقدنا أن العرب، كما يقول أحمد أمين، كانوا بدوا وليست لهم مدن، فإننا ننسى أن دمشق وبغداد وقرطبة كانت عواصم ذلك الوقت (وهو الترتيب ذاته الذي توجد عليه مدن باريس ولندن ونيويورك). من السخف أن نقول مثل هذه الرأي الذي يمثل صورا نمطية وكليشيهات لا تصمد أمام حقائق التاريخ، لذلك، بدأت العمل، مثل محقق، يتتبع خيوط جريمة قائمة على لغز بوليسي، وبادرت بالبحث عن سبب هذه المشكلة.. لماذا لم تنتج الحضارة الإسلامية المسرح؟
وهل التشخيص حقا حجة أم تفسير جدي؟
إنه تفسير أكثر جدية، لكنه خاطئ تماما. هذا يعني أن تحريم التمثيل سببه (التشخيص). وإذا ما عدنا إلى ما قال به حقا الفقهاء وكل ما كُتب في الموضوع، نلاحظ أنه حظر ومنع معقد تماما. وقد يعني ذلك القول: لا يوجد تمثيل، وهو ممنوع. لا، ذلك أمر غير صحيح. هناك الكثير من الفقهاء قالوا إنه يمكن للمرء أن يمثل، لكن يجب أن نحرص كل الحرص على عدم القيام بتمثيل أو تشخيص الأبعاد، حتى لا نتعرض لخطر الوقوع في (العودة إلى) صنع التماثيل. وبالتالي، السقوط في عبادة الأوثان كما كان الناس في مكة يكرمون اللات، والعزى، ومناة. لكن القول بأن المنع أيا كان نوعه في حضارة، سواء كانت دينيا أو فقهيا أو شرعيا يمكن أن ينهي فجأة فنا مستلهما ممن سبقونا؛ وذلك هو سبب هذا الحظر، فهو غير مقبول بشكل مطلق. والدليل أن ما يسمى تحريم التشخيص لم يمنع ممارسة الرسم التشكيلي الهائل، مثل المنمنمات الفارسية الإسلامية، أو الساسانية أو المنمنمات الأخرى (التركية مثلا) من الوجود، وما منع الأعمال العربية، مثل لوحات الواسطي. لذلك، من السخف قبول هذا التفسير، فالحظر لم يجفف منابع الرغبة في التعبير عن هذا الشيء، والحاجة إليها، بل وأكثر من ذلك، فإن حظر الخمر لم يمنع عمر الخيام، أو أبو نواس، أو غيرهما. وأنا لا أكتفي بتفسير وظيفي مثل هذا الذي قُدّم. فالنبيذ ممنوع، بشكل واضح إلى حد ما، لكن الحضارة العربية الإسلامية أنتجت أجمل القصائد التي تتغنى بالنبيذ. أجمل من شعر باخوس. إذن ماذا يعني كل هذا؟ يعني أن النهي أيا كانت طبيعته لا يمنع التعبير عن الشيء المحظور.
كيف حدث هذا الانتقال من هاجس البحث الاجتماعي إلى آخر يعنى بالتخييل؟
من الواضح أن التخييل ضرورة أو حاجة مطلقة. وعلى وجه التحديد، أنا شخص مزدوج. يوجد أو يتساكن في داخلي الأكاديمي الذي ينتج أعمالا تحليلية مثل «المسرح والإسلام» و»الصورة والإسلام».. ثم هناك البعد الآخر وهو كتابة الرواية. ولهذا فضلت الفصل بين الشخصين، البعدين على مستوى التسمية ذاتها. أوقع دائما الإنتاج الجامعي باسم (محمد عزيزة). وأوقع، باسم (شمس ندير) الإنتاج الروائي. وقد تسببت لي تسمية شمس ندير في بعض الجدل السخيف أو العبثي، لأن الناس اتهموني بالشعور بالفخر والزهو، لقد اعتقدوا أن ندير تأتي من نادر (الوجود). وقالوا لأنفسهم إن هذا الرجل يعتبر نفسه شمسا، بل أكثر من ذلك يعتبر نفسه شمسا نادرة. لكن الأمر ليس ما اعتقدوه. النادر مقياس فلكي يعني عكس الكبد. إذن فالأمر يتعلق بشمس ليست في كبد السماء، لكنها في الحضيض منها. إنها تعني عكس ما تعنيه الذروة. وقد دخلت كلمة ندير إلى اللغة الفرنسية، وتعني الشمس في الكسوف.. لذا فهي شمس سوداء، شيء مما ورد في تقليد نيرفال.
ولماذا اخترت هذا الاسم المستعار؟
شمس تعني الشمس المشعة، الملك الشمس. كانت التفاتة وتحية غير واضحة المعالم للغاية، للمعلم جلال الدين الرومي، الذي كان يُدعى شمس تبريز. وكانت ندير التفاتة نحو جيرار دو نيرفال، وكان ذلك نوعا من التشبيه المجازي الخفي بعض الشيء. وذلك لأنني كنت أريد الاختباء؛ إنها شمس سوداء، شمس في الكسوف، شمس يتعذر تبين وجودها.
كتابة الشعر والرواية، هل تشعر بأن هناك اختلافا؟
حقيقة، لا وجود لاختلاف يذكر. لكني ألاحظ، للأسف، أن كتابة الشعر مهمة صعبة. وعلى العكس من ذلك، وخلافا للاعتقاد الشائع، لا تتجاوز صفحات الديوان الشعري المئة أبدا. ولذلك يقال إنه سهل، وهو قول ليس صحيحا على الإطلاق.
فالشعر هو جوهر التعبير والشعور. وإذن فإذا كان هناك اختلاف، بين الجنسين الأدبيين، فهو يكمن في صعوبة الشعر. مع ذلك، ليس كل شيء هو شعر. نكتب كلمة شعر على الغلاف بمعنى أن ما يوجد بين دفتي الكتاب شعر. والآن، هناك نزوع رهيب، خاصة في الغرب، نحو ما يسمى بالفن المفاهيمي (يغلب الفكرة على التصوير الواقعي) وهو فن سهل للغاية نراه في الرسم، حيث نرسم أي شيء ونقول: آه، نعم، هذا عمل مبتكر. نرسم كرسيا مقلوبا. مصفاة. غربالا. يقال لك إنها تحفة فنية، لأن (مارسيل ديشامب) قام بذلك، منذ سنوات. لكنه قام بذلك لقطع كل صلة مع الكلاسيكية التي أصبحت جامدة للغاية. لكن لا ليدعي أحد، أن ذلك شكل من أشكال التعبير. إنه أمر سخيف وعبثي! وتُرتكب الهفوات نفسها أيضا في الأدب والشعر، على وجه الخصوص. لديك قصائد، من المفترض أنها ملموسة، حيث يُحكى أن شخصا ما أخذ دراجة، ليقوم بنزهة، وهذا مشى بجانب الحائط، وعاد. وبعد هذا، ها أنت ترى أن هذا الأمر يمثل القصيدة. إن ما يسمى بالفن المفاهيمي يثير اشمئزازي. ويثيره أيضا ما يسمى الطليعة السهلة. هناك طلائع شرعية تماما. والعديد من (المذاهب) الطليعية، عبر التاريخ كانت شرعية، واخترقت هياكل شديدة الصلابة. لكن، إذا أصبحت نظاما في حد ذاته، فهذا أمر سلبي للغاية. الفن المفاهيمي رعب مقدس مثل أي طليعة صبيانية وعبثية.