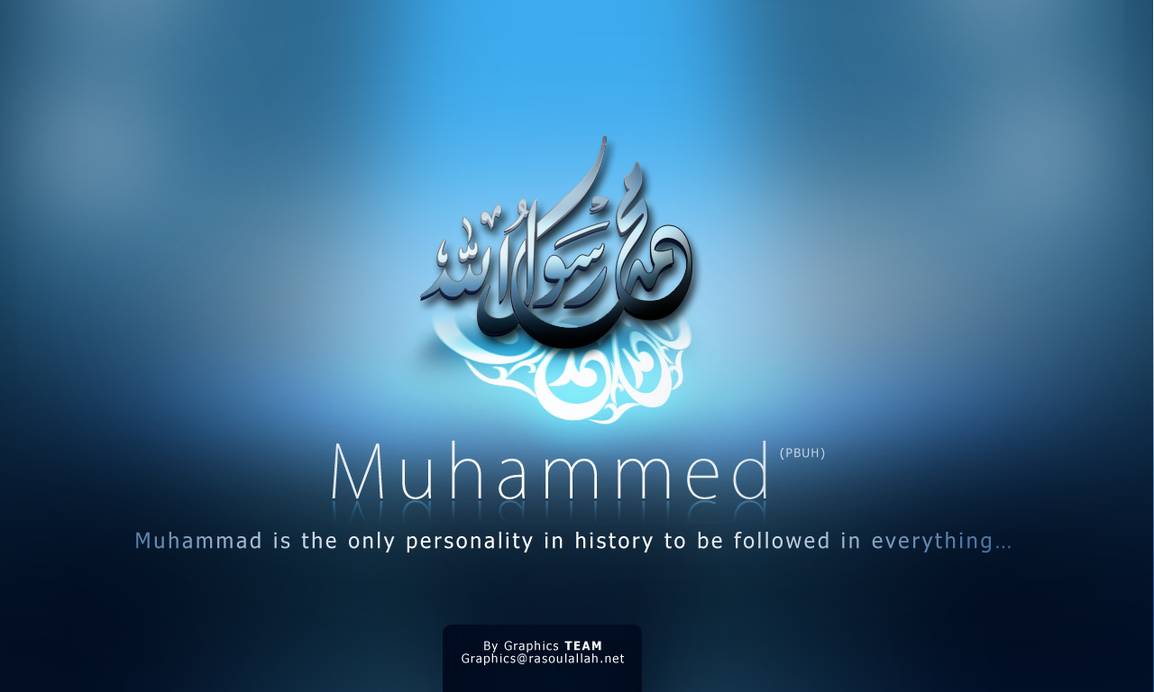أصدقائي الذين مضوا
2023-07-17

باسم النبريص
أصدقائي الذين مضوا... أحياناً على وجه الفجر،
يوقظونني من النوم، وأكون توّاً، حلُمت بهم.
أستيقظ: أحاول تذكُّر نتفٍ من الحلم، فتعبرني وجوهُهم سريعةً، دون أسماء.
أحيرُ وأستغرب...
كيف نسيتُهم وقد كانوا ملء البصر والخَافق، رفاق مسيرة الأدب البازغ بعد حرب حزيران، وزملاء معتقلات العدوّ، في زمن الرصاص؟
تعبرني أشجارٌ غامضة من بقايا الحلم، فأصل إلى حلّ: أُعطي لكلّ شجرة اسم من أسمائهم.
هذه الجميزة اسمها عبد الحميد طَقَّش.
هذه التينة اسمها زكي العيلة.
شجرة التوت اسمها محمد أيوب.
شجرة اللوز اسمها غريب عسقلاني.
شجرة الرمّان لها اسم عُمر حَمَّش.
المشمشة اسمها صبحي حمدان.
الأكاسيا اسمها وليد الهليس.
شجرة النبق لها اسم وليد خازندار.
هذه السروة اسمها معين بسيسو.
دالية العنب لها اسم ناهض الريس.
هذه الصفصافة اسمها محمود شقير.
شجرة الحور لها اسم فاروق وادي.
أرضى قليلاً، وينسحب إلى الخلف، مؤقّتاً، شعوري بخيانة أيامهم الجميلة، الصعبة.
ذكرى، لا يستسيغُها حداثيّو أدب ما بعد أوسلو
أدور في الغرفة، دون أن أشعل اللمبة. أدور وألوب على ذكريات سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
كيف كنّا نكتب، لنقرأ لبعضنا، قبل النشر، في صحف وطنية، يطاردها شبحُ الرقيب العسكري الصهيوني.
كيف كنّا نشتغل على الترميز البسيط، بكلّ ما فينا من وهَج وغُفْل، لننجو من مقص الرقيب. مقصّه الذي يتولّاه عادةً صهيونيٌّ معه دكتوراه في الأدب العربي، وله رتبةُ العسكر.
صهيونيّ يحاسبنا على الظنّ والنأمة؟
أتذكّر اجتماعاتنا شبه السريّة في بيوت بعضنا البعض، داخل أو على أطراف المخيّم.
بيت شيخنا عبد الحميد في قلعة خان يونس التاريخية. بركة أبو راشد ومخيم الجُرُن في جباليا. حارة الجامع، وبيتي الأوّل المجاور لمدرسة السِّت حياة الإعدادية لبنات اللاجئين. بيت غريب بمخيم الشاطئ وكان على شارع عام.
تقاسُمُنا للكتب الثمينة التي نادراً ما ظفرنا بها،
وكيف وأين كان يلاحق الشاباك عناوينها
ويمنعها: منشورات الحزب الشيوعي: الاتحاد والجديد، في حيفا، دار صلاح الدين وأبو عرفة في القدس، دار الشروق في رام الله، مجلة الكاتب، ومقر اتحاد الكتّاب قريباً من المدينة الأغلى، دار الأسوار في عكا. ولعلني نسيت دوراً عزيزة أُخرى، فالمعذرة.
هل كنا كتّاب الضرورة، انبثقنا من فراغ ما بعد حزيران؟
لقد مرّ وقتٌ طويل منذ حدثَ ذلك. وما نسيتها ولا نسيتكم، ولكنّ تعاقُب الليل والنهار في المنفى الفلامني، أحياناً ما يُنسي.
أتذكّر وأتذكّر: كيف كان أحدنا يكتب القصّة القصيرة أو القصيدة، وينتهي منها فجراً، فيقوم، ناسياً فطوره، راكباً سيارة أُجرة، أو ماشياً (من قال إنّ المسافات تهمّ؟)، فيطرق باب زميله في السادسة صباحاً، بكلّ ما في الروح من أشواق وصبابات الكتابة، لكي يقرأها عليه، كلمةً كلمة، متذوّقاً على اللسان كلّ فاصلة ونقطة منها، وكأنّها فاكهة محرّمة، دون مراعاة حال الصديق وأهل بيته.
هل تتذكّر يا رفيقي جبر شعث؟
كلّ هذا حدَثَ منذ عقود، وكلّ هذا صار اليوم ذكرى، لا يستسيغُها حداثيّو أدب ما بعد أوسلو.
نحدّثهم عن اعتقالنا بسبب مقطع من قصيدة: عن استدعاء رجل المخابرات لأحدنا، على وشّ الفجر، معززاً بقوّة إرهابٍ لا تقلّ عن أربع "جيبات" عسكرية وعشرين مجنداً، فلا يصدّقون.
كيف كنّا نُشبح مثل الذبائح في سجن غزة المركزي ـ (المسلخ).
كيف كنت ذات صيف من العام 1976، أوشك أن أقطع لقمة عيش زميلنا غريب عسقلاني، الذي لم أكن أعرف حينها اسمه الحقيقي، وهذا من حسن حظّه، وقد قيل لي إنّه يعمل مدرِّساً في مدارس الحكومة، فرُحت أسأل عنه في مديرية التعليم بالسرايا، وكان يرأسها ضابط في جيش الاحتلال، وهنالك، سألت موظّفين فلسطينيّين إداريّين، فلم يعرفوا الاسم.
أيامٌ ولّت.
أتذكّرهم بينما الأبطال في جنين يجترحون المعجزات
بعدها طفحَ الكيل، وجاءت معجزة الانتفاضة الأُولى العظيمة.
اعتُقلنا كلّنا تقريباً، والبعض منّا غير مرّة. وإن أنس، لا أنسى كيف كنتُ مع الروائي الراحل محمد أيوب، نوزّع المناشير في صقيع فجر الكوانين وأيام الأربعينية.
رفاق الحزب والجبهة لم يعرفوا ذلك، لأنّنا أخفينا الأمر عنهم.
كتبنا ونشرنا، ومن كان منّا صمَتَ لسنوات، فجّرت ينبوعَه الأحداثُ، فعاد للفن.
هل كنّا كتّاب الضرورة، انبثقنا من فراغ ما تركت نكسةُ حزيران، وعبّأنا خُلُوّ ساحة الكلمة، وفقاً لقانون أنّ الحياة لا تقبل العَدَم؟
خاصّة وأنّ جيل الآباء رحل لمصر، أو رحّلته قوّات المحتل، كما فعلت مع جميع الذكور في قطاع غزة، من عمر الشباب حتى عمر الكهولة؟
معين بسيسو وحسيب القاضي وهارون هاشم رشيد وناهض الريّس، وسواهم؟
ليكُن. فما من بشري قادر على اختراق قوانين الفيزياء، وقوانين الأدب، تالياً وبالضرورة.
بعدها جاءت نكبة أوسلو الثانية. وأُعيد تدوير أو إنتاج معركة أُحُد. لقد انقلبَ عاليها سافلها وتلخبطت الأمور، حدَّ المهزلة.
ثلاثون عاماً أو يزيد مرّت علينا، حتى صرنا إلى ما صرنا عليه اليوم: ناس مع المقاومة، وناس مع المنصب والامتيازات (يا تُعْسَ الأواخر)!
ثوّار تحوّلوا إلى بصّاصين على المقاومين.
ثوّار وضعوا نجوماً على الأكتاف، زاحمت نجوم سماء الله الأُولى. وغدا شغلهم الوحيد أن يراقبوا ويكتبوا تقاريرَ يُقال - والعهدة على الراوي - أنّ بعضها يُرفع ويُقدّم للمحتّل.
وا أسَفاً... وأسَفاً يا ثلّة رفاق الأمس، كيف انقلبنا على أنفسنا وعلى تاريخ شعبنا الممتدّ في المكابدة منذ قرن، مسترشدين فقط بلحمنا الحيّ، وبقانون اجترحته فلسطينُ، آيته: "الكفُّ تلاطم المخرز".
أتذكّرهم!
أتذكّر من قضى منهم، أكان فدائياً أم أديباً.
أتذكُر خليل التَّلْمَسْ يا عمر حمّش ـ مَن أبدعتَ عنه في رواياتك.
أنت لا تدري، إلى اليوم، أنّني رأيت بأمّ عيني، في العام 1969، لونَ رصاصاته الخضراء، وكيف كانت تزغرد في عتمة ما بعد انتصاف الليل، من رشّاشه "البرن"، وهو لابدٌ لدورية الجيش، من فوق شجرة الكينا الوحيدة في حاكورة أبو نايف زعرب، المجاورة لبيتي في مخيم بلوك ـ دي.
أتذكر كم قتَلَ منهم مع رفيقه زكي شعت (كلاهما من جيراننا، وكم بعثاني في مشاوير مع ورق مكتوب، وكانا يحذّرانني من فتحه في الطريق، لرفاق آخرين. وكم حملت لهما صينية الشاي، في دكّانة أخي أبو هاني، التي هي غرفة من غرفتَي بيتنا الوحيدتين).
ما زلنا بخير، ما دامت كلمتنا تكتبها أجيال من بعدنا
لقد قتل لا أقلّ من 12، ناهيك عن الإصابات. حتى إذا قتلوه وسقطَ عن الشجرة العالية، كما ينهار كتفُ الجبل، داسوا على جثمانه مراراً، جندياً فمجنّدةً فضابطاً، وأفرغوا فيه مخازنَ من رصاص بندقيتهم "العوزي"، وصراخَهم الوحشي، انتقاماً.
أتذكر غبش أيامنا هذه، وآسى.. لكن ما نفع الأسى مع عدوّ قادر وفاجر وفاشيّ السمات والسلوك؟
أتذكرهم في وقت كتابة هذه الزفرة، بينما الأبطال في جنين يجترحون المعجزات، فتعود لي قطعةٌ من روحي.
أتذكرهم وأنا منفيٌّ في مدينة أنتويرب، ساكناً، يا لمفارقة الأقدار، في حي "بيرخم"، اليهودي الأصولي، حيث تزدهر تجارة الألماس هنا منذ خمسة قرون.
أُحسّ بالندم والذنب دون سبب محدَّد. ألوب في أمتار الغرفة القليلة في الطابق السفلي، المجاورة لإشارة الضوء، ثم أعود لفراشي على الأرض، عسى يسعفني النوم، إنما هيهات.
أقوم بعد ساعة من التحديق في السقف العاتم، وقد شقشقَ ضوءُ الفجر.
أقوم لأكتب هذه الزفرة، كي أرسلها إلى شاعر، أخذ كتفاً عنّا، وما يزال يواصل نهج المقاومة، في أدبه الرفيع، أخفت نبرة ممّا كنّا نكتب، وله بصيرة آسية، تحفر في الصخر، أعمق.
ما زلنا بخير يا علي الخليلي.
ما زلنا بخير يا عبد اللطيف عقل.
ما زلنا بخير يا محمد البطراوي ويا عزّت الغزاوي.
ما زلنا بخير، ما دامت كلمتنا، تكتبها أجيال من بعدنا، على أسنّة التحرير، دون نسيان شَرطها الفنّي.
شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا