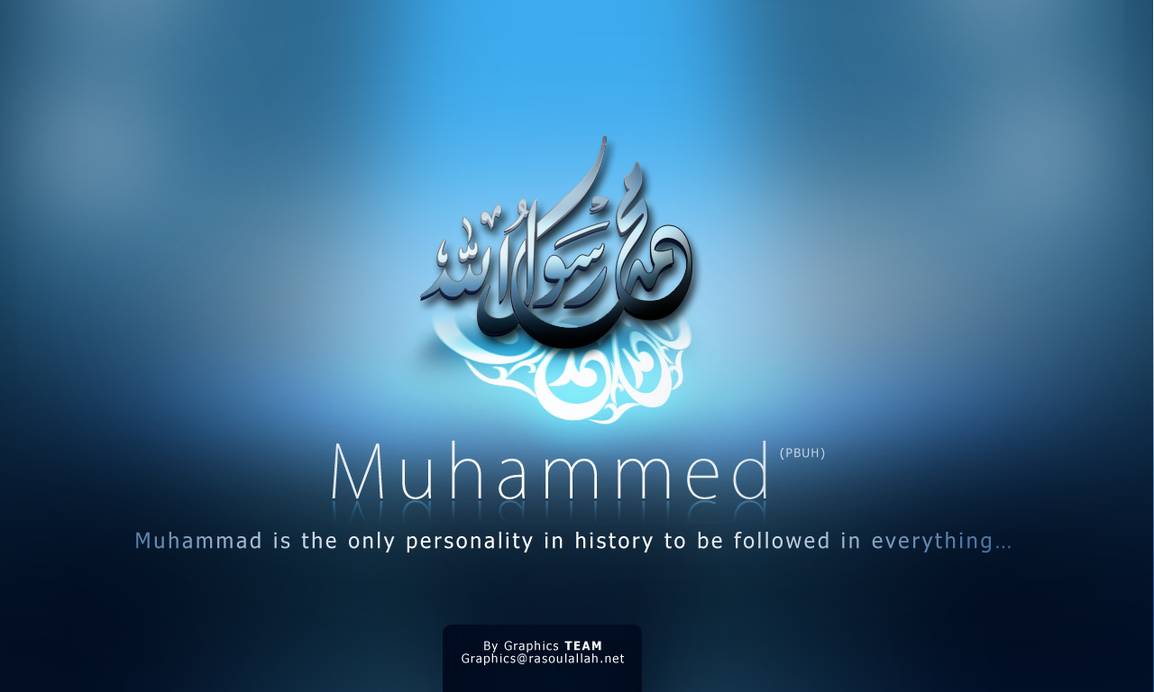مقالات عبد العظيم السلطاني: الهم المعرفي والاقتصاد البياني
2023-11-15

وسام حسين العبيدي
للمقالة عالمها الخاص بها، وتقاليدها الأدبية المتعارف عليها عند أربابها، قد لا نجد الحاجة إلى التعريف بأصولها، وتقاليد كتابتها وتطور تلكم التقاليد، إذ كفانا مؤونة القول في هذا المجال ما كتبه الراحل علي جواد الطاهر في كتابه «مقدمة في النقد الأدبي» قبل أكثر من ستين عاما، حسبما أشار إليه الطاهر في مقدمة كتابه، وحديثا ـ أي في عام 2018 من دار الشؤون الثقافية- ما أصدره قيس كاظم الجنابي من كتابٍ وسمه بـ»المقالة الأدبية في العراق ـ النشأة والتطور» وقد فصّل القول في نشأتها في العراق وأعلامها ومراحل تطورها أسلوبيا وفكريا، إلخ من قضايا تتصل بأدبية المقالة، وهي إن بلغت من الشأو الأدبي بين أجناس الأدب وأشكاله، لكنها لم تتعد ما رسمه لها الطاهر من حد يضعها في الجانب الذاتي أو التجربة الشخصية، إذ «تلتقي كلماتها وفقراتها عند الدافع المباشر، أو ما يشيعه هذا الدافع في نفس صاحبه، لتنقل إلى القارئ تأثره، وما يصحبه من أفكار وتأملات وخطرات، في صورٍ جميلةٍ مستمدةٍ من خيال صاحبها، وحياةٍ مصدرها صدقه، ووراء ذلك كله موهبةٌ تحيل التجربة من تجارب الحياة اليومية والمشهد من مشاهدها فنا لغويا يستهوي القارئ بجمال أدائه وطراوة إطاره وحميمية اللهجة التي يخاطبه بها الكاتب ويناجيه، دون تكلفٍ، بما يشبه البث والهمسَ والعفوية، وكأنه أخٌ أو صديقٌ كريم أو متحدثٌ في مجلسٍ يجمع أهلَه بين رهافة الحس ورقي التقاليد والارتياح للتفنن» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1979).
وقليلٌ من التدبر في هذا العرض لمفهوم المقالة حسب الطاهر، نجده يتمثل بوضوح في ما وضعه بين أيدينا مؤخرا عبد العظيم رهيف السلطاني في كتابه «ثلاثٌ وثلاثون مقالة في الثقافة والأدب» الصادر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، إذ احتشدت فيه مضامين ما ذكره الطاهر أعلاه، للمقالة من سماتٍ فنيةٍ وموضوعية، وليس ذلك ببعيدٍ عن باحثٍ قدير مثل السلطاني، اشتغل وعيه النقدي منذ أطروحته للدكتوراه عام 1997 عن «نقد التأليف الأدبي عند العرب بين الحربين العالميتين» على استقراء عدد كبير من المقالات الأدبية والنقدية التي كتبها نقاد يلاحقون به كتبا أدبية ونقدية تم تأليفها، فكان لهم أنْ يعملوا حاستهم النقدية بإبداء ما عنّ لهم من ملاحظ عن تلك الكتب، يتعلق بعضها بالضبط المنهجي من عدمه من جهة، أو بلغتها من حيث التوتر في لغة الخطاب من عدمه، أو بغير ذلك من مسائل يراها الناقد جديرة بالأخذ من قبل المؤلف في ذلك الكتاب، في حال إعادة طبع الكتاب مرة أخرى، بما يرتقي بذلك المنجز لما هو أفضل علميا وأدبيا، ولعلنا نلتقط إشارة مهمة في تلك الأطروحة قبل طباعتها كتابا عام 2021 ينوه فيها المؤلف بما أبداه الطاهر من دعمٍ لكونها «نشأت فكرة ورعاها بخبرته الغنية وملاحظاته السديدة ومكتبته العامرة» وهي ملاحظة إن دلت على شيء، فإنما تدل على بُعدٍ معرفي أدبي من قبل السلطاني بالطاهر، ومن ذلك تأثره بما كان للطاهر من أسلوبٍ مقالي مميز، يتسم برشاقة الألفاظ وأناقتها، فضلا عن الاعتناء بالفكرة التي تحركه للكتاب، من دون أن يجور أحد الجانبين – الشكلي والمضموني – على الآخر.
ومن هذا المنطلق، وجدنا مقالات كتاب السلطاني، يحركها هم معرفي وأدبي في آنٍ واحد، ولم يكن للترف الفكري مكانٌ بين هذين الهَمين، إذ يوجز لنا تلك الهموم في عنوانات تلكم المقالات، من قبيل: «عن التخلي في أقسام اللغة العربية أتحدث» أو «أبعدوا الخرافيين عن النقد الحديث» أو «عزيزي الكاتب: عنوانك حصانك» أو «المهرجانات العشوائية» أو «حين يكون الأديب عبئا على نصه» أو «الثقافة والمصطلحات العشوائية في درس الشعر» أو «كي لا يكون التاريخ حكايات عجائز» أو «كي لا يكون الأدب نشرة أخبار» أو «ظلم الكلمات مقدمة لظلم الناس» الخ من عنوانات لا تخرج عن الواعز الأخلاقي من وفاء الأجيال اللاحقة للسابقة لها عبر استذكارها، ومن تأكيد لجوانب أخرى تتصل عمليا بالجانب العلمي أو الأدبي للباحث أو الأديب، من مصداقية وأمانة وموضوعية وبحث عن الجيد، وترك الرديء، واحترام الذات عبر احترام الآخر، ونقد كل ما يند عن هذه المداليل، من فوضى وعشوائية في المناشط الأدبية، أو انعدام التخطيط العلمي لاختيار مشروع البحث، أو السطحية والتعامل بوجهين في الجانب الأدبي والاجتماعي، أو الخداع والتضليل بوجهٍ عام واستشرائه في المجال الأدبي أو الأكاديمي، إلخ، وعبر هذه العنوانات وغيرها، تظهر لنا «الوظيفة التعيينية» – تلك الوظيفة التي وصفها جيرار جينيت بأنها «من أهم الوظائف التي يمكنها أن تتجاوز الوظائف، لأنها تزيد من تطابق العنوان مع النص» – ممثلة بالوضوح والمباشرة فيما يريده الكاتب من مقالته، نائيا بنفسه عن «الضربات الفنية» التي مارسها رهطٌ من الكتاب، لم ينطلق أكثرهم من هم معرفي يدفعهم لكتابة تلكم المقالات، فوجدوا تعويضا لذلك الفراغ، إن «العنوان لعبةٌ يمررها الكاتب حتى تلتهم الموضوع ليصبح جزءا من تلك اللعبة، والكاتب لاعب خطير متوقد الذهن، يضحك أحيانا على القراء ليختبر ذكاءهم، ويكتشف مواهبهم، وأحيانا يستفزهم، أو ينافقهم، لأنهم يريدون منه العبارات المغرية، وهو يريد منهم استمرار اللعبة» (الجنابي، مصدر سابق) وإذا كانت المقالة خلوا من هذه المغريات التي تدفع في اتجاه قراءتها من قبل المتلقي، فلا يعني أن أصحاب هذا الاتجاه يقفون مكتوفي الأيدي، ففي الصراحة والوضوح ثمة أفانين أخر تعمل هي الأخرى على الترويج لما يريده الكاتب من أفكار يسعى لنشرها بين الناس، ومن تلكم الأساليب كان الاستفهام حاضرا في عنوانات مقالات هذا الكتاب، فنقرأ: «هل اقترف بدر شاكر السياب خطأ؟» أو «لماذا أحيي قصيدة رياض الغريب» أو «ما الذي تبقى من محمد مهدي البصير» أو «ما الذي يعيق الكاتب من أنْ ينقد ما نشر» فهي عنوانات تدفع للقراءة، بما لدلالة الاستفهام من فضول معرفي يحرك المتلقي ليعرف الجواب بين طيات تلكم المقالات، أو أسلوب الإيجاز في صياغة بعض عنوانات تلكم المقالات، ومعلومٌ أن الإيجاز له أثره البياني الواضح، لا من حيث التدليل على المعنى فحسب، بل بتركيزه على معانٍ ثاويةٍ في ظلال المعنى الرئيس الذي يترشح من دلالة العنوان، فمثلا عنوان مقالته: «كيمياء الكتابة» أو «للقصيدة ثقافتها» أو «الداعية الثقافي» أو «نريد أن نفهم» أو «الحياة فرصة حرة» أو «من أعباء الماضي» كلها عنوانات تدفع فضول القارئ لقراءتها والتعرف على مضامين تلكم المقالات، بما تنطوي عليه من إيجازٍ لم يدع للقارئ فرصة للتعرف على الفكرة التي ينوي الكاتب عرضها في تلك المقالة.
وإنْ كان من أهميةٍ لتلك المقالات، فهو الجانب المضموني، الذي يقف إلى جانب الشكلي منها، إذ بمجموعها تعكس لنا هموم مثقفٍ أكاديمي يعيش واقعه الأكاديمي من جانب، فيعكس لنا همومه في أول مقالٍ عن «التخلي» الذي ينعى حضوره وتفشيه في أروقة قسم اللغة العربية، بوصفها مثالا لأقسام أخرى، لم يكن حالها بأفضل من ذلك القسم، إذ الابتعاد عن «الجو الثقافي» الذي ينبغي أن يشيعه كل قسمٍ في أروقته، وعلى رواده من أساتذة أو طلبة، بما يدفع لكثيرٍ من «المصداقية» بين الجانب النظري من معارف، والجانب التطبيقي، ومن صيحته بكل من يجرَّ النقد ـ بوصفه المعطى الأساس للمعرفة – إلى ساحة «التخريف» في مقالته «أبعدوا الخرافيين عن النقد الحديث» عبر معايشةٍ يتلمس القارئ مدى حزنه من ممارسات أبعد ما تكون عن فكرة النقد، بما تعمل على إضاعة الثمرة التي ينبغي قطفها من هذا الدرس، مؤمنا بما أدلى به سارتر في كتابه المهم «دفاع عن المثقفين» من «أن المعرفة التي لا توضع باستمرار موضع النقد، والتي تتجاوز نفسها وتعيد توكيد ذاتها بدءا من ذلك النقد، معرفةٌ عاريةٌ من كل قيمة». وهذا القول وضعه السلطاني هدفا يتغياه في مقدمته لأطروحته. وانتهاء بمقاله عن «البحث الأكاديمي: التخصص والوعي المنهجي» الذي وضع قارئه نصبَ «حقيقة البحث الأكاديمي» ممثلة بعمقه، وهذا العمق، حسبما يراه، منوطٌ بطريقة تفكير الباحث، باستناده إلى فلسفةٍ يصطفيها بوعيٍ، وإلى نظريةٍ في التفكير، فيتحول البحث لديه إلى تجربة كتابة مكتملة، تناسق نفسها فترفض ما هو غريبٌ عنها وطارئٌ عليها، فالكتابة تختبر فرضياتها من خلال مسيرة البحث.
وهذا المعنى لم يخرج عن القضية التي حركته في مختلف المقالات، التي كتبها في هذا الكتاب، وقد تصل به هذه النزعة المثالية، والابتعاد عن الادعاء، اعترافا بما للعقل البشري من طاقة، واحتراما لمحدودية قدرة الإنسان غير الخارقة، أنْ ينأى عن كل ما يشتت جهده في ما لا يحسن فيه، فللبحث تقاليده وأعرافه التي لا يحق للباحث أن يتذاكى عليها، وفي المجال الأدبي يرى «للقصيدة ثقافتها» فيرفض مبدأ التنوع الأجناسي عند الشاعر، إيمانا منه أن لكل جنسٍ أعرافه وثقافته التي ينبغي مراعاتها في الكتابة، كذلك في مقالته «أرجوك إما شاعرٌ وإما روائي» ناعيا على من لم يخلص لواحدٍ من الفنين دون الآخر، بما يجعله يخوض في مجالين لكل واحدٍ منهما أعرافه الكتابية، وفي المحصلة لا يكون إلا «كمثل الطائر الذي أراد أن يقلد مشية طائرٍ آخر، فنسي مشيته» تلك القصة التي حكاها لنا ابن المقفع في «كليلة ودمنة» ومن هذا المنطلق يشكك السلطاني حتى في الحالات الفردية التي نجح فيها بعض الأدباء من الإمساك برمانتين، أو أكثر في يدٍ واحدة، مؤكدا أن ممثلي هذا الاستثناء ليسوا بالكفاءة نفسها في ما ينتجونه من أجناس مختلفة، فلا شك لديه أنهم في أحد هذه الأجناس أفضل تمثلا من الآخر، وهذا ما لا يستقيم وواقع الحالة الإبداعية عربيا أو عالميا، ولو جئنا بأمثلة تؤكد ما نذهب إليه، فقد نجد مثل يوسف الصائغ، الذي انطوى على إمكانات إبداعية كبيرة متعددة، فلم يقتصر نتاجه على الشعر، بل تجاوزه إلى الرواية، وإن كان نتاجه الروائي أقل حضورا من الشعر، إلا أنه على أي حال كان في الرواية بالغا شأوا بعيدا من حيث الجودة والفرادة، وعالميا فقد كان الفرنسي فيكتور هوغو شاعرا وروائيا، مع أنه اشتهرَ في موطنه بالشاعر أكثر من وصفه روائيا، وفي خارجه كان وصف الروائي يسبق الشاعر، ومع ذلك لم يفشل في التوفيق بينهما، بل حاز أعلى مراتب التميز فيهما، إلى غير ما ذكرت من نماذج عربية أو غربية، تؤكد لنا أن الإبداع حالةٌ استثنائية، لا تخضع لهذه الموجهات.
والحال نفسه نجده عند من جمع بين كتابة شعر التفعيلة، أو قصيدة النثر، فالاستثناء القائم على الفرادة والإبداع يمثل سيد الموقف في تقييم منجز الشاعر إن كان متقنا «شروط اللعبة» لكل جنس من أجناس الشعر، باعتبار ما لكل واحدٍ من اشتراطات فنية وفكرية ينبغي لمن يلتزم طريقة على شاكلة أحدهما أن يخضع لتلك الاشتراطات. أما الحالة العامة التي تفشت في واقعنا الأدبي ـ غير السليم من أدران «الفهلوة»- فنتفق فيها مع التوصيف الذي ذكره لها السلطاني، بقوله: «حين يكتب شاعرٌ صيغتين من القصيدة في آنٍ واحد فهذا يتضمن مشكلة ثقافية، وهذه المشكلة تبدو أكثر نشازا حين يكتب ذلك الشاعر الصيغ الثلاث للقصيدة (العمودية، قصيدة التفعيلة، قصيدة النثر) وهو في كل هذا إنما يعبر عن طبيعة وعيٍ ثقافي يجد الازدواج والتعدد في التصورات أمرا طبيعيا. ويكشف هذا أن ذلك الشاعر لا يؤمن بارتباط القصيدة بثقافتها» ولعل السلطاني في سره يؤمن بمبدأ الفرادة الذي يستثنى من هذا التصور، ولكن لكثرة من يراهم اليوم قد ولجوا كل جنسٍ من أجناس الأدب، من دون أنْ تختمر تجربتهم في واحدٍ منها، جعله يطلق صيحته، معبرا في كل ذلك عن موقفه الملتزم إزاء الفن والجمال، بما يعكس نزعة الجد والإخلاص للتخصص، لا في المجال الأدبي، بل في المجال العلمي، إذ يتلمس القريبون من طلبته، ما كان يضيق به ذرعا ممن يدعون الفهم والإحاطة في كل تخصصٍ من تخصصات الأدب والنقد، فيسيؤون من حيث يشعرون أو لا يشعرون لأنفسهم قبل الآخرين من طلبة ـ لاسيما في مرحلة الإشراف – ممن لم يسعفهم الحظ بمن يوجههم ويضعهم على الطريق الصحيح.
كاتب عراقي