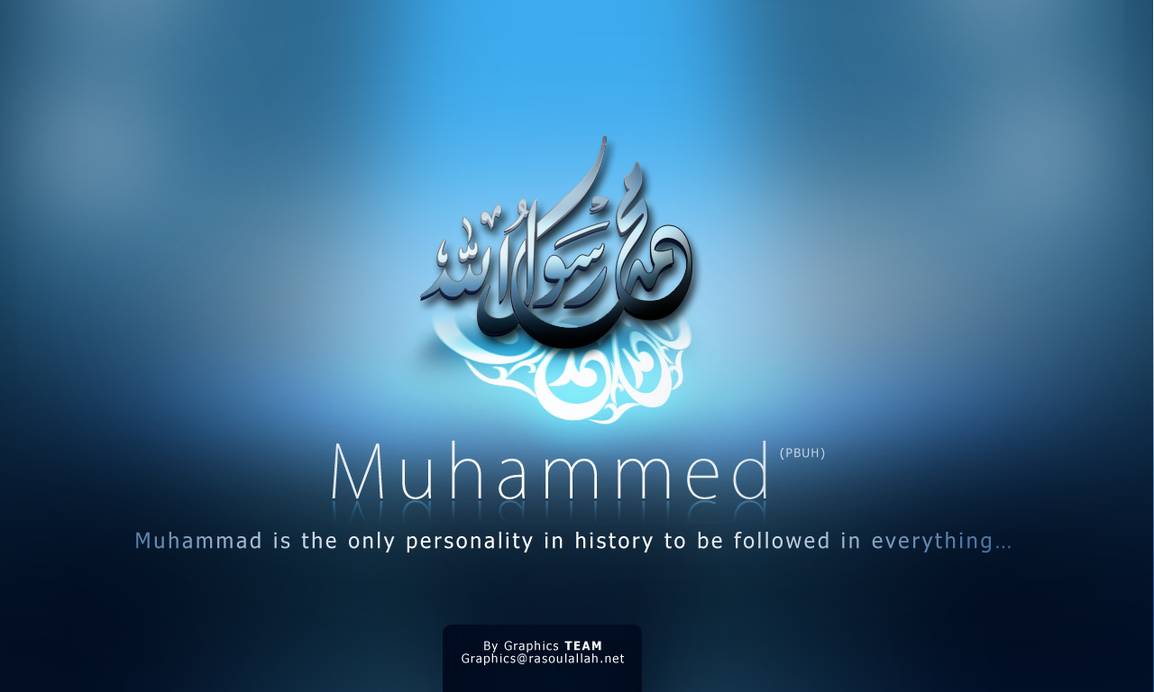رباعية القهر في رواية «قطط إسطنبول» للسوري زياد حمّامي
2023-11-17

موسى إبراهيم أبو رياش
اللاجئ، أي لاجئ إنسان يعيش على الهامش، إنسان من الدرجة الثانية وربما العاشرة، إنسان غير مرغوب فيه؛ فالمواطن يشعر بأن اللاجئ عبء ثقيل، وضيف جاء على غفلة، لا يشاطرهم العمل والجغرافيا فحسب، بل جاء ليسلبها منهم، ويهدد استقرارهم وأمنهم وأرزاقهم، ولذا ثمة عداء مبطن أو مكشوف للاجئ، ورفض لوجوده وعدم تقبله، وللأسف نجحت الدعوات القومية والإقليمية والعصبية والقطرية في خلق حواجز شاهقة بين الناس، وتشظي العلاقات الإنسانية، واستكلاب الناس في الانتصار لأنانيتهم على حساب كل خلق ودين وإنسانية. ولذا فكل حديث أو كتابة عن اللاجئ كتابة مُرَّة مؤلمة، تتعب النفس وتجرحها، وتوجع القلب وتدميه.
وتأتي رواية «قطط إسطنبول» للروائي السوري زياد كمال حمّامي، لتسلط الضوء على الواقع المزري للاجئين السوريين في إسطنبول، وما يعانونه من تمييز وتضييق ومعاملة غير إنسانية، وملاحقتهم، وحرمانهم من حقوقهم كلاجئين، من خلال «اللولو» الشخصية الرئيسة في الرواية، الذي يعيش حياة التشرد والبؤس والحرمان، ويكشف خفايا القاع، وما يتعرض له اللاجئون من تمييز وظلم وتهميش وإذلال. صدرت الرواية عن دار نون4 للنشر والطباعة والتوزيع، عام 2023، في 292 صفحة، توزعت على 44 فصلا.
تستدعي الرواية العديد من القراءات والمقاربات في مجالات كثيرة يمكن تناولها والبحث فيها. وتتناول هذه المقالة موضوع القهر الذي سُلط على اللاجئ السوري، وتعرض له في بلده أولا ومن ثم في إسطنبول. وكل ما في الرواية يصور القهر الذي تعرض ويتعرض له اللاجئ السوري، وصور هذا القهر لا حصر لها، ومنها الظلم والاستغلال والخداع والغش والاغتصاب والحرمان والإذلال والتشريد والمطاردة وغيرها الكثير. ويمكن إجمال ذلك في عناوين أو مصادر أربعة للقهر.
الاقتتال الداخلي
لا أحد يرغب بترك وطنه ترفا، وإنما لأسباب قاهرة، وأهمها الخوف على حياته ومن يعول، فلا مفر عند ذاك من البحث عن ملاذ يوفر أمنا أو بعض أمن، وإن على حساب أمور كثيرة، فاللاجئ مرغم على التنازل والتخلي ليحصل على بعض ما يريد. وإزاء الاقتتال الداخلي في سوريا الذي لم يوفر أحدا، وحوَّل سوريا إلى ساحة حرب وخراب، وغاب عنها الأمن، وسيطر الخوف والرعب، وافتقد الناس أعمالهم وأبسط مقومات الحياة، إزاء ذلك فر السوري بأسرته إلى البلدان المجاورة، تاركا أرضه وبيته وعمله ووطنه، ليوفر أبسط متطلبات الحياة لأسرته، التي كان يتهددها الموت في أي لحظة، إنها الحرب التي لفظتهم إلى دول اللجوء والاغتراب والتيه والضياع. هذا القهر الذي صُبَّ على رؤوس السوريين، واضطرهم للهجرة مرغمين، تتحمل مسؤوليته ووزره الأطراف المتحاربة كافة في سوريا، فقد كانت حرية المواطن السوري هي المشجب الذي يتقاتلون لأجله، وكل يدعي وصلا بليلى، لكن معظم الأطراف لم تأبه بالمواطن السوري، واتخذت منه أداة لتحقيق مصالحها، وتنفيذ أجندتها على الأرض السورية. وكان المواطن السوري المدني وقودا للاحتراب، ولا يقبل منه الحياد، وإلا كان عدوا لجميع الأطراف، أي أنه في أحسن الأحوال عدو لأحد الأطراف المتحاربة.
إن تكالب النظام والجماعات المسلحة وصراعهم المصلحي أدى إلى قهر المواطن السوري، وفقدانه الأمل، وفراره من ساحة الصراع طلبا للنجاة، في معادلة تستعصي على الفهم؛ لأنها خارج المنطق والمعقول؛ فمن جاء ليحررك يشترط استعبادك أولا. وما درى السوري وربما درى أنه فرَّ من الجحيم إلى الجحيم، فكل ما عدا الوطن جحيم، وإن فُرش بالزهور ورُشَّ بالعطور.
الدولة المضيفة
الدول المضيفة للاجئين، تكون مضطرة لذلك بحكم القانون والمعاهدات الدولية، لكنها لا تستقبلهم مجانا، فلكل شيء ثمن، وثمن باهظ في أغلب الأحيان، ومع ذلك لا يمكن أن تعاملهم كمواطنين من ناحية إنسانية وخدماتية، وليس لهم أي أولوية، وتصور رواية «قطط إسطنبول» تضييق السلطات التركية على اللاجئين وحرمانهم من الوثائق الرسمية التي كفلتها لهم المواثيق الدولية كلاجئين، وتركهم ضحايا للسماسرة والنصابين والاستغلاليين والعصابات المنظمة، ولا توفر لهم الحماية المطلوبة، ولا الرعاية كبشر من حقهم العيش في ظروف إنسانية معقولة. وزاد الطين بلة الدعوات المتزايدة لطرد اللاجئين السوريين، خاصة من قبل العديد من المرشحين السياسيين للانتخابات؛ لدغدغة مشاعر الأتراك واستمالتهم، على اعتبار أن اللاجئين من أسباب البطالة وارتفاع الأسعار وخلخلة الاستقرار، وأدى التحريض على اللاجئين إلى تحطيم محالهم، والاغتصاب والعنف، وازدياد موجة الكراهية والعنصرية، والقتل على الشبهة، والإذلال الذي أدى إلى انتحار البعض.
وفي مفارقة صارخة، أن «اللولو» اكتشف عندما همَّ بنزهة لقطته «هند هانم» أن القطط في إسطنبول تنعم بأوراق رسمية ومتنزهات وألعاب وشهادات تطعيم، بينما يُحرم منها اللاجئ السوري، الذي يعيش على هامش الهامش. يتذكر «اللولو» أحد مواقف الإذلال: «عندما وقف في الدَّوْر أمام مبنى مديرية الهجرة الموقرة، وكان المئاتُ من الأفراد والعائلات ينتظرون منذ شروق الفجر أن يُفتح بابُ «السلام» لهم، ويطوفون في محراب هذه الدائرة المكرمة، يتزاحمون، يتدافعون، يتناحرون، يتصارخون ، ينهرهم حُرَّاسُ المعبد، ويضحكون، يشتمونهم، يبعدونهم عن المدخل المقدس، لا يُبالون، وأخيرا، بعد تدخل عصي الحُرَّاس الكهربائية، يصطفَّون بنظام وراءَ بعضهم، خروف أمام شاة، وجَدْي وراء نعجة، وقبل أن يقترب دَوْرُه للبيع العلنيّ، أغلق الموظف شباك غرفته الزجاجيّ، وقال كلمة واحدة: «انتهى». أي انتهى الدوام، ولم يعر اهتماما لأي ثُغاء حمل: «باع أو مااع» أو لأي كلمةٍ توضيحية أو استفسارية، حتى لو كانت لكبشٍ ذي قرنين معقوفين أو لشاةٍ عنيدة!.»
وتذكر الرواية حادثة انتحار الشاب «عمرو الأشقر» لأنه لم يستطع الحصول على «الكيملك» وهي بطاقة الحماية الدولية للاجئين، التي تسمح للاجئ بالعمل والتنقل والتعلم بحرية، وكانت الشرط الوحيد لوالد الفتاة التي يحبها ويرغب بالزواج منها.
وبعد فشل محاولة الخروج من تركيا، ااقتيد «اللولو» ومئات اللاجئين من عدة جنسيات إلى مركز حجز لا تتوفر فيه أي خدمات إنسانية، ويصور مشهدا صادما: «السجناء الذي قُبض عليهم وهم يعبرون الحدود الدولية تهريبا واتجارا بالبشر، يجلسون على الأرض العارية، حيث لا شيء يُقدم لهم، لا أكل ولا ماء، وقد تم نهب كل ما يملكونه من مال وذهب مخبوء كانوا يخفونه بطرق شتى كي يساعدهم على الحياة بعد عبورهم الضليل، حتى أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم وهويات الحماية الدولية للاجئين مُزقت كلها، وأُحرقت أمام أعين المقبوض عليهم، ولم يستطع أحد مقاومة ذلك، إذ كانت الأسلحة الأوتوماتيكية مشرعة في صدورهم، وعصي حراس الحدود تنال من أجسادهم، ناهيك عن السب والشتم واللعن المُذل».
والملاحظ أن تركيا تتخذ من اللاجئين السوريين ورقة ضغط على الدول الأوروبية لتحقيق مكاسبها ومصالحها، أي أنها تبتز أوروبا باللاجئين، ترخي وتشد في طرق الهجرة والتهريب حسب استجابة الدول الأوروبية لطلبات تركيا، وبذلك تلوي تركيا اليد الأوروبية من اليد التي توجعها، فهي قد تتقبل لجوء عشرات اللاجئين أو المئات، لكنها لا تستطيع استقبال الملايين الموجودين على الأراضي التركية.
التجار الأتراك
مصائب قوم عند قوم فوائد؛ وما أكثر تجار الحروب الذين يستثمرون بآلام الناس وتعاستهم وجراحهم، ويستغلون ظروفهم وحاجتهم بعيدا عن القيم الإنسانية، وبعض تجار تركيا تاجروا بمصيبة اللاجئين وخاصة في مجالات الدعارة وتجارة الأعضاء ومكاتب السمسرة والهجرة والتهريب، بالإضافة بالطبع إلى أرباب العمل والمصانع الذين استغلوا حاجة اللاجئين للعمل، فشغلوهم بنصف الأجر الحقيقي، خاصة لمن لا يملك تصريحا يسمح له بالعمل.
لم يردع هؤلاء التجار دينهم المشترك مع اللاجئين، ولا جوارهم، ولا صلات القربى والنسب، ولا العلاقات التجارية السابقة، فالتجارة لا دين لها، ولا تعترف إلا بالدرهم والدينار، والليرة والدولار. هؤلاء التجار أشبه بمصاصي دماء، جاءتهم الفريسة إلى عقر دارهم، فلهم الحق الكامل أن يفترسوها كما يشاؤون. ومن أبشع صور التجارة، تجارة الدعارة، حيث استغل قواد تركي «تاجار» وضع «شام» الفتاة السورية التي وقعت ضحية زوج الأم الذي ظنته بديلا للأب فاستغلها وانتهك عرضها، وعندما وثقت «شام» بصديق الفيس «تاجار» استدرجها بحجة الزواج منها، وضمها إلى قطيع العاهرات، وعندما تمردت سجنت وذاقت الأمرين حتى استسلمت في النهاية وهي تضمر الانتقام. و«شام» هنا رمز لسوريا، التي خدعت ودنست من قبل الأقربين، فاستغل الآخرون أوضاعها، فاستباحوها واستباحوا أهلها وثرواتها. وتذكر الرواية طرفا من استغلال الأتراك للعمالة السورية حتى على مستوى المواطن العادي، ومعاملتهم دونية واحتقار، وهضم حقوقهم. ويستوي في ذلك الإعلام التركي الذي يتجاهل معاناة السوريين، ولا يتناولها إلا بعد أن تصبح متداولة وصارخة، بحيث لا يمكنه تجاهلها.
التجار السوريون
ليس مستغربا أن يستغل التاجر المواطن اللاجئين، ويتاجر بدموعهم ونكبتهم، لكن المعيب والشائن أن يستغل بعض اللاجئين السوريين ذلك؛ فلم يراعوا حرمة إخوتهم السوريين وتاجروا بالبضائع الفاسدة والنصب والاحتيال على بعضهم بعضا. إنها قمة الفحش أن يستغل الأخ أخاه وأقاربه وجيرانه وأبناء وطنه ليثري على حسابهم، ولا يرى فيهم إلا صيدا سهلا، وفرصة ذهبية ليسرق ما في جيوبهم، وقبل ذلك يمتص دماءهم، ويا ليته يتاجر بشرف وضمير؛ بل يستغل ويغش ويحتال وينصب.
وتذكر الرواية أمثلة صارخة على بشاعة بعض السوريين واستغلالهم لمواطنيهم وإخوتهم في اللجوء، ومنها: «عبدالحق» صاحب سوبرماركت «شط العرب» ابن حارة «اللولو» في حلب، الذي يبيع لمواطنيه مواد تموينية فاسدة، أدت إلى تسمم ومرض الكثيرين، ومنهم أطفال بسبب الحليب منتهي الصلاحية. والشيخ المزيف «صفوح الهدلة» الذي زعم أنه شيخ، وجمع التبرعات للاجئين، وتبين من بعد أنه تقاسم التبرعات مع عصابته التي سماها جمعية «بر الشام». وصاحب شركة «الوضاح» الذي هرب بعد أن استولى على «كل ما لدى الشركة من أموال المودعين والمهربين والراغبين في الهجرة عبر الحدود». و«قصوع الجزار» الذي كان يعمل بصفة طبيب للأمراض الجلدية، ومعالج فيزيائي، ومدلك، وخريج فرنسا، وتبين أنه «ممرض فاسد، كان يعمل في المشفى الوطني، وقد طرد من الخدمة لسوء سلوكه، بعد أن ضبط بالسرقة في زمن الحرب». وصاحب محل الصياغة «جابر حلاب النملة» الذي كان يمتلك عدة مقاه للقمار في حلب، «ولم يترك فاحشة إلا وحللها لنفسه، ولم يرحم خاسرا في لعبته إلا وامتص دمه» وكان بالإضافة إلى ذلك زير نساء. وفي ساحة ميدان «أسنيورت» الرئيسة، وعلى جوانبها وأمام شوارعها العريضة، مئات من المحال المختلفة، افتتح بعضها أمراء الحرب في سوريا والعراق وليبيا، وأولاد هؤلاء مدللون مرفهون، يتنعمون، فيما أبناء أوطانهم يعانون الحرمان بأبشع صورة.
وفي المقابل، يوجد رجال شرفاء، مثل «اليبرودي» الذي كان مليونيرا قبل الحرب، وفي المقهى يدفع عن كل رفقاء طاولته السوريين، ويواسي اللاجئين ويخفف عنهم، ويسارع إلى نجدتهم ما أمكنه ذلك، بالإضافة إلى دوره التوعوي في كشف أسرار الفاسدين وتاريخهم القذر في سوريا، وتحذير رفاقه منهم.
وبعد، فإن «قطط إسطنبول» لزياد حمّامي، رواية حافلة بصور البؤس والظلم وجبروت الإنسان على الإنسان، وتؤكد حقيقة أن اللاجئ إنسان منقوص الحقوق، ينظر إليه على أنه إنسان أجرب، ليس له الحق في الحياة الإنسانية أسوة بالمواطنين، فهو أقل منهم بدرجات. واللاجئ يُدرك ذلك، ولا يطالب بالمساواة في الحقوق، لكن أن يعامل كإنسان له حق الحياة، كالقطط على الأقل. ولعل توظيف القطط في الرواية ودلالتها يتطلب دراسة مستفيضة، فقد كان لها دور رئيس وفاعل في الرواية، بالإضافة إلى «اللولو» و«شام» و«اليبرودي». وتضاف الرواية إلى عشرات الروايات التي تناولت اللجوء السوري، ومعاناة اللاجئين، وشكلت في مجموعها ما يمكن أن يُطلق عليه «أدب اللجوء السوري».
كاتب أردني