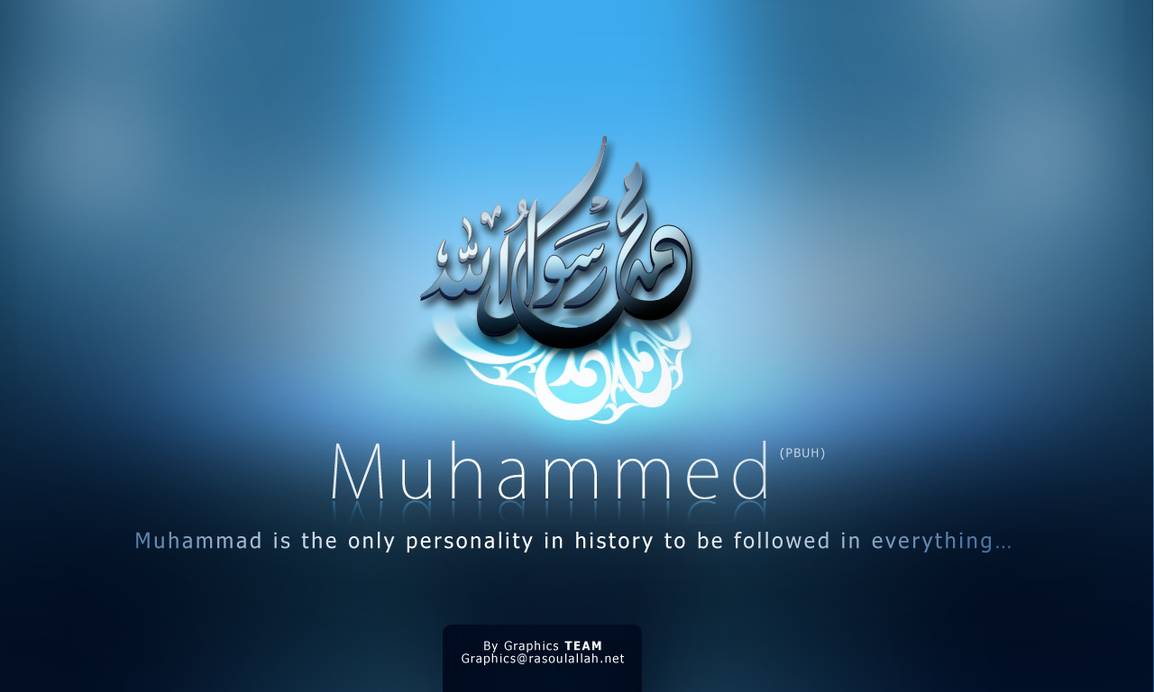رواية «قمر حرّان» وجدلية علاقة العالم بالسلطان
2024-03-06

موسى إبراهيم أبو رياش
يشكل التاريخ وتراجم الأعلام وسيرهم مادة غنية لفن الرواية. وكان التاريخ وسيبقى معينًا لا ينضب لمن شاء، يمتح منه دون حدود، ولن ينقص منه شيء، بل يزداد ويتعاظم. وهنا تبرز مهارة الروائي في اقتناص الحدث التاريخي المناسب، ليكون أساس روايته. ويكمن إبداعه في إعادة تشكيل هذا الحدث في بناء روائي ناجح، يختلف عن السائد، ويلفت نظر القارئ، وهو تحد صعب للروائي، واختبار لقدراته ومهاراته، ومدى تمكنه من فن الرواية. والتحدي الأكبر للروائي أن ينجح في تقديم رواية إبداعية متكاملة، ولا يسقط في حبائل التاريخ ومتاهاته. أي إنَّ المطلوب أن يكتب رواية كما يجب أن تكون الرواية، لا أن يعيد كتابة التاريخ.
في روايته الثالثة «قمر حرّان.. الشيخ والسلطان» يخوض الروائي الأردني ليث التل مغامرة لا يُحسد عليها، ويقتحم ميدانًا صعبًا؛ إذ يتناول جانبًا من سيرة ابن تيمية (661-728هـ) والسلطان الناصر محمد بن قلاوون (684-741هـ) في خطين يلتقيان ويتقاطعان حينًا، ويتباعدان حينًا آخر. ولعلَّ هذه الرواية هي الأولى، التي تتجرأ على أن يكون ابن تيمية موضوعًا لها؛ فابن تيمية شخصية إشكالية كانت وستبقى، وخصومه ومنتقدوه وكارهوه كثر، وما زال يثير الجدل والاختلاف والخلاف شرقًا وغربًا، وربما يكون ابن تيمية أكثر عالم إسلامي تعرض قديمًا وحديثًا لكل أنواع الشتم والإيذاء والقدح والتسفيه بل أكثر من ذلك، ومن هنا، فإنَّ الكتابة عنه سير في حقل ألغام، وخوض معركة ضد محبيه وخصومه على حدّ سواء.
التقط الكاتب بذكاء العلاقة المميزة بين الشيخ ابن تيمية والسلطان الناصر، واتخذها المحور الرئيس للرواية وعمودها الفقري، فقد كان السلطان محبًا للشيخ ومقدرًا له ومقربًا إيّاه، وفي مرحلة ما، كان أشبه بتلميذ بين يديه لا سلطانًا عليه. واللافت في هذه العلاقة أنَّ الشيخ كان صريحًا لم يداهن أو ينافق أو يجامل، والسلطان كان واسع الصدر، مستمعًا جيدًا، يأخذ بكلام الشيخ ونصائحه. وهذه حالة نادرة أن يجتمع الشيخ والسلطان ويتفقان في أمور الدين والدنيا.
المحتوى المعرفي
اتكأت الرواية على مفاصل من حياة ابن تيمية وحياة السلطان الناصر، وما عاصرهما من أحداث جسام، أثرت بشكل كبير على أحدهما أو كليهما، وعلى المنطقة ككل، وخاصة مصر والشام. ومن هذه الأحداث الغزو المغولي لبلاد الشام، والممالك الصليبية، وجهاد السلطان المنصور بن قلاوون وابنه من بعده السلطان الأشرف خليل في تحرير الشام كاملة من الوجود الصليبي، وتولي الناصر السلطنة صبيًا، ومعركة مرج الصُّفَّر قرب دمشق، وهزيمة المغول وكسر أرجلهم عن الشام للأبد، وضعف دولتهم بعد ذلك، ونشوء الدولة العثمانية، وصراع أمراء المماليك على السلطة، وغيرها من الأحداث التي سلطت الرواية الضوء عليها.
استعرضت الرواية مفاصل من حياة ابن تيمية؛ ابتدأت بخروجه صبيًا من حرَّان إثر الغزو المغولي، وإقامته في دمشق، وتدرجه في العلم حتى أصبح علم أعلامها، وأرفعهم مقامًا، وأبعدهم صيتًا، وانتقل إلى القاهرة، فزادت شهرته، وارتفعت مكانته، ورفض عروض قازان خان المغول والسلطان الناصر في تولي المناصب الرفيعة، وفضَّل أن يبقى حرًا مستقلا يعلم الناس أمور دينهم، دون أن يكون مدينًا لأحد. لكنه لم يتخلَّ عن مسؤولياته، فكتب للسلطان كتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» يفصل فيه واجبات السلطان ووظائفه، وغيرها من أمور الحكم والإدارة، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
مكانة ابن تيمية وشهرته أدت إلى كثرة حاسديه، فاشتغلوا به وعليه؛ تحريضًا وبث إشاعات وتحريف فتاوى وأقاويل، وتلفيق تهم، وكل ذلك لم يزد الشيخ إلا قوة وتمسكًا بدينه ورأيه، مما زاد من نقمة خصومه وسعيهم للكيد له وإزاحته عن الطريق، واستغلوا بعض فتاويه وآرائه مثل فتواه في الطلاق، ورأيه في صفات الله سبحانه وتعالى، ومسألة التأويل، التي كان يسميها التحريف، والتصوف، وحدود طاعة ولي الأمر، وغيرها من الأمور الخلافية التي أشعلت الفتيل، الذي أدى في النهاية إلى سجن ابن تيمية بأمر من السلطان الناصر إلى أن توفاه الله.
وفي المقابل، كان السلطان الناصر حالة متفردة، فقد تسلطن صبيًا بعد مقتل أخيه الأشرف خليل، وأُبعد وعُزل مرتين، لكنه عاد قويًا، وكان ذكيًا فطنًا، وتخلص من خصومه، وحيَّد أعداءه، وخطط لدولته، وعمل على إعمارها، ومنعة حصونها وحدودها، وصلاح رعيته.
تميز المحتوى المعرفي للرواية بالغزارة والتشعب، وذكر التفاصيل الدقيقة، وهذه لها فائدتها وأهميتها، وإغراؤها لدى بعض القراء، لكنها في المقابل، قد تشكل عبئا وحمولة زائدة على الرواية، ولو أوجز الكاتب لجاءت الرواية أرشق وأجمل وأكثر فتنة.
البناء الفني واللغة
جاءت الرواية الصادرة في عمّان عن الدار الأهلية في 416 صفحة، توزعت على أربعين فصلا، واعتمدت على الراوي العليم في معظم فصولها، لكنها وظفت أيضًا تقنية تعدد الأصوات في بعض الفصول، وهذا التنوع أعطى الرواية قيمة مضافة، وعدم اعتماده على تعدد الأصوات بشكل كامل مبرر؛ فليس من السهل على الروائي أن يُنطق ابن تيمية أو السلطان الناصر أو ست النعم وغيرهم من شخوص الرواية، ولا حاجة لذلك ابتداءً.
كما أنَّ الرواية لم تلجأ إلى تسجيل كل شيء، بل اكتفت بمحطات أو مواقف أو وقائع مؤثرة، مع تمكين القارئ أن يستنتج ما لم يُذكر، وفي هذا احترام للقارئ، ومنحه دورًا مهمًا في الرواية، وأن يشارك في كتابتها من خلال تخيله وتوقعاته واستنتاجاته.
وكونها رواية ذات مرجعية تاريخية، فقد سارت في خط تصاعدي، حسب المسار التاريخي للأحداث، ولم يكن ابن تيمية وخصومه محور الرواية، ولا الغزو المغولي، ولا الصراع على السلطة، بل العلاقة بين الشيخ والسلطان، هذه العلاقة غير المـألوفة؛ ففي العادة يكون الشيوخ تبعًا للسلطان، يزينون له، ولا يخرجون عن رأيه، بل ويفتون له ما يريد، لكن ابن تيمية كان مختلفًا، فلم يتزلف، ولم يتقرب، ولم ينافق، بل صدع بالحق بقوة، وعبَّر عن رأيه بجرأة، وجالس السلطان بهيبة وعزة، ورفض المناصب.
تميزت لغة الرواية بجمالها وقوتها، وهذا يتماهى مع مستوى شخوص الرواية ومكانتهم وقدراتهم اللغوية الرفيعة، فلا ينتظر من ابن تيمية أو السلطان الناصر أقلّ من ذلك، والرواية التاريخية تتطلب ذلك، واللغة العادية تهبط بها وتضعفها. ولغة الرواية الجميلة تسجل للكاتب، وتكشف عن طول باعه في اللغة، وحسن توظيفه لها دون تكلف أو تقعر أو شطط.
ما الذي تريده الرواية؟؟
من العبث أن يُكتب التاريخ من أجل التأريخ. ومن السخف أن يلجأ الروائي للتاريخ لتسويد الصفحات دون هدف أو غاية. ولا حاجة للروائي التل أن يكرر سيرة ابن تيمية والسلطان الناصر، لكن للرواية غايات أرفع ومرامي أبعد، وربما سهام تُسدد.
إنَّ قوة الدولة الإسلامية تكمن في الدرجة الأولى في التقاء العلماء والحكام، التقاء تكافئ لا تبعية، وعزة وكرامة لا استخذاء أو استجداء، ويجب أن تكون غايتهما مرضاة الله أولا، وصلاح البلاد والعباد، ورفعة الدولة ومنعتها، وهذا يتطلب جرأة وصراحة وقوة ورأيًا سديدًا من العلماء، وتقبلا ورحابة صدر وتنفيذًا من الحكام وتمكينًا للعلماء، وهذا ما كان عليه ابن تيمية مع السلطان الناصر. ولعل نظرة في تاريخنا القديم وواقعنا الأليم، ترتد إلينا خاسئة وهي ترى تذلل العلماء، وصمتهم، وخضوعهم للحكام، والتزيين لهم، والمساهمة في فرعنتهم وتفردهم بالسلطة، وبعدهم عن الحق والعدل وصلاح الرعية، بل وخضوعهم لعدوهم جهارًا نهارًا، واعتزازهم بذلك.
إنَّ مصر وبلاد الشام جناحا طائر، لا يمكن أن يرتفع بأحدهما، وأساس رفعة العرب والمسلمين مرهونة بوحدة الشام ومصر وقوتهما معًا، وهذا ما أثبته التاريخ، فعندما تصرخ مصر تسارع لنجدتها الشام، وإذا استغاثت الشام لبت مصر النداء، فلا نصر لمصر إلا بالشام، ولا مستقبل للشام دون مصر، ولن يكون للعرب والمسلمين قوة ومنعة ما لم تتوحد مصر والشام في كيان واحد، يكون نواة لوحدة أكبر وأعمّ.
كان المغول في عهد ابن تيمية مسلمين، أو ادعوا الإسلام، لكنهم كانوا بعيدين عن حقيقة الإسلام؛ فما كان إسلامهم إلا نفاقًا ومكرًا، وورقة رابحة للسيطرة والخداع، فأسلموا ظاهرًا، لكنهم بقوا على ملّة جنكيز خان وتعاليمه، لكن ابن تيمية ومعه جلّ علماء عصره والسلاطين رأوا أنَّ إسلام المغول الظاهري لا يحول دون قتالهم وصدهم عن الشام، وتكلل ذلك في معركة مرج الصُّفَّر، حيث انهزم المغول هزيمة منكرة بعد أن كانت البداية لهم، وانقطعت أرجلهم عن الشام، بعد ظلم وتخريب وتقتيل.
لم ينطل إسلام المغول على أهل الشام ومصر، فقاتلوهم دون هوادة، ولم يلجؤوا إلى الصلح، فهم آنذاك ليسوا طائفة مسلمة يجب السعي في الصلح معها، بل عدو محارب ظاهره إسلام وباطنه كفر بواح. ولذا فرفع الإسلام شعارًا وراية لا يعني بالضرورة أنَّ القلوب آمنت وأنابت، وأن الألسن تلهج بذكر الله.
لم يكن ابن تيمية رجل قتال، لكنه عالم عامل، فلما اقتضت الضرورة، قام بدور عظيم ومحوري في شحن النفوس ورفع الهمم، وأقنع السلطان الناصر بقتال المغول، وحرض أهل الشام على القتال، وسعى هنا وهناك ليزيل وهن النفوس ورعب القلوب من المغول، ولما حمي الوطيس، وانكشفت ميمنة المسلمين في مرج الصُّفَّر، تقدم واقتحم، وكان مع المغول وجهًا لوجه، فقاتل وثبت وحرض المقاتلين على الجهاد والصمود، فكان النصر المبين. وهذا دأب العلماء الصادقين في كل زمان، عندما تقترن الأقوال بالأفعال، ولو أنَّ كل عالم بذل وجاهد في سبيل الله في أي ميدان كان لتغيرت الأحوال، لكن هوى النفوس غلاب.
إنَّ أمور الدين لا تُؤخذ بالتقليد، بل بالحجة والدليل، وهذا ما سار عليه ابن تيمية، وكانت له آراء وفتاوى خرجت عن المسار المتبع، فثار عليه من ثار، لكنه لم يتراجع، وثبت على مواقفه، ودليله سلاحه، ومن ذلك فتواه في الطلاق، التي كانت غير مسبوقة، وأصبحت اليوم هي المعتمدة عند معظم المسلمين. وهذا يجب أن يكون نهج العلماء ليبقى الدين نضرًا فاعلا في حياة الناس.
وبعد؛؛؛ فإن «قمر حرّان.. الشيخ والسلطان» رواية قالت الكثير، وتركت بين سطورها الكثير، وهي تستحث القارئ للبحث والتقصي عن كثير من الأمور التي كان يجهلها، وأشارت إليها الرواية، كما أنّها قدمت ابن تيمية بصورة واقعية بعيدًا عن الهالة و»الأسطرة» والمبالغات التي أساءت له. وهي رواية يمكن أن تتحول إلى مسلسل تلفزيوني، فهي تملك كل الإمكانات الدرامية، وفيها قدر كبير من الإثارة والتشويق والمتعة، وتتوافر على كم كبير من الأحداث. كما أنّها بمثابة دعوة للمبدعين لمغامرات روائية عن أعلام أُخر لهم قدرهم ومكانتهم.
كاتب أردني