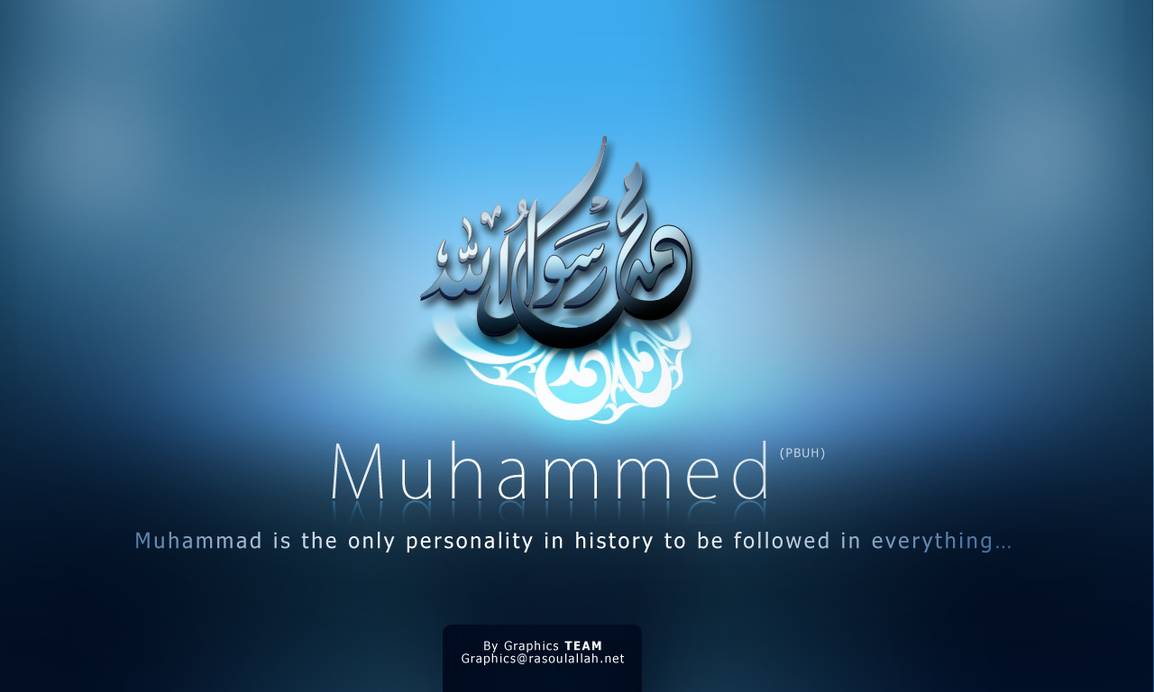الشاعرة المغربية مليكة العاصمي: رفضت الالتزام الأعمى ولم أتنازل عن حريتي قيد أنملة
2024-01-14

حاورها: عبد اللطيف الوراري
كانت المعركة التي خاضتها المرأة في كلّ مجالاتها، منذ عصر النهضة، جديرة بأن تقرأ من منظور أشمل؛ فقد كانت معركة وجود، ومعركة قيم وأخلاقيات، ومعركة مجتمع لا يمكن أن يتنفس روح العصر وحداثته المتجددة برئة واحدة، وهي لهذا السبب لم تتوقف بعد. ففي المجال الثقافي، ارتبط حضور المرأة وبروز كتابتها في الأدب العربي الحديث، بالوعي النسائي التحرري الذي كان يتطور على نحو دراماتيكي في سبيل حريتها وكرامتها وأخلاقيّات كتابتها، لأنه كان في مواجهة مباشرة مع نظام الهيمنة الذكورية ومؤسساته القارة. برز صوت المرأة عبر المِنصّات التي أُتيحت لها، أو عملت على إظهارها من خلال جمعيات وأندية تقوم بأنشطة نوعية، حيث صار يُسمع، وصار بوسعه الإقامة في العالم، واسترداد حقوقه الاعتبارية، عبر توطين لغته النوعية والمرحلة كنسق من العلامات إلى الفضاء العام، وإلى الفضاء الأدبي والشعري على نحو خاص. كان الأمر أشبه بثورة ناعمة لانتزاع الاعتراف بوجود المرأة، والإقرار بحضورها وحقوقها في تقرير مصيرها الإبداعي والإنساني.
داخل هذه المعركة، بعد استقلال المغرب، كان صوت مليكة العاصمي متصادياً مع أصوات بنات جنسها، ممن حظين بتعليم عصري وتربية مواطنة، بل إن هذا الصوت أخذ يشتبك مع قضية المجتمع، وكان ذا آثار قوية في النفوس. واجهت محنتها الخاصة، في ما كانت تواجه المحو على ميدان السلط المحتشد بالموانع والحجب الكثيفة. نستأنف -هنا- الحوار مع الشاعرة والمثقفة المغربية، حول بدايات تكوينها الشخصي، وانخراطها في المعترك الثقافي والسياسي، وتدبيرها الشاقّ بين ما هو شخصي وجمعي.
من البيت إلى مدرسة «الفضيلة» التي تلقيت فيها تعليمك الابتدائي، وكانت أول مدرسة حرة للبنات أُسِّست في المغرب، بعد تقديم وثيقة الاستقلال، انتقلت إلى «معهد الفتيات» التابع لجامعة ابن يوسف، وانخرطت في العمل الجمعوي، حيث أسست مع بنات جنسك جمعية «فتيات الانبعاث». كيف كان وضع التعليم وموقعكنّ داخله؟ وما هي الأنشطة التي انخرطتم فيها رغم الصعوبات والإكراهات التي واجهتكُنّ في مجتمع محافظ وذكوري؟
كنت ضمن أول فوج من الفتيات اللواتي التحقن بجامعة ابن يوسف العتيقة بعد الشهادة الابتدائية، بعد أن تقرر لأول مرة انفتاح هذه الجامعة على المرأة بعد قرابة عشرة قرون من الذكورية، أي الاقتصار على تعليم الذكور. كنا في السنة الأولى حوالي عشرين تلميذة تقريبا، وكانت جامعة ابن يوسف قد شهدت نقلة نوعية مع الاستقلال، من القدامة إلى الحداثة والتحديث باستقدام مجموعة الأساتذة المصريين واللبنانيين والسوريين، وتحديث البرامج بإدخال الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء، والأدب والتاريخ والجغرافية والتدبير المنزلي وغيرها، مع الاحتفاظ بالدراسات القديمة من علوم القرآن والحديث واللغة. ساهم هؤلاء الأساتذة في جعل النقلة النوعية التي طمحت الجامعة للانخراط فيها حقيقة واقعة، فبالإضافة إلى كونهم كفاءات عليا في تخصصاتهم، كانوا أيضا إضافة نوعية على المستوى الثقافي، بإبداع مجموعة أفكار ومبادرات مثل، التحفيز على الكتابة والنشر وإصدار مجلة حائطية وتهيئة معرض بالمستحضرات التي نقوم بإعدادها في دروس الكيمياء والفيزياء والأحياء والتدبير المنزلي، وغير ذلك من المبادرات التي خلقت قدرا كبيرا من الحيوية في وسطنا التعليمي.
رغم تحديث التعليم في مؤسستنا «معهد الفتيات» بشكل خاص، وفي هذه الجامعة بشكل عام، فقد ظللنا نحمل الطابع التقليدي. وباعتبارنا إناثا، فقد دشّنا ظاهرة جديدة في هذه الجامعة، وأضفنا بصمتنا الخاصة بمجموعة اجتهادات دينية مميزة. خديجة الشياظمي رائدتنا، أبدعت فكرة إحيائنا ـ كإناث – لذكرى المولد النبوي في مسجد ابن يوسف وقت صلاة العصر. ذهبنا بهذه الفكرة لمقابلة رئيس الجامعة الفقيه الرحالي الفاروقي بحضور بعض الفقهاء أعضاء مجلس الجامعة، الذين وافقوا دون تحفظ على مطلبنا، بما فيه إمامتنا بالنساء. كان حدثا مهما أن تستأثر النساء بمسجد اعْتُبر ـ دائما- مقام كبار العلماء، ولأول مرة سيتخلف الرجال فيه عن صلاة أساسية جامعة منذ عشرة قرون. كنا نُحاط بعناية خاصة من طرف العلماء في إدارة الكلية أو الجامعة. فقد انتدبنا – مثلا- لتأطير النساء في سجن أبي المهاريس، ورافقونا لحضور أول درس حسني في مسجد أهل فاس في الرباط، وخضنا معهم معركة مقاومة الإجهاز على هذه الجامعة التاريخية العريقة ومحوها. وبما أنّ «فتيات الانبعاث» جمعية ثقافية اجتماعية متعددة الاهتمامات، فقد قمنا في مراكش بحملات تربوية توعوية، وإسعافات لفائدة النساء والأطفال في الأحياء الشعبية والقرى، وشاركنا في حملة إنقاذ ضحايا زلزال أكادير، وقمنا بأنشطة اجتماعية كثيرة، بتنسيق مع جهات ومنظمات مختلفة مثل منظمة الهلال الأحمر المغربي التي كان يترأسها عبد العزيز برادة. كما قدمنا عددا من العروض الفنية في موسيقى الآلة والملحون في قاعات السينما أو قاعة الكازينو، وأول أغنية لعبد الله العصامي نحن اللواتي قدمناها. الآلة موسيقى باذخة تختص بالأفراح والمناسبات المهيبة، لكن قليلين من كانوا يتفاعلون معها. وكان لفتيات الانبعاث الفضل في تحبيب هذه الموسيقى لعموم المغاربة، بأدائهن لقطعة «شمس العشي» في الإذاعة الوطنية. كما قدمنا عددا من العروض المسرحية بتنسيق مع بعض الفرق المسرحية، مثل: فرقة الأطلس لمولاي عبد الواحد الأطلسي، وفرقة الكوميديا. وقدمنا كذلك ندوات ومحاضرات وغير ذلك كثير. وهكذا استقطبنا بأنشطتنا جمهورا كبيرا كانت تضيق به قاعات سينما بلاص ومبروكة وكوليزي والكازينو في مدينة مراكش.
هل تذكرين أول محاولة شعرية كتبتها؟ هل عرضتها على الأهل؟ وهل كان المحيط حافزأً لميلاد شاعرة في مجتمع ذكوري؟
توفي والدي في 2 أبريل/نيسان 1961، والمحاولات الأولى عبّرتْ عن هذه النكبة. كانت جنينيّة. لم أعرضها على أيٍّ كان، ولم أقدمها أبدا. لكنّني أذكر محاولات أخرى كتبتها في القسم، خلال إحدى مراحل دراستي الإعدادية والثانوية، بعضها عرضته على الأستاذ الذي كان يدرسنا، وكان شاعرا؛ هو ابن عمّتي الأستاذ مبارك الغراس أحد المُوقِّعين على وثيقة الاستقلال. لم أُعرف إلا من خلال النشر، لأنني لا أعرض كتاباتي على أحد. من ثَمّ صار يُطلب مني قراءة الشعر في بعض المجالس التي كنت أشارك فيها.
كنا نعيش مناخَ الشعر وبين أفياء الشعر الذي ينشره عمي عبد القادر حسن، فيما نتداوله بالبيت من صحف ومجلات، أو الذي يرسله من معتقلاته، أو الذي يرسله ابن عمتي مبارك الغراس هو الآخر من منفاه في الدار البيضاء. كان لهذا الشّعر وقْعُه في الوجدان؛ سواء العاطفي منه، أو شعر الشكوى، وعذابات المعتقلات وشبيهها. كذلك كان كثير من الرسائل المتبادلة بين أعضاء الأسرة شعريّةً. وكانت مكتبة بيتنا تحفل بدواوين الشعر، وحفظت منها أغلب ديوان الأخطل الصغير على سبيل المثال. ودروسنا منذ الابتدائي والإعدادي والثانوي كانت تحفل بالنصوص الشعرية والأناشيد، والمسرحيات التي تعرضها المدرسة وأشارك فيها، هي في أغلبها مسرحيات شعريّة.
مَنْ من الشعراء والشاعرات الذين قرأتِ لهم، أو أُعجبت بهم، من القديم والحديث؟
أذكر أن أستاذنا في المرحلة الابتدائية إبراهيم الهلالي جاءنا بديوان للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، درسنا منه قصيدة جميلة تحمل عنوان الديوان نفسه: «وحدي مع الأيام» وقد كان لها أثرٌ كبيرٌ في نفسي.
ما الذي شدّك في شعرها؛ صوتك الأنثوي الجريح؟ أم أثر النكبة على نفسها وشعرها في الوقت معا؟
لم يكن سني قد تجاوز بعد ثماني سنوات عندما تعرفت على قصيدة فدوى طوقان على طاولة الدرس في القسم الابتدائي، وما زلت أحفظها إلى اليوم: بجسميَ قفقفة وانخذال/ فيا نار زيدي لظى واشتعال/ ومدّي بجوي دفيئ الجناح/ فللبرد عاصفة واجتياح/ أما تسمعين احتدام النضال/ نضال العواصف فوق الجبال/ وأنت اعصفي، واملئي ليلتي/ بدفءٍ يهدّئ من رعدتي/ فحولي يدبُّ صقيع الشتاء/ دبيب الفناء/ فبثي الحرارة في غرفتي، إلخ». قصيدة وجدانية إنسانية كما ترى، لا تتحدث عن وضعية الاحتلال والنضال، ولا عن حميميات الأنثى وعاطفياتها، لكن عن الهشاشة الإنسانية. تتحدث عن الوحدة؛ وهي واحدة من أبشع الحالات التي قد يتعرض لها الكائن، لأن الإنسان مدنيٌّ بالطبع، اجتماعي يحتاج إلى الانتماء، وإلى أن يكون محاطا بأحبابه وأهله وأصدقائه. تتحدث القصيدة من جهة ثانية عن حاجة روحية أو اقتصادية للدفء، في وضع يتسبب في القفقفة والارتعاش، فيجعل الشاعرة تستغيث بالنار، كي تمنح لجسمها، بل ولروحها بعض الدفء. كانت في وعيي، بالنسبة إليّ، حالة إنسانية محزنة غاية في النفاذ إلى روحي ووجداني والتأثير فيهما. النص بسيط يكاد يكون مباشرا، لكنه مكثف بعناصر القوة والإبداع والوجدانية والغنائية يلامس الروح، لاسيما روحاً هشّة هي روح الطفلة حينئذ.
في مراكش مَنْ مِن الشعراء التقيتِ بهم؟ هل كنت تسمعين ـ مثلا- بشاعر الحمراء محمد بن إبراهيم؟
لم أتعرف على شاعر الحمراء مباشرة، فقد توفي وأنا ما زلت بعدُ في مرحلة الوعي الأولى. لكن ذلك لم يمنعني من متابعته، سواء من خلال أشعاره، أو من خلال تتبع حياته ومحيطه وأخباره وعلاقاته، وتسقُّط أخباره من الأقربين والأبعدين والمساندين والمناهضين. وقد دُعيت أكثر من مرة للتحدث أو إلقاء محاضرات عنه، منها الندوة المهمة التي نظمتها جمعية قدماء ثانوية محمد الخامس في سبعينيات القرن الماضي، بمساهمة كبار شخصيات ومفكري وأدباء مراكش والمغرب، وكان لمحاضرتي صدى كبير، وقد نُشرت في مجلة «المناهل». كما تعرّفتُ مبكّرا على الشاعر محمد المختار السوسي باعتباره واحدا من معارف الأسرة، وعلى محمد الحبيب الفرقاني صديق الأسرة وزوجته، وكان معلّمًا في مدرسة الفضيلة، التي درست فيها وكان يديرها أبي، بل إن أكثر أساتذة جامعة ابن يوسف التي أنتمي إليها كان معروفًا كشاعر؛ منهم: مولاي الطيب المريني، ومحمد الخلاصة، ومولاي الحسن عادل، ومولاي مبارك العدلوني، وإبراهيم الهلالي وأحمد الشرقاوي إقبال.. وهي المجموعة التي أسست اتحاد كتاب المغرب العربي في صيغته الأولى، وغيرهم كثير.
كتبتِ نصوصك الأولى في أواسط الستينيات. هل تذكرين أول نص منشور لك؟
لا أذكر مع الأسف الشديد. في الستينيات كنت أقرب إلى قشّةٍ في مهبّ الريح، وحيدة أعاني أنواعا من اليتم، لا أعرض عملي على أحد، ولا أفرح ذلك الفرح الخاص لظهور اسمي في الصحافة.
التحقتِ بكلية الآداب في فاس سنة 1967. لمَ اخترتِ فاس دون غيرها، ومَنْ مِن الشعراء والأدباء الأساسيين الذين التقيتِ بهم هناك؟
في هذه السنة عُيّنت في كلية الآداب في جامعة محمد الخامس، إلا أن قسم اللغة العربية داخلها نُقل إلى فاس. وهكذا وجدتني في فاس، حيث اجتمع مؤسسو القصيدة المغربية الحديثة: أحمد المجاطي، ومحمد الخمار الكنوني، وإبراهيم السولامي، ومحمد السرغيني وغيرهم. وكذلك كبار النقاد ووجوه الثقافة المغربية ودعاة الحداثة، من أمثال: محمد برادة، وعباس الجراري، وأحمد اليابوري، وحسن المنيعي. كما كان هناك رموز الثقافة التقليدية: عبد القادر زمامة، ومحمد بن تاويت، ومحمد عبد السلام الهراس، وإبراهيم الكتاني وغيرهم. استقبلتني فاس استقبالا حفيّا، وكنت محط عناية وتقدير من طرف عدد من البنيات الفاعلة في فاس، باعتباري أول امرأة أستاذة في الجامعة، حيث دُعيت لإلقاء محاضرات هنا وهناك، وانخرطت في أنشطة نوعية. أذكر إخواني الشعراء والأساتذة الذين استدعوني كضيفة شرف على أمسية جميلة داخل مطعم أنيق. وكان الشاعر أحمد المجاطي رفيقي الدائم، لا يتركني إلا لماما؛ كنا نترافق في كل يوم تقريبا، من الكلية إلى المدينة. عندما نشرت قصيدة «أنفاسكم تحرق كرمة العنب» المضمنة في الديوان الثاني «أصوات حنجرة ميتة» كان يقول لي: أقوم بتضخيم أناك بعض الشيء، يرحمه الله. كذلك كانت الجامعة تنظم أماسي شعرية وأنشطة ثقافية متنوعة تشعُّ على محيطها بشكل كبير، وهناك التقيت أو رافقت كفاءات طلابية من الشعراء والباحثين الذين يعلنون عن مواهبهم وأصواتهم لأول مرة؛ منهم: محمد بنيس، ومحمد بنطلحة، وإدريس الناقوري، ومصطفى بغداد وغيرهم.
أثناء مقامك في فاس، هل لمستِ صراعا على أيّ نحو بين المدرسة التقليدية والاتجاه الحديث في كتابة الشعر والأدب (ندوات، مقالات، مناظرة..؟) وأين كنتِ تضعين نفسك من هذا الصراع؟
لا أذكر أنه كان هناك صراع معلن من هذا النوع، رغم وجود مجموعة من الكفاءات التقليدية في قسم اللغة العربية إلى جانب مجموعة أخرى حداثية. ولا أذكر كذلك شيئا من هذا في المحافل الأخرى التي أغشاها. أتوقع أنه لو كان هناك صراعٌ من هذا النوع وتهجّمٌ للمدرسة التقليدية، لكنت أول أهدافها.
لكن اتحاد الكتاب والصحافة الثقافية، بما في ذلك الملحق لجريدة «العَلَم» عملا في ما بعد على تصفية هذه المدرسة، وشطب كل المنتمين إليها، فأُغلقت في وجههم منابر التعبير والحضور. وكنت وما زلت أدين هذا التوجه وألحُّ على جعل الحقل الثقافي ديمقراطيّا، متعدّدا بتعدد الواقع، للجميع الحق في التموقع فيه والاستفادة منه. وكان الصراع السياسي في أوجه داخل الجامعة؛ صراع أيديولوجي ومواجهات بين الفصائل الطلابية ومرجعياتها الحزبية أو الفكرية، بل صراعات دموية ومواجهات بين الطلبة والقوات العمومية.
انتميت مبكّرا إلى حزب الاستقلال؛ هل شعرتِ يوما بأنك شاعرة حزب، أو أنّ أحدا أشعرك بذلك أو سمعتِ به؟
أبدا.. أبدا؛ الشعر حرٌّ لا ينتمي إلا إلى نفسه ولا يكون لأحد، هذا من حيث المبدأ، فأحرى إذا كان شعر مليكة العاصمي؛ إذ ذاك سيكون في أعلى حالات التمرد والاستقلالية. رغم أن هذا لا يمنع من أن يخدم الشعر قضايا إنسانية سامية تلتقي في أهدافها مع حزب، أو تيار، أو تنظيم تنخرط في مشروعه.
هل مارستِ من موقعك الحزبي رقابةً ما على شعرك؟
من أهمّ عيوبي أو مميزاتي أنني منفلتة. أرفض الالتزام الأعمى. وأرفض الرقابة من أي جهة كانت. ولا أنتظم في الصفوف والخانات والتصنيفات. أمارس بكل إصرار حرية المفكرة والمثقفة، وأحتفظ لنفسي بمساحة القرار والفعل والتحرك مهما كان الثمن، ولا أقنع بهامش من الحرية.
هل التقيتِ في إحدى المرات بزينب النفزاوية، باعتماد الرميكية؟
زينب النفزاوية واعتماد الرميكية وولادة والخنساء ومي زيادة وغيرهن كثير، فقد ساكنتهُنّ جميعا وتآلفنا وتقاسمنا أشياءنا الجميلة، لقد دعتنا مراكش إليها ونفحتنا من أنفاسها وأغدقت علينا ربما بغير حساب.