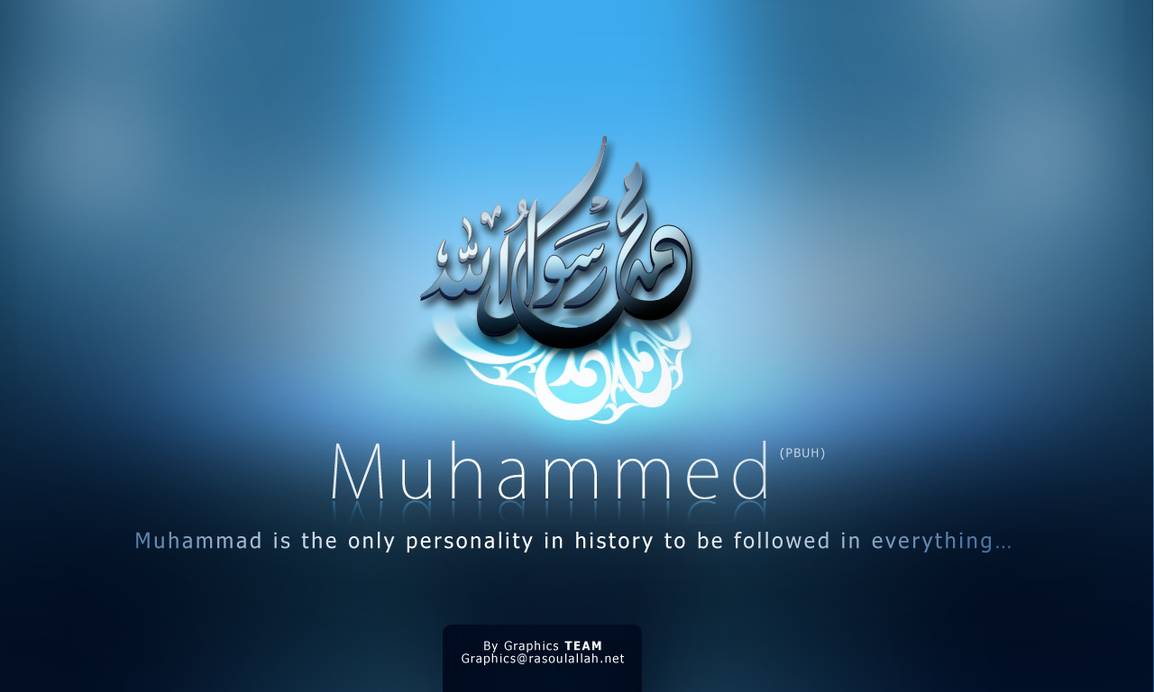بغداد التي هرّبتُها في حقيبتي
2024-03-05

عبد الإله مهداد
كنتُ أوضّب حقيبتي الصغيرة، مساء الأحد؛ مُسافرا، بدعوة كريمةٍ من وزارة الشباب والرياضة العراقية، إلى العراق، وتحديدا إلى بغداد. كنتُ حريصا على عدمِ نسيان أغراضي الهامّة، والقصائد، التي سأقرؤها في المهرجانِ الشّعريّ. لكنَّ ما وضّبتْهُ أمّي من أدعيةٍ ممزوجةٍ بالمخاوف، فاجأني! أمّي التي كبرت وهي تسمع خُطب الراحل «صدام حُسين» بمشيته المحاطة بالحرس، مستحضرةً الدبابات الأمريكيّة، وهي تجوبُ شوارع بغداد، متفنّنةً في تخريبِ المدينة وتراثها وبنائها الحيويّ..
لقد كانت الدّباباتُ تحاولُ سرقة تاريخ بغداد الضارب في القدم، وتشويهَهُ، وصولا إلى لحظة ميلانِ النّصبِ الكبير في ساحة الفردوس. كأنّ أمي تستحضِرُ، حتى هذه اللحظة، الجلسات الماراثونيّة لمحاكمة «صدام» التي انتهت بإحناءِ جبهته لحظةَ الإعدام، وهي التي – وأستعيرُ من أمل دنقل – «لمْ يحنِها وهيَ حيّة».
أمّي ما زالت تسمعُ وتقرَأ عن توتراتِ الأوضاعِ في العِراق، عن الصّراعات، والثنائيّات: شيعةٌ وسُنة، أربيل وبغداد… تقرأ عناوين الصُّحف «الصفراء» وتسمع تجار المآسي، على شاشة التلفزيون، متتبعة العدوانَ على غزّة، وما صاحبه من توتّر في المنطقة برُمّتها، مفضّلة بقائي في المغرب، وعدم السّفر والمُخاطرة.
كنت «عاقّا».. أغلقت حقيبتي، ولم أحمل فيها سوى حديث الأصحاب، وغبطة الأصدقاء، الذينَ اعتبروا هذه الرّحلة: فرصة عمرِ، محملينَ أمتعتي بتوصياتٍ وعهود كان لِزاما عليّ أن أفيَ بها، وأنا أتجول في شارع المتنبي، وفي يدي قائمة من الكتب والأشياء، التي يجب أنْ أشتريها، عهودا ألزمتْني بالتّسكُعِ في شارع أبي نواس، والمرور على جسر مود، والتبرّكَ بضريح الإمام ابنِ حنبل، والصلاة بمسجد براثا، واستنشاق غبار ساحة التّحرير، والتقاط صورِ نصب الحريّة، الذي صمّمه جواد سليم بسرعةٍ، قبل أن يحرّكَ الشرطيُّ يده طالبا الابتعاد، وأنْ أطيرَ إلى كركوك؛ كي أقرأ سورة «نوح» على قبر سركون بولص.
لم أكن أحمل في ذهني تلكَ السّاعة سِوى زرياب.. زريابُ الذي كتبتُهُ في عملي الشّعري الأول.. زريابُ الذي غادرَ بغداد صوبَ الأندلس، عابرا مدينة وجدة.. تذكرتُهُ آنذاك وهو يصفُ مدينتي.. زريابُ المنفيّ/ المقتول رمزيا، الذي صنعَ وطنا له؛ كي «يبعثَ حيّا» ويخلَّدَ فنانا عظيما، هل مدَّ لي خلسةً مفاتيح بغداد؟ (مَن أنا ليفَعَلَ ذلك؟).
زحف القطارُ من وجدة إلى البيضاء، ثم طرتُ إلى الدوحة، وصولا بعد ذلك إلى بغداد، في تمامِ الساعة الثالثة صباحا. مطارٌ صغير، يكبُر بحفاوةِ أهله وكرمِهم، كانت الانتخاباتُ على الأبواب، والمنافسة تبدو شرسة، إذْ تغطّي الإعلاناتُ الأشجار، الجدران، أعمدة النور، الحفر…إلخ. السكانُ مستيقظون لم يناموا بعد، الشعراءُ ساهرون في «فندق فلسطين».. المدينةُ مفعمة بالحياة السياسيّة والاجتماعية والثقافية.
دخلتُ «فندقَ فلسطين» ولم أشعر وأنا أتأمل نهر الفُرات، مشدوها من الطابق التاسع، إلا والشمس بدأت تنسج خيوطها، لأذهب مباشرةً إلى بوابة الإله، عاصمة الإمبراطورية البابليّة.. بابلُ مدينةُ السّحر، البعيدةُ عن بغداد بحوالي 85 كلم، حيثُ واصلتُ بين أسوارها الحلم، الذي راودني في وجدة.. كان حلما جميلا.
أسبوعٌ شعريّ بامتياز، وقد تكلّلت إقامتي بلقاءاتٍ ماتعة مع عدد من الشّعراء العرب، الأصدقاء: حسام شديفات، وأسيل سقلاوي، وعمار حسن سعد الدين، وزكريا مصطفى، وعلي إبراهيم الياسري، وجمانة الطراونة، وعماد جبار، وأسماء عديدة مثلت تجارب وأجيال وحساسيات مختلفة، استطاعت أن تبعَثَ «شيطانِي الشّعري» الذي كادَتْ رتابة العمل أنْ تحرقه.
كان لقائي بالإعلاميّ جواد إسماعيل العراقي، في بغداد، إضافة نوعية في الرّحلة. جوادُ الذي حمل الكاميرا بكل رشاقة، مُجيدا خطفَ صور المهرجان، حدثني كثيرا عن المغرب، كما أزاح ستار بغداد.. بغداد الحقيقية، بمقاهيها الشّعبية، وروادها المقبِلين على الحياة، ودكاكينها التراثية، وأحيائِها، التي تحدّتْ قسوة الزمن، حيثُ يسود الأمانُ في ما بعد منتصف الليل.. شربنا عصير الزبيب الطازج عند الحاج «زبالة» والحامض الحلو، والشاي الساخن، والقهوة العربية الفواحة، وتذوقنا حلو الدبس، والحلويات العراقية. جواد صاحبُ الصوتِ الشّجي، الذي أسمعنا أبياتا ومقاطع غنائيّة شعبيّة، وهو يقودُ سيارته بسرعةٍ جنونيةٍ، في الثانية صباحًا؛ ليستطيع أنْ يُريَنا، قدر الإمكان، تاريخ المدينة، الذي كان أطولَ من عددِ أيامِ إقامتي.
سَرّني أيضا سعة ثقافة الدكتور أحمد المبرقع، وزيرُ الشبابِ والرياضة، وهو يستحضرُ في جلستَيْهِ مَعَنا، على الغذاء ثمّ العشاء، لمحات حول التاريخ والثقافة، بالإضافة إلى مخزونه الشعري، محطِّمًا تمثُّلَ ثنائية السياسيّ/الشاعر، فهو الذي يحفظ قصائد ومقاطع لأحمد مطر، ولثلة من الشعراء العراقيين والعرب، بالإضافة إلى ذوقه الشعريّ الرفيع، وهو ينصت للشعراء، وهم يلقونَ قصائدهم على نهرِ الفرات.
أسبوع المهرجان، كان وقتا مستقطعا ومسروقا من الذاكرة العربيّة المثخنة، حتى آخِرها، بالحربِ والدمار، إذ اجتمع رحيق البلدان العربية، متجاوزة بعبقها سجن الحدود، مخترقةً الأفق الضيِّقَ والحسابات السياسية، إلى أفق أرحب، أفق الشِّعر، حيث السِّلْمُ والحرية والقيمُ الإنسانية المنتصرةُ دائما على بشاعة القتلِ والقمع.
وضّبتُ حقيبتي، ورجعتُ مسرعا إلى مطار بغداد، بعد أن اقتربت الطائرة من الإقلاع، استنفدتُ آخر دقيقة لي وأنا أسمع الشِّعر.. أثناء مروري على نقطة التفتيش، أوقفني شرطيٌ وطلبَ منّي فتحَ الحقيبة، كانتْ مليئةً بهدايا تذكاريّةٍ، حرصتُ على شرائها.. أخذ إحدى القطع، قَرَعَ عليها بلُطف، وطلب مني أن أُعيدها إلى الحقيبة، موضِّحا: أنه يجبُ أن يتأكَّدَ من أنَّ القطعة تذكارٌ فقط وليست من الآثار التاريخية، التي تهرّبْ.. أخبرتُهُ مازِحا أنه لو كان في وسعي أنْ أُهرِّبَ قطعةً أثريّة، كنت قد هرّبتُ بغداد بأكملها، ابتسم، وطلب مني اللحاقَ بالطائرة، التي كنتُ آخِرَ الواصلين إليها، وهو لا يعلم أنّني هرَّبْتُ ما يكفي من تاريخِ العراقِ في ذاكرتي.
جلستُ في الدوحة ثمان ساعات، عثرتُ على مغاربة في «السّوق الحرّة» للمطار، استغربوا زيارتي لبغداد، متسائلين حول طبيعة الزيارة، وحول طبيعة العمل، الذي سأزاوله في بغداد، قبل أنْ أسِرَّ في نفسي أنّ: رحلتي لا تقدَّرُ بعملٍ أو ثَمن.
أثناءَ عودتي إلى وجدة، اكتشفتُ أنني بالكادِ نمتُ خلال أسبوع، وهي كانتْ فرصةً لأعيشَ، ولو حلما، أياما إضافية في بغداد.. وفيتُ بوعدي، وأهديتُ صديقي في المقهى تمثالا صغيرا للمتنبي، منقوشا عليه إحدى أبياته الشعرية، أمسكها، شمّها بقوةٍ، حانيا بجسده إلى الوراء، بعينين مغلقتين متنهدا..: «اللـــه» في ما يشبه انتشاءً، لكنْ بعبقِ بغداد!
كاتب مغربي